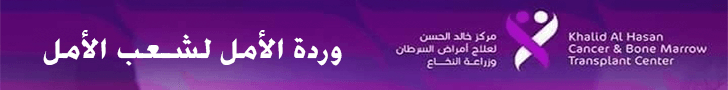معهد القدس للسياسة والأمن: خطة ترامب، إذا ما أُديرت بشكل صحيح، ستتيح، فرصةً لتحقيق أهداف دولة إسرائيل

معهد القدس للسياسة والأمن 8/10/2025، العقيد (احتياط) البروفيسور غابي سيبوني والمقدم (احتياط) إيريز وينر: خطة ترامب، إذا ما أُديرت بشكل صحيح، ستتيح، فرصةً لتحقيق أهداف دولة إسرائيل
مقدمة
كانت (ولا تزال) صرخة شائعة على لسان مقاتلي الجيش الإسرائيلي النظاميين: “إلى متى؟!”. مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لحرب غزة، يبدو أننا نسمع هذا السؤال يتكرر ويزداد حدة، وإن بصيغ مختلفة. حجتنا هي أن مدة الحملة في غزة تعتمد بشكل أساسي على إسرائيل والطريقة التي اختارتها لإدارة الحرب حتى الآن. في فهمنا، كان من الممكن التصرف بشكل مختلف وتحقيق أهداف الحرب في فترة زمنية أقصر بكثير.
في هذه المقالة، نود تقديم تحليل موجز لكيفية إدارة الحملة على مدار العامين الماضيين، وخاصةً كيف يُمكن وضروري التصرف بشكل مختلف. نجادل بأن مدة الحملة نتجت عن أخطاء جوهرية من جانب المؤسسة الأمنية وعجز المستوى السياسي عن توجيه وضمان تنفيذ الخطوات التي من شأنها تقصير مدة الحملة حتمًا، مما يؤدي أيضًا إلى عودة الرهائن. ليس المقصود الخوض في وصف التحركات التكتيكية، بل استعراض شامل لمراحل الحرب والقرارات المتخذة خلالها. سنعرض الأخطاء والدروس الرئيسية، وأخيرًا سنستعرض الخطوات اللازمة لإنهائها. يجب شنّ حملة على غزة بأسرع وقت ممكن مع تحقيق جميع أهداف الحرب المحددة.
يُرجى هنا ذكر أهداف الحرب كما حددتها الحكومة في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023:
- الهدف الأول: تدمير القدرات العسكرية والبنية التحتية الحكومية والتنظيمية لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة؛
- لهدف الثاني: إنهاء حالة الحرب – أي أن قطاع غزة لم يعد يُشكل تهديدًا لإسرائيل بمرور الوقت؛
- الهدف الثالث: إعادة الأمن لسكان المنطقة المُحاصرة، بما في ذلك إنشاء “منطقة عازلة” في أراضي قطاع غزة؛
- الهدف الرابع: تهيئة الظروف لعودة المختطفين إلى إسرائيل؛
لاحقًا، أُضيف هدفٌ في سياق الساحة الشمالية، وهو العودة الآمنة لسكان الشمال إلى ديارهم.
من المهم الإشارة في هذه المرحلة، وخاصةً في ظل الجدل الدائر حول أهداف الحرب وكون عودة المخطوفين هي الهدف الأهم، إلى وجود منطقٍ في ترتيب تحديد الأهداف، ولم يكن هذا المنطق نابعًا من الاستخفاف أو التقليل من الأهمية الأخلاقية والمعنوية لعودتهم. ينبع ترتيب الأهداف من الإدراك أن أسرع وأكثر الطرق فعالية لإعادة المخطوفين هي تدمير القدرات العسكرية لحماس والبنية التحتية الحكومية والتنظيمية في قطاع غزة، كما كان الحال في جميع حروب إسرائيل السابقة التي وقع فيها الإسرائيليون، بمن فيهم المدنيون، أسرى لدى العدو.
مراحل القتال في غزة
على مدار العامين الماضيين، نفّذ جيش الدفاع الإسرائيلي عدة عمليات فرعية في قطاع غزة. وكانت هذه العمليات جزءًا من الحملة الشاملة لتحقيق أهداف الحرب.
سنناقش أدناه المراحل المختلفة لحملة غزة وخصائصها.
إعادة الوضع إلى سابق عهده وحملة القصف (7-27 أكتوبر/تشرين الأول 2023)
امتدت هذه الحملة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى السابع والعشرين من الشهر نفسه، حيث عمل الجيش الإسرائيلي خلالها على إعادة الوضع إلى سابق عهده في المنطقة المحيطة. وتزامن ذلك مع قصف ناري، جوي بالأساس، على العديد من الأهداف في قطاع غزة. خلال هذه الفترة، أكمل الجيش الإسرائيلي تعبئة هيكل القوة اللازم وأعدّه للقتال. تجدر الإشارة هنا إلى أنه خلال هذه الفترة، كان هناك جدل مهني (وإعلامي) حاد حول الحاجة إلى المناورة داخل قطاع غزة وقدرتها. كان هناك العديد من الجهات، بما في ذلك داخل المؤسسة الدفاعية نفسها (رئيس الأركان ووزير الدفاع آنذاك)، التي سعت إلى تجنب المناورة في قطاع غزة وفضّلت العمل في لبنان ضد حزب الله. كان هناك انعدام ثقة بقدرات الجيش البري على العمل البري في القطاع، ومبالغة في قدرات العدو.
حملة واسعة النطاق في مدينة غزة (27 أكتوبر – 24 نوفمبر 2023)
في 27 أكتوبر، شنّ الجيش الإسرائيلي، بقيادة القيادة الجنوبية، هجومًا بريًا بثلاث فرق على شمال قطاع غزة ومدينة غزة. خلال هذا الهجوم، استولى جيش الدفاع الإسرائيلي على معظم شمال قطاع غزة ومدينة غزة، ودمّر العديد من البنى التحتية الإرهابية، وقضى على آلاف الإرهابيين. في 24 نوفمبر، أُعلن عن وقف إطلاق نار أولي لصالح صفقة تحرير الرهائن. اقترحت القيادة الجنوبية مناورة مشتركة، في شمال قطاع غزة ومدينة غزة كجهد رئيسي، نظرًا لكونها مركز الثقل الحكومي والعسكري لحماس، وفي رفح في الجنوب كجهد ثانوي، نظرًا لأهميتها كطريق للتعزيز والقدرة على تجديد الموارد لحماس. نبع قرار تركيز الهجوم على شمال قطاع غزة ومدينة غزة من سببين: الأول والرئيسي – الخوف من قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ عملية برية موازية في شمال وجنوب قطاع غزة، والثاني – الخوف من أن تؤدي عملية في منطقة رفح إلى ضغوط دولية على إسرائيل وأزمة في العلاقات مع مصر.
وقف إطلاق النار الأول (24 نوفمبر/تشرين الثاني – 1 ديسمبر/كانون الأول 2023)
تم وقف إطلاق النار بين 24 نوفمبر/تشرين الثاني و1 ديسمبر/كانون الأول 2023؛ وبقيت قوات الجيش في المناطق التي توقف فيها القتال، وبدأت مساعدات إنسانية محدودة تدخل القطاع، إلى جانب إطلاق سراح 105 رهائن، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن والعمال الأجانب. بعد أن انتهكت حماس الاتفاق، وأجّلت إطلاق سراح الرهائن، وأطلقت الصواريخ، استؤنف القتال من خطوط وقف إطلاق النار في 1 ديسمبر/كانون الأول 2023. نُفّذ وقف إطلاق النار هذا، واتفاق إطلاق سراح الرهائن، بشروط مواتية لإسرائيل، حيث لم تنسحب القوات من الأراضي المحتلة، وكانت تعويضات الرهائن المفرج عنهم أقل بكثير من أي عرض نوقش لاحقًا. توصلت حماس إلى الاتفاق بعد حوالي شهر من القتال العنيف، حيث تلقّت ضربة موجعة وفوجئت برد فعل إسرائيل من جهة، ومن جهة أخرى، بعدم إدخال أي مساعدات إنسانية إلى القطاع.
نقل الجهود إلى خان يونس وبدء الغارات (1 كانون الأول 2023 – 7 نيسان 2024)
خلال هذه الفترة، نقل الجيش مركز عملياته إلى منطقة خان يونس، بينما خُفِّضَ تنظيم القوات العاملة في قطاع غزة خلال تلك الفترة، ونُقِلَت الفرقة 36 إلى الشمال (نهاية يناير 2024). خلال وقف إطلاق النار، جرت سلسلة من المناقشات بين القيادة الجنوبية وهيئة الأركان العامة حول مكان تركيز القتال المستمر. كان موقف القيادة الجنوبية هو استكمال الإنجازات العملياتية في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وعندها فقط يُنقل مركز الثقل جنوبًا.
كهدف لتركيز الجهود القادمة، تم بحث خياري خان يونس ورفح: خان يونس كمركز ثقل حكومي ثانٍ، وملجأ لكبار قادة حماس بقيادة يحيى السنوار، ورفح للأسباب نفسها المذكورة سابقًا. كان القرار بتركيز الجهود في خان يونس، ويعود ذلك أساسًا إلى إدراك جهاز الأمن العام إمكانية تضييق الخناق على يحيى السنوار وقيادات أخرى، في ظلّ الخوف من عملية في رفح، وذلك للاعتبارات نفسها المفصلة أعلاه.
خلال هذه الفترة، استمرّ القتال في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وتميّز بغارات مُوجّهة على مراكز ثقل حماس، كالأنفاق ومراكز القيادة والمستشفيات ومراكز القيادة التي وردت معلومات عن وجود قيادات فيها. قبل مغادرة الفرقة 36، أنجزت عملية لتدمير البنية التحتية لإنتاج الأسلحة لحماس، والمنتشرة في سلسلة من الأنفاق والمصانع العميقة تحت الأرض في منطقة المحور العرضي الرئيسي الذي يعبر قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب في قطاع المعسكرات المركزية. دمّرت هذه العملية الجزء الأكبر من الصناعة العسكرية لحماس، وأثّرت على قدرتها على تجديد مخزونها من الصواريخ والمتفجرات مع استمرار القتال. خلال هذه الفترة، تركزت معظم عمليات القيادة العسكرية على خان يونس بقيادة الفرقة 98، وكان الهدف الرئيسي من العملية هو استهداف يحيى السنوار ومجموعة من كبار قادة حماس المقربين منه. وقد تم نشر معظم القوات العاملة في قطاع غزة في منطقة خان يونس لهذا الغرض.
ابتداءً من شباط 2024، وبعد استئناف القتال، بدأت إسرائيل بإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تحت ضغط من إدارة بايدن وفي مواجهة تهديدات بفرض عقوبات وتعليق المساعدات الأمنية لإسرائيل. وانتهى نقاش بدأته القيادة الجنوبية حول ضرورة التحكم في المساعدات الواردة وإمكانية تشغيل حكومة عسكرية مؤقتة وجزئية في القطاع بتصريح من رئيس الأركان آنذاك، اللواء هرتسي هاليفي، يعارض تشغيل آلية تحكم من خلال حكومة عسكرية جزئية ومؤقتة، حيث قدم مسؤولو جيش الدفاع الإسرائيلي وهيئة الأركان العامة عرضًا تهديديًا للمستوى السياسي في مواجهة اقتراح إنشائها. كان البيان هو أن إدخال حكومة عسكرية في قطاع غزة سيتطلب ما مجموعه خمسة أقسام، وسيكلف 20 مليار شيكل سنويًا، وسيؤدي إلى زيادة في تكلفة المعيشة. العيش في إسرائيل – تحليل منفصل عن الواقع مصمم لردع صانع القرار عن اتخاذ قرار بشأن الحكم العسكري وإحباط أي محاولة لإجراء نقاش مهني حول هذه المسألة. ونتيجة لذلك، تم إدخال المساعدات إلى القطاع دون سيطرة ومراقبة على وجهتها، حيث كانت بمثابة أداة في أيدي حماس لتعزيز نفسها، وتمويل عملياتها، ودفع رواتب نشطائها، وتجنيد نشطاء جدد، والسيطرة على السكان. وبهذه الطريقة، إلى جانب العمليات العسكرية المكثفة، عملت دولة إسرائيل بفعالية على الحفاظ على قوة حماس وقدرتها على الحفاظ على حكمها.
نقل الجهود إلى رفح (7 نيسان – 6 أكتوبر 2024)
بالتوازي مع استمرار الانخراط في صفقات الأسرى ورفع حماس لمطالبها بصفقة أخرى، تجدد الحديث حول دخول رفح – آخر مدينة رئيسية غير محتلة من قبل الجيش، والتي تسيطر على المنطقة الحدودية مع مصر (محور فيلادلفيا) ومعبر رفح، الذي تمر عبره عمليات التهريب والتسليح التي تقوم بها حماس حتى أثناء القتال. قوبلت الخطوة في رفح بمعارضة شديدة من الإدارة الأمريكية، إلى جانب ضغوط دولية متزايدة، بالإضافة إلى معارضة من هيئة الأركان العامة، التي خشيت من مواجهة مع الإدارة الأمريكية وعواقبها. وإلى جانب الضغوط الخارجية ومعارضة رئيس الأركان آنذاك، كان هناك خطاب إعلامي وشعبي، بقيادة شخصيات رفيعة سابقة في الأجهزة الأمنية، حذرت من دخول رفح، وشبهتها بحصن منيع سيكلف الجيش ثمنًا باهظًا. بتوجيه من القيادة السياسية وبدعم من القيادة الجنوبية، تقدمت عملية الموافقة على عملية احتلال رفح. ورغم كل المعارضة، انطلقت الفرقة 98 من خان يونس في 7 نيسان استعدادًا لاحتلال رفح، استعدادًا لهجوم على رفح بالتوازي مع الفرقة 162، التي تحركت أيضًا جنوبًا من شمال قطاع غزة لتنفيذ العملية. بقيت قوة محدودة في قطاع شمال قطاع غزة، تسيطر بشكل رئيسي على منطقة محور نتساريم، المسؤول عن عزل شمال قطاع غزة ومدينة غزة عن الجنوب. قبلت القيادة الجنوبية الفرقة 99 للمهمة، إلى جانب لواءين احتياطيين. انتهى النقاش الداخلي حول احتلال المدينة بقرار مجلس الوزراء بشأن عملية في رفح، إلا أن آلية تنفيذ المناورة تغيرت، فبدلاً من الخطة التي وضعتها القيادة الجنوبية لمحاصرة المدينة واحتلالها، مع محاصرة الإرهابيين النشطين فيها والقضاء عليهم، تم اختيار بديل آخر، وهو خيار الدفع، حيث تهاجم الفرقة 162 من الجنوب إلى الشمال بموازاة محور الحدود مع مصر، على طول محور “فيلادلفيا”، بخطوط تقدم محدودة، يتحكم بها رئيس الأركان مباشرةً، وكأنها عملية خاصة تنفذها قوة صغيرة. كان الهدف من العملية بهذه الطريقة هو تمكين الإرهابيين من الفرار من رفح باتجاه خان يونس والرهائن في حوزتهم، مع تقدم تدريجي ومنضبط من الأعلى، مما صعّب على القوة التكتيكية مواصلة القتال، وتسبب في توقفات، تتعارض أحيانًا مع المنطق العملياتي. في إحدى الليالي، واجهت قوة من اللواء الرائد في الفرقة نيران أسلحة مضادة للدبابات على مدى عدة مئات من الأمتار، وهو ما كان خارج حدود قطاع الفرقة، وبدلاً من الرد التكتيكي الفوري على التهديد، تطلب الأمر تنسيقًا وموافقة من هيئة الأركان العامة، مما أخر عملية القوة.
بدأ الهجوم على رفح في 6 ايار 2024، واستمر كجهد قيادي مركزي حتى 12 ايلول. خلال هذه الفترة، سحقت الفرقة 162 لواء رفح، وقتلت أكثر من 2000 إرهابي، ودمرت بشكل منهجي الأنفاق تحت الأرض التي تمر بين رفح في غزة ورفح في مصر. بالتوازي مع قتال الفرقة 162 في رفح، تم تفعيل الفرقة 98، التي لم تكن جزءًا من مهمة تطويق المدينة، بتنسيق الغارات المذكور أعلاه، لثلاث عمليات فرقة. الأولى، في ايار 2024، في منطقة جباليا شمال قطاع غزة. الثانية، في حزيران 2024، في منطقة خان يونس، وهي عملية دُمجت مع “عملية أرنون”، والتي أُطلق فيها سراح أربعة رهائن إسرائيليين من منطقة النصيرات، والثالثة في آب 2024، مرة أخرى في خان يونس.
في أيلول 2024، غادرت الفرقة 98 قطاع غزة مُفضّلةً عملية في القطاع اللبناني. في الوقت نفسه، وسّعت الفرقة 99 سيطرتها على ممر نتساريم، مُحوّلةً إياه إلى ممر واسع خالٍ من البنى التحتية، سواءً فوق الأرض أو تحتها.
خلال هذه الفترة، وفي ضوء إدراك تأثير احتلال الأراضي وتدمير البنى التحتية على حماس، وبالنظر إلى ما كان يحدث في ممر نتساريم ورفح، وُضعت خطة في القيادة الجنوبية لعملية واسعة النطاق في شمال قطاع غزة. نظرًا لأنه كان من الواضح في هذه المرحلة أنه لا توجد الموارد اللازمة لتنفيذ عملية شاملة في القطاع بأكمله، فقد تم وضع خطة لتنفيذ عملية محدودة في شمال القطاع، وهي عملية ستكون قادرة على الاستفادة من إنجازات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة في بداية القتال وإحداث قرار وإكمال تحقيق الهدف الحربي الأول في شمال القطاع بأكمله وفي مدينة غزة، وهي منطقة تشكل حوالي 40٪ من القطاع بأكمله. في هذه المرحلة، بلغ عدد سكان المنطقة حوالي 300000 نسمة، والذين لم يتم إجلاؤهم في المرحلة الأولى. عارضت هيئة الأركان العامة الخطة، انطلاقًا من تفضيل أسلوب المداهمة والرغبة في تقليل ترتيب القوات وكمية الموارد المنتشرة في غزة. واستند ذلك إلى تحليل العبء على نظام الاحتياط، وحالة الأسلحة وقطع الغيار، والحاجة إلى الحفاظ على القدرات للساحة الشمالية.
غزو شمال قطاع غزة (6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 – 16 كانون الثاني 2025)
رغم معارضة هيئة الأركان العامة ونقل بعض القوات إلى الشمال، وُضعت خطة جزئية لهزيمة قوات حماس في شمال قطاع غزة والقضاء عليها. بعد عدة محاولات، وبدعم من القيادة السياسية، أُقرت الخطة المحدودة. اقتصرت الخطة على خط جباليا وشمالاً، ولصالحها، غادرت الفرقة 162 رفح، وحلت محلها فرقة غزة، التي تولت أيضاً مسؤولية منطقتي “فيلادلفيا” ورفح، بالإضافة إلى تكليفها بالدفاع عن قطاع غزة بأكمله.
كان الهجوم مُخططاً له في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أي قبل يوم من ذكرى الحرب، بهدف مُتعمد لتعطيل الاحتفالات التي خططت لها حماس. نُفذت الخطة كما هو مُخطط لها، ورغم محدودية القوات وندرة الموارد، فقد حققت إنجازات عديدة. تم القضاء على أكثر من 2000 إرهابي، وأسر الجيش الإسرائيلي عددًا مماثلًا. دُمّرت بنية تحتية تحت الأرض هامة، وأُعيدت جثث العديد من الرهائن إلى إسرائيل.
الأمر الأكثر أهمية هو تأثير الاحتلال وعملية السحق على قيادة حماس. تتحدث تصريحاتهم في تلك الفترة عن نوع مختلف من القتال، وتصريحات بأنه إذا استمر الجيش على هذا النهج، فلن يكون لهم نهوض. تطلب هذا الفهم مواصلة تعميق الإنجاز، والذي أصبح ممكنًا أيضًا بفضل انتهاء الحملة البرية في لبنان في نهاية شباط 2024.
بدلاً من تعميق الإنجاز، تقرر قبول عرض حماس بوقف إطلاق النار مقابل صفقة رهائن ثانية. تميزت هذه الصفقة بدفع ثمن باهظ لإطلاق سراح إرهابيين قتلة وتقديم كميات كبيرة من المساعدات. والأسوأ من ذلك؛ لأول مرة، وافقت دولة إسرائيل على دفع ثمن الإنجازات العملياتية المحققة بدماء جنودها، وانسحبت قوات الجيش من الأراضي المحتلة، بما في ذلك ممر نتساريم، مما سمح لمئات الآلاف من سكان غزة بالعودة إلى شمال القطاع، وتسبب في خسارة أحد أهم الإنجازات العملياتية التي تحققت في القتال، والذي شكّل نقطة ضغط مركزية على حماس، وذلك مقابل صفقة جزئية فقط. أشار سلوك قيادة حماس في تلك الأيام إلى أن الضغط العملياتي كان يعمل في الاتجاه الصحيح، ولو أننا عمقناه ووسعناه في ذلك الوقت كما هو مخطط له، إلى جانب سيطرة أكثر فعالية على المساعدات الإنسانية، لكان من الممكن تحقيق إنجاز منهجي أكبر، يصل إلى حد هزيمة حماس.
صفقة المختطفين الثانية (19 كانون الثاني – 18 آذار 2025)
خلال هذه الفترة، عُقدت صفقة الاختطاف الثانية. وفي إطار وقف إطلاق النار وإعادة تنظيم الجيش في المنطقة، أمر وزير الدفاع الجديد، يسرائيل كاتس، الجيش بالتخطيط لاستئناف القتال، في حال عدم تمديد الاتفاق لإعادة جميع المختطفين، بهدف هزيمة حماس واحتلال قطاع غزة خلال فترة تصل إلى ستة أشهر. أعدت القيادة الجنوبية خطةً بناءً على ذلك، ووافقت عليها مع رئيس الأركان هرتسلي هاليفي ومجلس الوزراء. عندها، تم استبدال رئيس الأركان. بعد استقالة هرتسي هاليفي وتعيين المقدم إيال زامير، الذي كان يشغل منصب المدير العام لوزارة الدفاع حتى ذلك الحين، تم استبداله في 5 آذار 2025. بناءً على طلب رئيس الأركان الجديد، وبعد الاطلاع على الخطة التي أُعدّت أثناء توليه منصبه، عُدّلت الخطة وأُضيفت قوات إلى القيادة الجنوبية، بحيث يُمكن هزيمة حماس في غضون ثلاثة أشهر بدلاً من ستة، وفقًا لطلبه وتوجيهاته.
استندت الخطة المُقدّمة إلى دروس قتال العام الماضي: إدراك ضرورة السيطرة على المساعدات الإنسانية وعدم تسليمها لحماس، وإدراك ضرورة فصل السكان عن حماس، وضرورة احتلال المناطق الرئيسية التي بقيت في أيدي حماس، وفي مقدمتها مدينة غزة، ووضع خطة تتوافق مع خطة الهجرة التي أعلنها الرئيس ترامب.
نظراً لأهمية ضبط الجهد المدني، ولأن هيئة الأركان العامة، حتى في عهد رئيس الأركان الجديد، عارضت فرض حكم عسكري، حتى ولو جزئياً ومؤقتاً، وُضعت أدوات بديلة. أولها المؤسسة الأمريكية (GHF)، التي أُنشئت لإنشاء هيئة تُعنى بضبط وتوزيع وتأمين المساعدات التي تدخل قطاع غزة، بحيث تصل إلى المواطنين مباشرةً دون أن تقع في أيدي حماس. ثانيها، الاستعانة بعناصر محلية فاعلة تُعارض حماس، مثل ياسر أبو شباب، زعيم عشيرة بدوية في جنوب شرق رفح. كانت الخطة التي وُضعت في القيادة الجنوبية، ووافق عليها رئيس الأركان إيال زامير مطلع آذار، فور توليه منصبه، تتألف من ثلاثة محاور: الأولى، السيطرة الكاملة على المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة بمساعدة المؤسسة الأمريكية. والثانية، عملية فصل السكان عن حماس، من خلال نقلهم إلى مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية بعد التدقيق والمراقبة، والعمل مع عناصر محلية فاعلة. ثالثًا، احتلال الأراضي التي بقيت تحت سيطرة حماس، حيث خُطط لعملية موازية في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وفي جنوبه في خان يونس ورفح، لتسريع عملية هزيمتها. وقدّرت القيادة الجنوبية أن التنفيذ المتزامن للخطة بجميع عناصرها سيؤدي إلى استسلام حماس أو تفككها خلال فترة تصل إلى ثلاثة أشهر. وكان من الواضح والمتفق عليه أنه حتى بعد تفكك المنظمة أو استسلامها، سيتطلب الأمر شهورًا طويلة من القتال لتطهير المنطقة وتحقيق السيطرة الكاملة، وهو ما يمكن تحقيقه بقوات متناقصة، بالتوازي مع تنظيم المنطقة للسيطرة على شكل فرقة وألوية مناطقية.