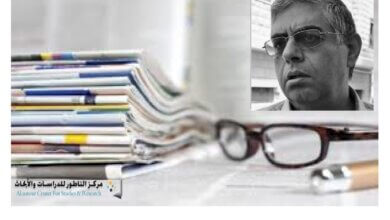ماجد كيالي- في ما يخص التعارض بين الهويةوالكيانية الفلسطينية

ماجد كيالي *- 27/11/2021
بات الكلام العمومي المرسل عن الهوية الوطنية الفلسطينية يحتاج إلى مزيد من التفحّص، والتعيين، والمطابقة، إذ أضحى ثمة بون شاسع بين التصور أو المتخيّل والواقع، وبين الإنشاء النظري والمعطيات العملية، بين الرغبات والبديهيات والمحددات، أو المحبطات، إذا أردنا الصدق مع أنفسنا، بمعزل عن محاولاتنا المكابرة وإنكار الواقع بتعقيداته ومشكلاته وتداخلاته وتحدياته.
ثمة اليوم فلسطينيون في مجتمعات منفصلة، منذ النكبة الأولى (1948)، وتعمق الأمر بعد النكبة الثانية (1967)، وتعمق أكثر بعد إقامة كيان السلطة الفلسطينية نتيجة اتفاق أوسلو (1993)، بدل أن يخفّ، نتيجة تهميش منظمة التحرير، وأفول الطابع التحرري للحركة الوطنية الفلسطينية، بإقامة سلطة لجزء من شعب في جزء من أرض مع جزء من حقوق.
هكذا بتنا إزاء واقع من مجتمعات فلسطينية متعددة، إذ يمكن أن نتحدث عن فلسطينيي 1948، أو عن فلسطينيي الضفة، أو فلسطينيي غزة (في ما بات يعرف بالداخل)، أو عن الفلسطينيين اللاجئين في الخارج، في الأردن ولبنان وسورية والعراق ومصر، كل على حدة، وطبعاً ثمة بلدان الشتات على امتداد قارات الدنيا، علماً أن كل تجمّع له خصوصياته ومشكلاته وأولوياته، وسلطاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعلماً أن السلطة تعتبر نفسها معنية بالفلسطينيين في الضفة والقطاع، والمشكلة أن هؤلاء باتوا تحت سلطتين كل واحدة مختلفة عن الأخرى، بل وتنازع أخرى، ربما بما لا يقل عن منازعتها إسرائيل.
هذا التوصيف للواقع لا يلغي أن ثمة شعباً فلسطينياً واحداً لديه سردية تاريخية واحدة، وآمال مشتركة، لكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تبقى مطلقة وثابتة مع تعقيدات الواقع، والخضوع لأنظمة مختلفة، ومرور أكثر من سبعة عقود، ومع غياب منظمة التحرير، ككيان وطني جامع، وتجوف حركة التحرر الفلسطينية، بتحولها سلطة تحت الاحتلال. والمعنى أن حقيقة وجود الفلسطينيين كشعب لا تبقى هي ذاتها، في الظروف المذكورة، إذ إنها بدورها تتعّرض للتآكل، أو الإزاحة، لمصلحة حقائق أخرى، أو لمصلحة التمايز، وحتى الافتراق، في إدراكات الفلسطينيين ومصلحتهم وأولوياتهم في كل تجمع إزاء التجمع الآخر.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية استطاعت في الستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي، أن تتشكّل كـ “بوتقة صهر” للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، حتى أن تأثيراتها وصلت إلى فلسطينيي 1948، على رغم الخلل المتمثل بعدم إيجاد الأطر التي تمكّن هذا التجمّع من الانخراط في المنظمة مباشرة أو مداورة.
ثمة مشكلتان هنا، أولاهما، أن “بوتقة الصهر” تلك اشتغلت، أو تركّزت، على الإدراكات الهوياتية الجمعية من دون أن تقرن ذلك بإنشاء أطر أو مؤسسات وطنية جامعة ومستدامة، بل إن كل ما تم بناؤه على هذا الصعيد جرى تهميشه أو التخلّي عنه، بحكم ضعف إدراكات آباء الحركة الوطنية الفلسطينية لأهمية مثل تلك البنى، في حراكات وكيانات طغت عليها الروح الشعاراتية والمزاجية وتقديس العمل المسلح وغياب المراجعات النقدية، والاهتمامات الثقافية والمجتمعية.
أما المشكلة الثانية، فهي ناجمة عن أن وجود المنظمة، التي استنهضت الوجود الفلسطيني في مرحلة، بما لها وما عليها، ما أدى في ما أدى إليه إلى ضمور المجتمع المدني في تجمعات الفلسطينيين والهيمنة عليه، أو طبعه بطابعها، ما نجم عنه أيضاً تهميش دور الطبقة الوسطى، إذ تماهت غالبية الفلسطينيين، بنخبهم، مع منظمتهم، تأتي في إطار ذلك الطبقة الوسطى بمثقفيها وأكاديمييها. وبالنتيجة فإن انحسار مكانة هذه المنظمة، وأفول دورها، وترهّل بناها، أدت إلى نتائج سلبية جداً، إذ خسر الفلسطينيون في ذلك منظمتهم، أو الإطار الجمعي الذي يمثّلهم، ويعبّر عن آمالهم وهمومهم المشتركة، وفي الوقت ذاته كانوا خسروا طبقتهم الوسطى، كما خسروا تبلورهم باتجاه مجتمع مدني، وإن في إطار مجتمعات أخرى يعيشون بين ظهرانيها.
في المحصلة فإن الفلسطينيين اليوم، الذين يعتبرون من أكثر مجتمعات المنطقة ثقافة وحراكات سياسية، باتوا يفتقدون أي تعبيرات مستقلة، عن حقلهم السياسي المهيمن عليهم، بعد أن أضحت المنظمة بمثابة “رجل مريض”، وبعد أن باتت السلطة معنية بجزء من الفلسطينيين، وبعد أن غدت معظم الفصائل أثراً من الماضي، قد لا يقبلها حتى “متحف التاريخ”. يفاقم من ذلك أن الطبقة الوسطى، في كل تجمعات الفلسطينيين، تبدو منكفئة على ذاتها، وتفتقد المبادرة والجرأة والاستقلالية، كأنها فقدت فاعليتها، وتخلّت عن دورها القيادي، أو الحامل للتغيرات، كحال الطبقات الوسطى في مختلف المجتمعات الحديثة والحية والفاعلة.
مثلاً، ليس للفلسطينيين محطة فضائية أو صحيفة أو جامعة، ناهيك بأكثر من واحدة، فما هو موجود مجرد محطات أو صحف لفصائل، أو لبعض التجمعات، أو للسلطة في الضفة أو غزة. حتى المجلس الوطني الفلسطيني، وهو المنبر الجامع لكل الفلسطينيين، تم تغييبه طويلاً، وهذا ينطبق على الفصائل، ومن ضمنها “فتح”، التي باتت تعبّر عن الفلسطينيين في الداخل (أراضي الـ 1967)، بل حتى عن فلسطينيي الضفة أكثر بكثير من كونها تعبّر عن الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة.
ما تقدم يفيد بأن الفلسطينيين، بقياداتهم وطبقتهم الوسطى ومثقفيهم، معنيون بإدراك أن العيش على السرديات التاريخية لم يعد يكفي، كي تبقى إدراكات الشعب لذاته أو لهويته بوصفه شعباً هي ذاتها، فكيف إذا كان هذا الشعب مجزّأ ويعيش في ظروف مختلفة؟ والقصد إن اختلاف أوضاع الفلسطينيين يفتح على التمايز والافتراق في رؤيتهم لذاتهم ووعيهم لمصالحهم وأولوياتهم، وهذا ناجم بدوره عن نشوء سرديات جديدة أخرى، مع نشوء أجيال جديدة، إذ إن الحديث يجري عن عقود، وليس عن سنوات، وهذه السرديات من شأنها أن تزيح سابقاتها، أو تغطيها، أو تهمشها، كي تحلّ محلّها.
هذه الحقيقة الصعبة والمرّة والقاسية، الناشئة عن الظروف الخاصة للفلسطينيين، ينبغي إدراكها جيداً، لإيجاد الحلول لها، بدل المكابرة والإنكار والتهرب، مع ملاحظة أن هذا الأمر يجري مع غياب منظمة التحرير، وأفول حركة التحرر الفلسطينية، وشيوع حال الإحباط والضياع والتفكّك في مجتمعات الفلسطينيين، وضعف مبادرة الطبقة الوسطى، يفاقم من ذلك ما جرى لفلسطينيي سورية ولبنان والعراق، وما يجري بين كياني السلطة في الضفة وغزة.
المهم اليوم العمل على تعزيز المشتركات، على حساب الاختلافات، على صعيد الهموم والمصالح والأولويات، بين الفلسطيني اللاجئ والفلسطيني في مناطق 1948 أو الفلسطيني في الضفة أو غزة.
القصد من هذا الكلام دق جرس الإنذار بأن الأمر لم يعد يتعلق بتفكيك القضية الفلسطينية وتصفيتها على ما يحلو لأرباب الأيديولوجيات والمبادئ والفصائل الحديث عنه، إذ إن الأمر يتعلق أساساً، وقبل أي شيء، بتفكيك مفهوم الشعب الفلسطيني، أو بتقويض هذا المفهوم، وجعله من دون معنى.
عموماً تلك المسألة ليست من مسؤولية منظمة التحرير فقط، إذ هي مسؤولية الطبقة الوسطى من الفلسطينيين، مثقفين وأكاديميين وفنانين، من المعنيين، قبل أي أحد آخر، ببعث الروح بالهوية الوطنية الفلسطينية، وحراسة سرديتهم التاريخية، ليس بمعنى إغلاقها، وتحويلها إلى “تابو”، وإنما بمعنى إغنائها واستكمالها بسرديات الفلسطينيين الجديدة، لأنها ليست مجرد سردية متخيّلة، بل لأنها سردية واقعية متأسسة على طلب الحقيقة والعدالة والحرية والكرامة، باعتبار ذلك بمثابة المدخل المناسب لتحرير الفلسطيني من سرديته الخاصة وبناء سردية مغايرة.
هكذا، فعندما تحدث بنديكت اندرسون عن “الجماعات المتخيلة”، وعن دور التخيّل في بناء الهويات أو الجماعات القومية، كان يتحدث عن كيفية تحويل التخيّل إلى قوة في الواقع، وسردية الفلسطينيين، بصورها ورموزها وأحداثها، أصلاً ليست متخيّلة، أي منبثقة من الواقع أساساً، في حين أن الواقع هو الذي يتغير، أي أن الفلسطينيين في حالتنا يخسرون سرديتهم، أو إدراكاتهم عن ذاتهم، ويخسرون أيضاً واقعهم ومستقبلهم كشعب، في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، ما يضفي صدقية على المقولة التي سعت الحركة الصهيونية، منذ قرن، لترويجها، والمتعلقة بعدم وجود الشعب الفلسطيني، أو باعتبار أن “الكبار يموتون والصغار ينسون”، على حد قول لجون فوستر دالاس (وزير خارجية أسبق للولايات المتحدة) في زمن مضى.