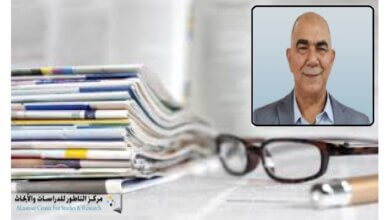بكر أبو بكر: لماذا خصّنا (خصّني) الله بالمصائب؟

بكر أبو بكر 7-10-2025: لماذا خصّنا (خصّني) الله بالمصائب؟
لماذا يبتلينا الله نحن دونُا عن سائر الأمة؟!
لماذا تطرق رأسنا المصائب دونًا عن سائر الناس؟
ولماذا المآسي والأحزان والمشاكل و…. تتوالى علينا-فقط؟
ولماذا أنا، أو نحن بالذات؟
مثل هذه الأسئلة الكثير مما قد يرد على ذهن الانسان عامة.
وفي الحالة الفلسطينية نجد أنفسنا منذ بداية القرن العشرين ونحن تحت نار الاستهداف الحارقة، من قبل قوى الاستخراب العالمي. ومما يقع من فكر استخرابي (استعماري) ثم احتلالي إحلالي نجد البلايا والرزايا والمصائب تحيق بأرض فلسطين، ولاحقًا بما أصبح قضية فلسطين وبالشعب الفلسطيني في كل جهة من جهات الأرض في فلسطين ثم بخارجها ما طال الشعب العربي الفلسطيني بالداخل والخارج.
الثورة والجهاد ضد الاستسلام
الجهاد بالإسلام جهاد (بمعنى استفراغ الوسع والطاقة) بأنواع عدة ومنها جهاد النفس والذات، وجهاد العلم والأدب، وجهاد الدعوة، وجهاد الطغاة والبُغاة والمنحرفين والفُسّاق وأصحاب الفتن-وما أكثرهم هذه الأيام- باليد او الكلمة، وجهاد حفظ القرآن، وجهاد الحفاظ على حياة الناس وثباتهم، وجهاد مقارعة العدو الغاصب او المحتل…، ومنها جهاد رعاية الأبوين…الخ مما ذكرته الصحائف المختلفة. وهو إذ كان داخلي بالذات الانسانية فيقصد ردّ شرورها، أو تهذيبها داخليًا وتحقيق رفعتها أو اتزانها.
وحسب العالم الحصيف شيخ الإسلام ابن تيمية فإن: “الجهاد في سبيل الله تعالى مِن الجُهد، وهي المغالبة في سبيل الله بكمال القدرة والطاقة، فيتضمن شيئين: أحدهما: استفراغ الوسع والطاقة. والثاني: أنْ يكون ذلك في تحصيل محبوبات الله، ودفع مكروهاته، والقدرة والإرادة بهما يتم الأمر”.
وقال ابن رشد: “الجهاد المبالغة في إتعاب الأنفس في ذات الله، وهو على أربعة أقسام: جهاد بالقلب أن يجاهد الشيطان والنفس عن الشهوات المحرمات، وجهاد باللسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وجهاد باليد أن يزجر ذوو الأمر أهل المناكر عن المنكر بالأدب والضرب على ما يؤدي إليه الاجتهاد في ذلك…”
والجهاد خارجيًا يخرج من تلك النفس المتعلمة المجاهدة المتزنة التي تصالحت مع ذاتها ونجحت في غزو مجالها فخرجت منتصرة فحلقت في سماء الطاعة والايمان والثبات، وعليه تصبح هذه النتيجة للصراع الداخلي وجهاده ما إذا انطلق للخارج (للآخرين ويُنقل لهم) جهادًا خارجيًا يُؤجر عليه المسلم والمؤمن.
الجهاد أو الثورة او المقاومة أو الكفاح أو النضال بمصطلحات الحرب الشعبية طويلة المدى أوطويلة النفس او بمصطلحات كافة حركات التحرر منذ القرن العشرين لا تخرج لا ذاتيًا ولا جماعيًا عن ذات المفهوم الذي يفترض أن هناك شرًا أو فسادًا أو ظلمًا يجب التخلص منه، وهنا يبدع المجاهدون أو الثوار أو المقاومون باجتراح الوسيلة (والأصوب عديد الوسائل) لتحقيق النصر.
قال تعالى في سورة الحج بأول ما نزل إذنا بالجهاد ضد الظُلاّم عامة (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ).
لم تقف قيادة الثورة الفلسطينية الحديثة منذ العام 1965م، بقيادة ياسر عرفات، ومن سبقها أيضًا وبخصوص الذكر ثورة عزالدين القسام وصحبه، وعبدالقادر الحسيني ثم طليعة الشعب الفلسطيني-في كل مرحلة- عند حد الشعور بالغُبن والظُلم والمأساة، أو أنهم تحت المصائب والبلايا ما (يؤهلهم) للخنوع او الاستسلام أو الركون للغير ليقوم عنّا بما هو متوجب علينا (كما كانت فكرة أن الأمة هي من ستحررنا، ونحن قاعدون تحت شعارات مختلفة)، فهذا لم يقع ولن يقع.
العمل والإقدام والاندفاع بشجاعة وإيمان وعزيمة، وحسابات عقلانية ووعي وإبداع لتحقيق الهدف بكل السُبُل مطلب الثوار، والتوقف والتقييم والمراجعة والنقد ضرورة.
ولكن اتخاذ ذلك مسلكًا للهروب من التبِعات جريمة، وهو ما لم تفعله طلائع الشعب الفلسطيني لا على الصعيد العام (على صعيد القضية الفلسطينية وأن فلسطين كلها لنا، وأننا جزء من الحضارة والامة العربية الاسلامية بالإسهامات المسيحية المشرقية، وأننا في فلسطين وبلاد الشام خصّنا الله بالرباط والجهاد).
كما لا يتوجب الركون أو الهروب او الاستسلام على الصعيد الشخصي، فمنا من استشهد أباه أوابنه أو أمه أو زوجه أو أي من أقربائه او أصدقائه، ومنهم -أي من الناجين- مَن زالت ملامح ذكرياته كليًا سواء في القدس أو يافا او صفد أو بئر السبع أو حيفا، او مما هو حاصل حالياً في كل أنحاء قطاع غزة الفلسطيني أو بالضفة الفلسطينية في كل حارة وكل قرية وكل مخيم وكل مدينة.
البلايا والفتى الملموم
البلايا والمصائب قد تأتي متتابعة وفقد تأتي فُرادَى. ولكن الانسان المكلوم عندما يحلّ به البلاء (الفردي) يتوجس من كل فرح! ويترقب كل ترح! وقد يظن أن ما به لا نظير له!
لذا يرى الرزايا متتابعة مُسقطًا ما بين البلية والأخرى ما قد يكون نعمة وهبة من الله.
إن النظر الى المصائب نظرة إيجابية أو بتفاؤل هو صفة الانسان المجاهد بالله، ولذاته ومن أجل وطنه، أو قيمه السامية.
وإن صفة الانسان الايجابي المتفائل هي سمة المقاوم المقاتل المرابط لا يتوانى عن نقد ذاته حين تخور أو حين تنحني، أو نقد نفسه حين تنهزم ذاتيًا، فلا يتكوّر على نفسه قائلًا مع الشاعر العربي تميم بن مقبل “ما أطيبَ العيشَ لو أن الفتى حجرٌ تنبو الحوادثُ عنهُ وهو ملمومُ”.
إن الثائر هو الإيجابي القادر على النهوض من وحل المصائب ومستنقع الظلم، ونار المآسي، فيستعيد توازنه، ويسير الى الأمام -أو بطريق متعرج بعيدًا عن الألغام كما كان يردد الخالد ياسر عرفات- ليصل مبتغاه سواء الشخصي أو العام.
الحياةُ صعودٌ وهبوط
قال صلى الله عليه وسلم: “لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء (ضيق المعيشة والمرض)، حتى يأتيهم أمر الله. وهم كذلك”، قالوا: يا رسول الله وأين هم؟ قال: “ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس”.
انطلقت الثورات والحراكات والانتفاضات والهبَات في فلسطين لتجعل من فكرة الكرب الناشئة عن الظلم أو الاستخراب (الاستعمار) أو اللجوء والمذابح والمقتلة والطرد من الأرض أرض فلسطين محطة للنهوض وليس محطة للخنوع فكانت فلسطين جوهرة الأمة، وقضيتها المركزية وشملنا الله وخّصنا (فلسطين والشام) بالجهاد والنضال، وكما هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فماذا نريد أكثر من ذلك؟!
قد يرى البعض في هكذا نظرة إيمانية تبريرًا للضعف أو للمصائب، أو مواساة دينية تمر وتمضي! وما هو كذلك. فالإنسان خُلِق للأعمار، وخُلق ليحقق توازنه الشخصي والرباني والمادي لذا فمن المنطقي أن نجد الخلخلات والتذبذبات الكثيرة في الحياة صعودًا الى الأعلى وهبوطًا الى الأسفل، فكيف لك أن ترى وسطية أو توازنا تفهمه وتدركه وترنو لتحقيقه إن لم ترى خلخلة ومصائبًا، وصراعًا ونضالا، وفي النضال والجهاد والصراع الفلسطيني (الفردي والجماعي) رسالة ونضال ومثابرة، أي ديمومة حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولا.
حرية العقل والإيمان
سقطت الفكرانيات (الأيديولوجيات) في وقت مضى كان يتحكم بالعقول فرضياتها الثقيلة، ويفترض صاحب الفكرانية أو أختها النقيضة ارتباطه بتاريخ ما، أو بهذه الدولة أو تلك بما يشكل الملجأ أو المنعزل الحامي، وافترض آخرون بعواصم بلدان أنها رباط الخيل لنا، ليجد كل الفكرانيون (الشيوعيون، والقوميون الأنويون-الشوفينيون، والاسلامويون…) أن الفكرانية لا قيمة لها في ظل الفهم الذاتي لحقيقة الخلق بالإيمان والإعمار والاستخلاف الرباني.
فنحن كلنا لله، ولا يحق لأحد مقابل الآخر أن يدعي إيمانه وينقصه أو يبخسه بغيره.
لا يحق لأي كائن أن يحمل عصا الإيمان والكفر ليشير بها الى هذا أو ذاك كما تفعل أو فعلت عدد من التنظيمات الاسلاموية المتطرفة، ومثيلاتها بالديانات الأخرى.
ولا يحق لأي كان أن يكتب صكًا (وثيقة) للغفران الديني أو القومي أو الاشتراكي أو الوطني او الديمقراطي لأي كان. فالإسلام (أو المسيحية) أو أي دين (بالأصح ملّة) هو بفهمه الصحيح ملك لكل انسان صلته الوحيدة مع الخالق سبحانه، وليس لأي عليه من سلطة أرضية إنسانية مقدسة.
وليس على أي شخص واعي أو فاهم للفكرة أي فكرة الا رباط القانون (قانون الدولة، قانون المجتمع…) حاكمًا، ورباط الأخلاق والقيم التي متى ما كانت مرتبطة بالدين سمَت وعظُمت، وبالعقل الانساني لاحقًا لتتخذ من حريتها ارتباطًا بالله سبحانه وتعالى والقضية.
لست وحدك
نعود للبلايا والمصائب والمآسي ونحن كما قد يقول البعض نحن شعب المآسي وفيها هذا لربما إغراق بالأنوية (الشوفينية) فلكل شخص أو شعب فترات تردد من صعود أو هبوط، وفي حالتنا الحالية لك أن تجد ما يحصل في أرجاء الأمة العربية مثلما هو حاصل في السودان وليبيا والصومال وسوريا وفلسطين ولبنان…. وغيرها من دولنا العربية، والاسلامية من بلايا وحروب ومقتلة.
فلكل نصيبه من الامتحان الرباني، فلست وحدك-كشخص أو شعب أو جماعة- المبتلى، وما لنا الا ثلاثية: حمل الرسالة والنضال والمثابرة. وأيضًا الإعداد لكل أمر، والله معنا.