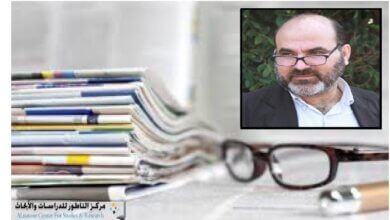كيف نمنع تفريغ التحرر الفلسطيني دون الوقوع في وهم الإصلاح أو عجز القطيعة؟
لم يعد الخطر الذي يواجه القضية الفلسطينية محصورا في سياسات الاحتلال أو في الغطرسة الأمريكية المتجددة، بل بات متمركزا في الطريقة التي يُعاد بها تعريف الفلسطيني سياسيا:
ليس بوصفه شعبا يخوض صراع تحرر،
بل جماعة سكانية تُدار، تُغاث، وتُعاد هندسة شروط حياتها بمعزل عن السيادة والقرار.
هذه اللحظة ليست طارئة، وليست مجرد نتاج لحرب إبادة، أو لعودة ترامب إلى البيت الأبيض، بل هي ذروة مسار طويل بدأ حين جرى تفريغ السياسة الفلسطينية من معناها التحرري، واستُبدلت بإدارة الأزمة، ثم بإدارة السكان، وأخيرا بإدارة ما بعد الكارثة.
ليست المشكلة في أن تُدار الحياة بعد الكارثة، بل في الطريقة التي تُدار بها، وفي اليد التي تمسك بمفاتيح الإدارة، وفي السقف السياسي الذي لا يُقال صراحة، لكنه يُفرض عمليا. هنا تحديدا يبدأ التحوّل من العنف الصريح إلى العنف الناعم، من القتل المباشر إلى إعادة ترتيب المجتمع تحت الضغط.
أولا: التكنوقراط ليسوا المشكلة، بل الفراغ الذي استدعاهم
الخطأ ليس في الكفاءة، ولا في التخصص، ولا في إدارة شؤون الحياة اليومية لشعب محاصر ومنكوب. الخطأ الجوهري هو تحويل التكنوقراط من أداة مساعدة إلى بديل عن القرار السياسي.
فالتكنوقراط لا يظهرون في الفراغ، بل يُستدعون حين:
• تُعطّل الإرادة الوطنية،
• تُفرغ المؤسسات التمثيلية من مضمونها،
• ويتحوّل الصراع إلى ملف تقني.
هنا لا يعود التكنوقراط حلا مؤقتا، بل يصبحون آلية لإدامة نزع السياسة، لا بفعل نواياهم، بل بوظيفة الموقع الذي وُضعوا فيه.
حين تُطرح “اللجنة” بوصفها حلا، ينصبّ النقاش غالبا على أسمائها، كفاءتها، أو توازنها الفصائلي. لكن هذا النقاش يُخطئ الهدف. فالسؤال الحقيقي ليس: من يجلس؟ بل: من يختار؟ من يموّل؟ من يملك حق الإقالة والتعليق؟
في السياق القائم، لا تُشكَّل مثل هذه اللجان بقرار سيادي فلسطيني، بل ضمن منظومة تفويض خارجي مشروط:
• تمويل مرتبط بالالتزام السياسي والأمني،
• معابر تُفتح وتُغلق كأداة ضبط،
• زمن إداري يُدار من الخارج: تمديد، تعليق، مراجعة.
بهذا المعنى، لا تكون “التكنوقراطية” خروجا من السياسة، بل شكلها الأكثر تهذيبا. الإدارة هنا لا تُنهي الاحتلال، بل تُعيد تنظيمه وتكريسه على مستوى أقل صخبا، وأكثر اختراقا، وأقل كلفة.
من هنا، لا يكون التحدي في رفض أي إدارة مؤقتة لشؤون الحياة، بل في منع انزلاقها من وظيفة تقنية إلى موقع قرار سياسي. فالإدارة التي لا تُقيَّد بسقف زمني غير قابل للتمديد، ولا تُحصر بصلاحيات غير سيادية، ولا تخضع لمساءلة مجتمعية علنية، تتحوّل – بحكم الواقع لا النوايا – إلى شكل مهدّب من أشكال الحكم المفروض. إن الحد الأدنى المطلوب ليس شيطنة التكنوقراط، بل نزع القدرة عن أي إطار إداري على إعادة تعريف الصراع أو استبدال الإرادة الوطنية بوظيفة تنفيذية.
ثانيا: آليات الضبط – كيف تُدار الحياة كوسيلة ضغط؟
السلطة الفعلية لا تكون داخل اللجنة، بل خارجها. القوانين واللوائح ليست أدوات الضبط الأساسية، بل: الاقتصاد، الأمن، والزمن،
الرواتب، فرص العمل، المساعدات، العلاج، إعادة الإعمار، كلها تتحوّل إلى أدوات مشروطة، لا حقوقا أساسية. وحين تصبح الحياة نفسها قابلة للسحب، تتحوّل الإدارة إلى وصاية، لا خدمة.
الخطر هنا لا يكمن في “سوء النوايا”، بل في بنية التحكم التي تجعل أي إدارة – مهما حسنت نوايا أفرادها – جزءا من منظومة ضغط أوسع.
ثالثا: غزة كفاعل، لا كموضوع إدارة
في كثير من الخطابات، تظهر غزة: كجسد مُستهدف، كمجتمع مهدَّد، كوعي يُعاد تشكيله. لكن نادرا ما تُرى كقوة اجتماعية – سياسية حيّة، تمتلك قدرة على التنظيم والفرض، ولو في حدودها الدنيا.
هذا الغياب ليس لأن الفاعل الفلسطيني غير موجود، بل لأنه مستهدف ومُعطَّل: شبكات التكافل، المبادرات المحلية، أشكال التنظيم تحت النار، القرار الجماعي اليومي للبقاء.
كلها أشكال فاعلية لا تمر عبر القنوات “المعترف بها”، ولذلك يُنظر إليها كفوضى يجب ضبطها، لا كقدرة يجب البناء عليها.
المرحلة الثانية لا تأتي لملء فراغ، بل لتفكيك الفاعلية المحلية: بتجاوز التمثيل، وفصل الإدارة عن الإرادة، وتجريد المجتمع من أدوات الفرض.
حماية غزة كفاعل تعني الاعتراف بأشكال التنظيم القاعدي القائمة كمصادر شرعية للفعل، مثل لجان الأحياء، فرق الإغاثة، والمبادرات المجتمعية، التي تشكل آخر خطوط الدفاع عن الإرادة الجماعية، وليس ضبط الفوضى.
رابعا: الخطاب الداخلي – ضرورة التمييز لا التعميم
ليس كل نقد خيانة، ولا كل حديث عن الشرعية تحريضا. النقد السياسي الحقيقي ضرورة لحماية المجتمع من التكلّس، وهو شرط لأي إعادة بناء ذات معنى. لكن الخطر يبدأ حين:
• يتحوّل النقد إلى اختزال للتجربة كلها في صورة سوداء واحدة،
• وتُستخدم اللغة لإغلاق الأسئلة لا لفتحها،
• ويُعاد تعريف المشكلة بعيدا عن الاحتلال، ليصبح “الداخل” هو العائق الوحيد. هنا يجب التمييز بين: نقد سياسي يوسّع الأفق، وبين تحريض يصنع عدوا داخليا، ودعاية وظيفية تُسوّق شروط الخارج بلغة خلاص.
هذا التمييز ليس ترفا، بل شرط أخلاقي لمنع الفتنة من التحوّل إلى أداة حكم. إن ضبط الخطاب الداخلي لا يعني تقييد النقد أو تحصين السلطة، بل منع تحويل اللغة إلى أداة لإعادة إنتاج الانقسام الاجتماعي وتبرير الوصاية.
فالفتنة لا تبدأ بالرصاصة، بل بالكلمة، السياسة، أو الخطاب السياسي الذي يعيد تعريف الخصومة السياسية بوصفها تهديدا وجوديا داخليا، وتفتح الطريق أمام حكم بلا مساءلة.
خامسا: الانقسام لم يعد خلافا، بل نظام حكم
لم يعد الانقسام الفلسطيني مجرد انشطار سياسي أو جغرافي، بل تحوّل إلى بنية سلطوية مستقرة:
• ينتج شرعيات متوازية،
• يخلق مصالح مادية وتنظيمية،
• ويوفر للخارج ذريعة دائمة لتجاوز الفلسطيني كفاعل سياسي موحد.
الأخطر أن هذا الانقسام لم يعد يُدار كأزمة يجب حلها، بل كنمط حكم يُعاد إنتاجه، بحيث يصبح أي مسار وحدوي تهديدا لبنى قائمة، لا أفقا وطنيا جامعا.
إذا كان الانقسام قد تحوّل إلى نظام حكم، فإن مواجهته لا تبدأ بشعار “إنهائه”، بل بتجريد هذا النظام من وظائفه الحيوية. فالإغاثة، والإعمار، والتمثيل السياسي الخارجي، ليست ملفات قابلة للإدارة الانقسامية دون كلفة وطنية جسيمة. كلما جرى التعامل مع هذه الملفات خارج إطار وطني جامع، تعمّق الانقسام بوصفه بنية حكم لا مجرد خلاف سياسي.
سادسا: أين يكمن الاشتباك الحقيقي؟
المرحلة الثانية لا تُفجّر الصراع دفعة واحدة، بل تُوزّعه على تفاصيل الحياة. نقاط الاشتباك الأساسية ستكون:
• السلاح والأمن: من يُجرَّم؟ ومن يُحمى؟
• الاقتصاد والعمل: من يعمل؟ ومن يُقصى؟
• الشرعية والخطاب: من يُعترف به؟ ومن يُوصم؟
هنا يتحوّل الانقسام من سياسي معلَن إلى وظيفي ومعيشي، وهو أخطر أشكال الانقسام، لأنه طويل الأمد وصامت.
سابعا: من “الشعب” إلى “السكان” التحول الصامت
أخطر ما يجري اليوم ليس فرض حلول مجحفة، بل إعادة تعريف القضية نفسها. حين يُفصل:
• الإعمار عن السيادة،
• الإغاثة عن السياسة،
• الإدارة عن التمثيل،
يُعاد تعريف الفلسطيني ليس كصاحب حق تاريخي، بل كمشكلة إنسانية تحتاج إلى تحسين شروط العيش. هذا التحول لا يتم بخطاب عدائي، بل بلغة ناعمة: “اليوم التالي”، “التهدئة الطويلة”، “الإدارة الرشيدة”، وكلها مصطلحات تُخفي نزع الطابع التحرري عن الصراع.
ثامنا: الواقعية ليست استسلاما، إنما إدارة للصراع لا لنتائجه
ليس المطلوب رفض كل تكتيك مرحلي، ولا إنكار موازين القوى القاسية، بل التمييز الحاسم بين:
• واقعية سياسية تُدير الصراع دون إعادة تعريف الحقوق الوطنية والتاريخية الثابتة للشعب الفلسطيني في وطنه ومرتكزها الحرية والعودة وتقرير المصير، فالحقوق ثابتة وحق للأجيال وليس لأي جيل حق لإعاده تعريفها تحت وطأة تغير موازين القوى القابلة للتغييرعند تفعيل الإرادة.
• واقعية لا تغير الأهداف وإنما مناهج واستراتيجيات بلوغها بوعي معرفي لطبيعة الصراع الوجودي مع الكيان الصهيونى العنصري الاستيطانيّ الإحلالي الوظيفي ما يتعذر معه مهادنته والتعايش معه.
• وبين استسلام مقنّع يُدير نتائج الهزيمة ويطلب التكيّف معها
الواقعية السياسية لا تعني القبول بإدارة الاحتلال، بل تعني:
الحفاظ على البوصلة، منع تحويل المؤقت إلى دائم، ومنع الحلول التقنية من التحول إلى بدائل سياسية.
تاسعا: استعادة منظمة التحرير ليست شعارا، بل شرطا
الدعوة إلى إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير لا يمكن أن تبقى في مستوى الحنين أو الخطاب العام. فالمنظمة لا تُستعاد بوصفها مؤسسة إدارية، ولا كغطاء شرعي فارغ، بل كإطار صراع تحرري وتمثيل ومساءلة، عبر إعادة بناء شرعيتها التمثيلية، فصلها عن إدارة السلطة اليومية، وإعادتها إلى موقع قيادة المشروع الوطني التحرري، لا إدارة قيوده. من دون ذلك، ستبقى كل اللجان، مهما حسنت نواياها، تعمل في فراغ سياسي قاتل.
عاشرا: الإغاثة ضرورة، لكن ربطها بالسيادة واجب
إنقاذ أهلنا في غزة أولوية وطنية وواجب سياسي وأخلاقي لا نقاش فيه.
لكن تحويل الإغاثة إلى بديل عن التحرر هو جريمة سياسية.
المعادلة الواضحة يجب أن تكون:
• الإغاثة: حق إنساني غير مشروط،
• الإعمار: فعل سيادي مرتبط بقرار وطني، وتحميل مرتكبي الإبادة كلفة إعادة الإعمار،
• الإدارة: وظيفة سياسية تخضع للشرعية، لا تقنية محايدة.
أي فصل بين هذه المستويات هو خطوة إضافية في مسار تفريغ القضية من مضمونها.
حتى في غياب السيادة الفعلية، يبقى ربط الإغاثة بخطاب المسؤولية السياسية للاحتلال حدا أدنى من الفعل السيادي الرمزي، يمنع تطبيع الجريمة كقدر، ويُبقي الإعمار فعل مساءلة لا إحسان.
حادي عشر: الإرادة لا تُستعاد بقرار، بل بتراكم
لا وهم قوة هنا، ولا قفز فوق الواقع. الإرادة الوطنية لا تُستعاد بمرسوم، بل: بتراكم الفعل الجماعي، باستعادة الثقة بين الشعب وممثليه، وبإعادة السياسة إلى موقعها الطبيعي: تنظيم الصراع لا إدارة الخراب.
ثاني عشر: السياسة أو الغياب
ما نواجهه اليوم ليس فقط خطر حلول مفروضة، بل خطر غياب السياسة الفلسطينية نفسها. إما أن نعيد بناء السياسة بوصفها فعل تحرر، أو سنُدار، مهما حسنت النوايا، كـ“سكان” في معازل محسّنة الشروط، منزوعة السيادة.
والخيار رغم كل شيء، لم يُحسم بعد.
ثالث عشر: الأفق البديل – بوصلة لا وصفة
ليس المطلوب خطة جاهزة ولا وعود خلاص. المطلوب حدّ أدنى من البوصلة الجماعية يمنع الانجرار إلى الأسوأ. يمكن تلخيص هذا الأفق في ثلاث حدود لا يجوز تجاوزها:
الأول: لا إدارة بلا إرادة فلسطينية
الثاني: لا إعمار مقابل نزع الفعل
الثالث: لا شرعية تُبنى ضد المجتمع
ما عدا ذلك تفاصيل قابلة للنقاش والتغيير.
رابع عشر: ما الذي لا يجوز أن نصبحه
المرحلة الثانية ليست عودة سلطة، ولا هزيمة فصيل، ولا انتصار أسماء. هي مفترق طريق يُعاد فيه تعريف السياسة، والمعنى، ودور المجتمع. الخطر ليس فيما يُقال علنا، بل فيما يُدار بهدوء. وليس في القذيفة، بل في المسار.
في لحظات كهذه، لا يكون المطلوب فقط أن نعرف إلى أين سنصل، بل أن نعرف ما الذي لا يجوز أن نصبحه: مجتمعا يُدار بدل أن يقرّر، وعيا يُعاد تشكيله بدل أن يُنتج، وقضية وطنية تُختزل في إدارة الحياة تحت شروط الاحتلال.
من يملك البصيرة سيحرس المعنى قبل المواقع، ويمنع الفتنة قبل أن تتجذّر، ويُبقي البوصلة حيث يجب، في معركة لم تنتهِ بعد.