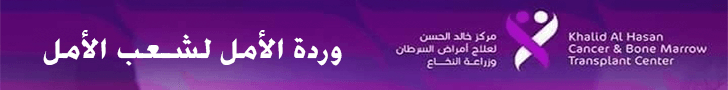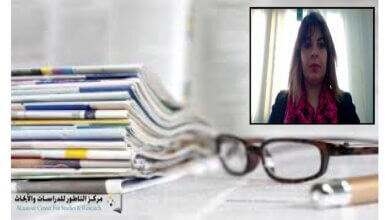يحيى عباسي بن احمد: من الأمة إلى غزة: هندسة الاستعمار للوعي العربي، قراءة في ضوء مالك بن نبي

يحيى عباسي بن احمد 21-11-2025: من الأمة إلى غزة: هندسة الاستعمار للوعي العربي، قراءة في ضوء مالك بن نبي
ملخص
يهدف هذا البحث إلى تحليل التحوّل التاريخي–الخطابي الذي أصاب مركزية القضية الفلسطينية في الوعي العربي، من موقعها الأصلي كـ”قضية أمّة” إلى واقعها الراهن كـ”قضية قطاع غزة”. يستند التحليل إلى أدوات معرفية مستمدة من فكر مالك بن نبي، خاصة مفاهيمه حول “مراصد الاستعمار” و”القابلية للاستعمار” و”دوائر الفعل الحضاري”. ويكشف البحث عن آليات اشتغال هندسة الوعي الاستعمارية عبر المصطلح، والإعلام، والحدود السياسية، وتحوّلات الدولة الوطنية بعد الاستقلال. وينتهي بأن تحجيم القضية لم يكن مجرّد حدث سياسي، بل كان عملية إعادة تشكيل للخيال الجمعي العربي، قادته بنى الاستعمار الحديث، وتواطأت معه تجارب التجزئة والأنظمة القُطرية.
مقدمة:
تشكّل فلسطين إحدى أكثر القضايا رسوخًا في المخيال الجمعي العربي والإسلامي. غير أنّ ما شهدته من تحوّل مفاهيمي–خطابي يثير سؤالًا معرفيًا شديد الحساسية: كيف انتقلت من كونها قضية أمّة إلى أن تُختزَل في قطاع غزة؟
هذا الانتقال ليس انكماشًا جغرافيًا فحسب، بل هو تحوّل بنيوي في الوعي، يعكس اشتغال منظومة استعمارية جديدة لم تعد تعتمد على الاحتلال المباشر بل على الهندسة الذهنية.
يتقاطع هذا التحول مع أطروحات مالك بن نبي (1905–1973) حول “القابلية للاستعمار”، و”عالم الأفكار”، و”مراصد الاستعمار”؛ وهي الأطروحات التي تناولت شروط تفكيك الوعي وقدرة القوى المهيمنة على إعادة صياغة المعنى. ومن هنا تبرز إشكالية هذا البحث.
إشكالية البحث
تتمحور الإشكالية حول السؤال التالي:
ما الآليات الخطابية والسياسية والمعرفية التي مكّنت الاستعمار من تحجيم القضية الفلسطينية من أفق الأمة إلى إطار محلي ضيق، كما تجلّى في مرحلة غزة، وفق منظور مالك بن نبي؟
أسئلة فرعية
- كيف يشتغل “المصطلح” كأداة استعمارية لإعادة تشكيل الوعي العربي؟
- ما الدور الذي لعبته الدول الوطنية بعد الاستقلال في تكريس هذا التحجيم؟
- كيف تُفعّل “مراصد الاستعمار” آلياتها في الفضاء الإعلامي والسياسي؟
- ما علاقة هذا التحول بمفهوم “القابلية للاستعمار”؟
فرضيات البحث
- المستعمر المعاصر لا يتحرك عبر الاحتلال الجغرافي وحده، بل عبر إعادة هندسة الوعي.
- تغيّر المصطلح من “قضية الأمة” إلى “القضية الفلسطينية” ثم إلى “غزة” يعكس مسارًا مقصودًا لا بريئًا.
- الأنظمة القُطرية العربية أسهمت — بوعي أو دون وعي — في بناء السياج الذي حاصر القضية.
- الوعي الشعبي العربي تعرض لعملية “تفتيت” تتوافق مع ما يسميه بن نبي “تفكك عالم الأفكار”.
منهج البحث
يعتمد البحث منهجين متداخلين:
- تحليل الخطاب (Discourse Analysis)
لتفكيك المصطلحات، الإطارات المفاهيمية، بنية الخطاب الرسمي والإعلامي.
- منهج تحليل المفاهيم (Conceptual Analysis)
لفهم وظيفة المصطلحات في تشكيل الإدراك الجمعي، وربطها بنظرية “مراصد الاستعمار”.
- القراءة السوسيولوجية–الفكرية لفكر مالك بن نبي
باعتباره الإطار الفلسفي الذي يفسر التحوّل في بنى الوعي العربي.
الإطار النظري
- مراصد الاستعمار عند مالك بن نبي
يعرّف بن نبي “مراصد الاستعمار” بأنها منظومة تتكوّن من أجهزة سياسية وثقافية وإعلامية تعمل على مراقبة حركة الأفكار داخل العالم الإسلامي، والتدخل لإعادة توجيهها بما يخدم مصالح القوى المهيمنة[1]. هذه المراصد لا تهدف إلى الاحتلال العسكري بقدر ما تهدف إلى إعادة صياغة المعنى.
- القابلية للاستعمار
يرى بن نبي أن الاستعمار الخارجي لا ينتصر إلا حين يجد تربة داخلية تستقبله، أي “قابلية للاستعمار”[2]. وهي حالة يخلي فيها المجتمع مسؤوليته الحضارية، فيفرّط في وحدته ومشروعه.
- هندسة الوعي
هندسة الوعي هي استخدام أدوات معرفية وخطابية لإعادة تعريف الأشياء في الوعي الجمعي. وهي أساس الفعل الاستعماري الجديد كما يظهر في فلسطين.
الفصل الأول: المصطلح كأداة استعمارية – من الأمة إلى العرب
- مركزية المصطلح في تشكيل الوعي
المصطلح ليس مجرد كلمة، بل هو إطار إدراك (Frame) يحدد ما نراه وكيف نفهمه. حين تغيّر المصطلح تغيّر الفكرة، وحين تغيّر الفكرة تغيّر السلوك.
- كيف أُسقطت المرجعية الأمة؟
في بدايات القضية، كان الخطاب يقول: “قضية الأمة”.
بهذا المصطلح كانت:
- فلسطين جزءًا من الوعي الديني والأخلاقي للأمة.
- “التفريط فيها” تفريطًا في الذات الحضارية.
- كل مسلم طرفًا أصيلًا لا متضامنًا.
لكن المراصد الاستعمارية عملت على نقل المصطلح إلى: قضية العرب.
وهنا وقع أول كسر للأفق الإسلامي الواسع.
- دلالات التحول
- إخراج المسلمين غير العرب من دائرة المسؤولية.
- حصر الصراع في القومية العربية، التي كانت بدورها مشروعًا هشًا.
- تحويل الصراع من صراع تحرّر حضاري إلى صراع سياسي قابل للتفاوض.
هذا ما يسميه بن نبي تفتيت عالم الأفكار الكبرى[3].
الفصل الثاني: من “قضية العرب” إلى “القضية الفلسطينية” – صناعة السياج القطري
- ولادة الدولة الوطنية بعد الاستقلال
كانت الدولة الوطنية العربية — كما يقول بن نبي — “نسيجًا استعماريا بوجه محلي”[4] ، إذ حافظت على التجزئة الجغرافية.
- كيف تحوّلت القضية إلى ملف قطري؟
- أصبح الفلسطيني “صاحب القضية”، والعربي “متضامنًا”.
- صارت فلسطين شأنًا دبلوماسيًا يدار في الجامعة العربية.
- وتحوّلت الأنظمة إلى حراس للحدود لا للوحدة.
- أثر هذا التحول على الوعي الشعبي
تحول الوعي من:
- “الأمة تُستباح”
إلى
- “الفلسطينيون في محنة”.
وهو تحوّل لا يقل خطورة عن الاحتلال ذاته.
الفصل الثالث: من “القضية الفلسطينية” إلى “قضية غزة” – اكتمال التفتيت
- آلية الاستعمار في تفتيت الجغرافيا
بعد أوسلو وما تلاها، دخلت القضية في طور جديد:
- الفصل بين الضفة وغزة.
- خلق إدارات منفصلة.
- صناعة الفصل الداخلي الفلسطيني.
- غزة كملف إنساني
تحويل غزة من جزء من قضية تحرّر إلى “مشكلة إنسانية” يخدم سردية:
- العزل،
- الإغاثة،
- إدارة الأزمة،
- نزع الطابع السياسي.
- اكتمال هندسة الوعي
عندما يصبح الخطاب العالمي يتحدث عن:
- “وقف إطلاق النار في غزة”،
- “المساعدات الإنسانية إلى غزة”،
- “مستقبل غزة”،
فهذا يعني أن الإطار المرجعي قد تبدّل بالكامل، وأن الوعي العربي أُعيد تشكيله.
الفصل الرابع: دور الأنظمة في صناعة السياج
- الأنظمة كامتداد للمنطق الاستعماري
الأنظمة العربية — في جزء كبير منها — لم تخرج من “عقلية الاستعمار” رغم خروج الاستعمار المادي.
فهي:
- كرّست الحدود،
- حاربت المبادرات الشعبية،
- سخّرت القضية لشرعيتها،
- وأدخلتها في دائرة “التوظيف السياسي”.
- المزايدة كبديل عن الفعل
مع الوقت، أصبحت القضية منصة للخطابات لا للأفعال.
وهي الظاهرة التي انتقدها بن نبي بوصفها “بنية العجز الحضاري”.
الفصل الخامس: الفرد بين القابلية والتحرّر
- استهداف الوعي الشعبي
المراصد الاستعمارية لا تشتغل مع الأنظمة فقط، بل مع الفرد أيضًا:
- تحويل فلسطين إلى خبر.
- تحويل النضال إلى ترف عاطفي.
- زرع شعور العجز.
- القابلية للاستعمار كشرط للانكماش
حين يفقد الفرد حسّ الانتماء للكلّ الحضاري، تصبح القضية خارج مجال فعله.
المناقشة
يكشف التحليل أن التحجيم لم يكن نتيجة “الواقع الجغرافي”، بل نتيجة هندسة فكرية–خطابية عملت على مراحل.
وقد اشتغلت المراصد الاستعمارية عبر:
- إعادة إنتاج المصطلحات.
- خلق حدود نفسية قبل الحدود السياسية.
- تفتيت الفضاء العربي إلى وحدات صغيرة.
- تحويل القضية إلى ملف إداري ثم إنساني.
وكل ذلك ترافق مع “قابلية داخلية” سهّلت المهمة.
الخاتمة
يتبين من خلال البحث أن القضية الفلسطينية لم تُختزل طبيعيًا، بل أُعيد تشكيلها عبر هندسة استعمارية واعية.
لم يكن الانتقال من الأمة إلى غزة تحولاً جغرافيًا، بل هو انهيار في هندسة الوعي.
إن فهم هذا المسار شرط لاستعادة فلسطين كقضية تحرّر حضاري، لا كملف إغاثي.
وهو الفهم الذي ينادي به مالك بن نبي حين يجعل تحرير الوعي مقدمة لتحرير الجغرافيا.
هوامش:
[1] بن نبي، مالك. مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي. دار الفكر، 1970، ص 44.
[2] بن نبي، مالك. شروط النهضة. دار الفكر، 1948، ص 19–21.
[3] المرجع نفسه، ص 88.
[4] بن نبي، مالك. مذكرات شاهد للقرن. دار الفكر، 1969، ص 112.