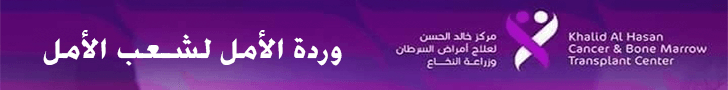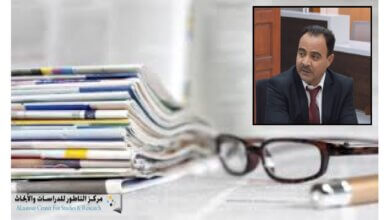يحيى عباسي بن أحمد: حين تموت الفكرة في المصطلح، تفكيك لغوي لمفهوم “القضية الفلسطينية”

يحيى عباسي بن أحمد 20-11-2025: حين تموت الفكرة في المصطلح، تفكيك لغوي لمفهوم “القضية الفلسطينية”
المقدمة
يُعدّ المصطلح في الفكر الإنساني أكثر من مجرد وعاء لغوي أو اتفاق تداولي، فهو كائنٌ دلاليّ حيّ يختزن في بنيته رؤية للعالم، ويؤطر الوعي الجمعي بما يتجاوز حدود اللفظ إلى فضاء الفكر والفعل. فالكلمات ليست محايدة كما يُخيّل، بل هي ـ كما قال رولان بارت ـ «لا تُسمّي الأشياء فحسب، بل تُعيد تشكيل العالم على صورتها»[1]. من هنا، تكتسب اللغة في المجال السياسي بُعدًا سلطويًا، إذ تُستخدم لتوجيه الإدراك، وصياغة المواقف، وصناعة القبول الجمعي.
في هذا السياق، برز مصطلح “القضية الفلسطينية” بوصفه أحد أكثر المفاهيم تداولًا في الوعي العربي المعاصر. غير أنّ كثرة تكراره واستعماله المألوف أفرغته من محتواه الأصلي، فتحوّل من رمزٍ للتحرّر إلى شعارٍ استهلاكيّ فاقد الفاعلية. وقد ساهم هذا التحوّل في صناعة فكرة ميتة ـ على حدّ تعبير النص الذي شكّل منطلق هذه الدراسة ـ أي فكرة فقدت قدرتها على الإلهام والتعبئة، بعدما تجمّدت في قوالب لغوية جامدة.
يهدف هذا المقال إلى تفكيك المصطلح من منظور لغوي وفكري، للكشف عن البنية الخطابية التي أعادت إنتاج الوعي الفلسطيني والعربي ضمن منظومة لغوية مفرغة من دلالاتها الكفاحية، مستعينًا بمناهج تحليل الخطاب وفلسفة اللغة، وبالنظر في التحولات السياسية التي رافقت هذا الانزياح اللغوي.
الإشكالية وأهداف الدراسة
تقوم إشكالية البحث على سؤالٍ محوري:
هل ما زال مصطلح “القضية الفلسطينية” يؤدي وظيفة تحررية، أم تحوّل إلى خطابٍ ميتٍ يُنتج اللاموقف ويؤبّد العجز؟
ينبثق من هذا السؤال جملة من الإشكالات الفرعية:
- كيف تُنتج المصطلحات الوعي السياسي وتعيد تشكيله؟
- متى فقد مصطلح “القضية الفلسطينية” فاعليته الرمزية؟
- وهل يمكن القول إنّ اللغة نفسها ساهمت في نزع الطابع الحيّ عن الفكرة الفلسطينية؟
تهدف الدراسة إلى:
- تحليل البنية اللغوية والدلالية للمصطلح.
- ربط تحوّله بالسياق السياسي العربي والدولي.
- اقتراح قراءة جديدة تُعيد للفكر الفلسطيني والعربي قدرته على تجاوز قيود اللغة.
الإطار النظري: اللغة والمصطلح والسلطة
يرى الفيلسوف لودفيغ فيتغنشتاين أنّ «حدود لغتي هي حدود عالمي»[2]، وهو قول يُلخّص جوهر العلاقة بين اللغة والوجود؛ فالكائن الإنساني لا يدرك العالم إلا من خلال وساطة اللفظ. وبذلك، يصبح من يملك الكلمة يملك القدرة على تحديد ما يمكن التفكير فيه، وما لا يمكن تصوّره أصلًا.
أما رولان بارت، فقد كشف في تحليله للأسطورة الحديثة أنّ اللغة قادرة على تحويل التاريخ إلى طبيعة، أي على إفراغ الظواهر من واقعها المادي لتبدو وكأنها حقائق أبدية. وهذا ما يحدث حين يُكرَّر مصطلح ما إلى حدّ التقديس، فينزع عنه الوعي معناه التاريخي والسياسي، ويتحوّل إلى دالٍّ بلا مدلول أو إلى ما يسميه إرنستو لاكلو “العلامة الفارغة”[3]
بهذا المعنى، لا يمكن فصل المصطلح عن شبكة السلطة والمعرفة التي تنتجه، إذ ليس كل ما يُتداول لغويًا بريئًا أو عفويًا. فالمؤسسات السياسية والإعلامية تسهم في تثبيت دلالات معينة وتهميش أخرى. ومن هنا فإنّ “القضية الفلسطينية” ليست مجرد تركيب لغوي، بل نتيجة لتاريخٍ من الصراع على الخطاب، شاركت فيه القوى الاستعمارية كما شاركت فيه الأنظمة العربية التي تبنّت المصطلح وسوّقته حتى صار جزءًا من اللغة اليومية، دون مساءلة لمعناه الفعلي أو لدوره في الوعي الجمعي.
تحليل مصطلح “القضية الفلسطينية“
ظهر التعبير “القضية الفلسطينية” في الخطاب العربي والدولي منذ بدايات القرن العشرين، مع بروز الوعي السياسي بالاستعمار الصهيوني وتداعيات وعد بلفور (1917). غير أنّ تكراره المتواصل عبر المنابر الرسمية والإعلامية جعل منه مصطلحًا مألوفًا، فاقد الصدمة والمعنى.
من الناحية اللغوية، يتكوّن المصطلح من مضاف ومضاف إليه: “القضية” و”الفلسطينية”.
- كلمة “قضية” في اللغة العربية تحمل دلالات قانونية، ترتبط بالمحاكمة والبتّ والحكم، أي أنّها تُحيل إلى شيءٍ ما يُنظر فيه، ينتظر قرارًا خارجيًا من جهةٍ عليا.
- أما “الفلسطينية”، فهي صفةٌ تُحيل إلى الانتماء الجغرافي، فتجعل الوطن موضوعًا للنقاش، لا ذاتًا فاعلة.
هذا التركيب إذن يُعيد تشكيل الوعي الفلسطيني في صورة موضوعٍ محلّ نزاع، لا فاعلٍ يقاوم من أجل حريته. وبهذا، فإن المصطلح ـ رغم صداه العاطفي ـ يحمل في طيّاته نزعًا للفاعلية عن الإنسان الفلسطيني وتحويله إلى مجرّد طرفٍ في ملفٍّ دوليٍّ مؤجّل.
لقد تحوّل اللفظ إلى ما يمكن تسميته بـ”اللغة الميتة”، أي اللغة التي تكرّر نفسها دون أن تُنتج أثرًا في الواقع. وكما يقول عبد الوهاب المسيري: «حين تتحوّل الكلمات إلى شعارات، تنفصل عن التجربة وتصبح جزءًا من نظامٍ رمزيٍّ مغلق»[4]. وهكذا، صارت “القضية” غطاءً يُخفي تحت عباءته العجز السياسي العربي، ومفردةً مريحة تُتيح للضمير الجمعي التهرّب من المواجهة.
من التحرير إلى “القضية”: تحوّل الخطاب العربي
لم تكن اللغة دائمًا بهذا القدر من السكون. ففي خمسينيات وستينيات القرن الماضي، كان الخطاب العربي يتحدث عن “تحرير فلسطين”، وعن “الثورة الفلسطينية”، وهي تعبيرات مشبعة بالدينامية والفعل. لكن مع مرور الزمن، وخصوصًا بعد هزيمة 1967، بدأ الخطاب الرسمي العربي يتبدّل تدريجيًا، متخليًا عن مفردات الفعل إلى أخرى أكثر حيادًا وتهذيبًا، مثل “القضية الفلسطينية” و”العملية السلمية” و”المفاوضات”.
كان هذا التحوّل نتيجة لتبدّل الموازين السياسية ولتراجع المشروع القومي العربي، فصارت اللغة نفسها تعكس حالة الانكسار. فحين تُستبدل كلمة “تحرير” بـ”قضية”، يتحوّل الفعل إلى اسمٍ جامد، وتُختزل المأساة في ملفٍّ قابل للتأجيل.
وهذا ما يعبّر عنه المفكر إدوارد سعيد حين يقول: «حين تُستبدل الجغرافيا بالخطاب، تُصبح الأرض مجرّد نصٍّ يُدار بالكلمات لا بالدم»[5]. فالمصطلح هنا لم يكن بريئًا، بل أداة لتأبيد الوضع القائم، إذ حوّل الصراع من ميدان الفعل إلى ميدان الخطاب.
بنية الفراغ: «العلامة الفارغة» وفعل التجويف
إنّ أحد أعمق مفاتيح فهم تحوّل “القضية الفلسطينية” من فعلٍ إلى اصطلاحٍ جامد يكمن في مفهوم العلامة الفارغة (Empty Signifier) لدى إرنيستو لاكلو[6]: مصطلحٌ يَحمل قيمةً رمزيةً تسمح له بأن يستوعب مطالب متعدّدة ومتناقضة، لكنه في الوقت نفسه يظلّ خالياً من محتوى محدّد، فتحلّ بدلاً منه وظيفة إيديولوجية تمثيلية تُبطئ الاحتواء الفعلي للمطالب.
في السياق الفلسطيني، صارت «القضية» علامةً فارغة تحمِل في طياتها مصائر وأوجاعًا متعددة: حقّ العودة، الاستقلال، المقاومة، الأمن، الحماية الدولية، وغيرها. لكنّ هذه القدرة على “الاحتواء” سرعان ما تُستغل سياسياً: فكلما ازدادت القدرة الدلالية للمصطلح على الامتداد، قلّت إمكانات تحديده كبرنامج عملي واضح؛ وبذلك يتحوّل المصطلح إلى سلطة خطابية تُرجئ الحسم الفعلي إلى إطارٍ نظري/تعبوي لا عملي.
تعمل هذه العلامة الفارغة كغشاء؛ تسمح بالتماهي الرمزي مع المصطلح (نشعر بتعاطفٍ وجدانيّ حين نقول “القضية”) لكنها تمنع بلورة برنامج تحريريّ واضح أوُصُولٍ عمليّةٍ ذات نتائج ملموسة. وهنا يأتي دور الإعلام والأنظمة الدولية والإقليمية: بتكرار المصطلح وإتاحته كعنوان شامل، تخلق خطابًا يطمس الحدود بين الواجب العملي والنداء الرمزي؛ أي يحوّل الفعل إلى كلام، والمطلب إلى بند في جدول تفاوضي.
اللغة كآلية تأبيد: من الأسطورة إلى الطبيعة
رولان بارت[7] يذكرنا بأنّ الأسطورة لا تنفي الأشياء بل “تطهرها” وتحوّلها إلى أمورٍ طبيعيةً قابلة للاستيعاب والقبول دون سؤالٍ نقدي. عندما تُكرَر عبارة “القضية الفلسطينية” في مناسباتٍ سياسية وثقافية وإعلامية متعدِّدة، فإنّها تهضم اختلافاتٍ عميقةً وتُقدّم القضية كـ”واقع ثابت” يستدعي إجراءات روتينية (جلسات، بيانات، مبادرات دبلوماسية) بدل أن يقتضي فعلًا تحرريًا يتطلب تضحية وسننًا عملية.
وهنا يتحقّق ما يمكن تسميته «أسطَرةُ المأساة»: تجعل من الفلسطينيّة حالةً رمزيةً تُستهلك شعوريًا، ويصبح التعامل معها إداريًا وقانونيًا ــــ بينما الاحتياج الفعلي للفعل (مقاومة، بناء مؤسسات، تعبئة شعبية مؤثرة) يتعرّض للضعف والاستيهام. بعبارة أخرى: الأسطورة تجعل المسألة “قضية” قابلةً للتأجيل، لأن شكلها الرمزي يبدو مقبولًا لدى جمهورٍ واسع، في حين أنّ المخرج العملي يتطلب تعدّي هذا القبول إلى فعلٍ ملموس.
سياق التحول السياسي: من مشروع التحرير إلى إدارة النزاع
لا يمكن فهم التجويف اللغوي بمعزل عن التحولات السياسية الواقعية: الهزائم العسكرية، التقلبات في موازين القوى الإقليمية والدولية، صعود منطق الدول-اللاعب وحكم “دولة مقابل دولة”، وضغط مفاهيم “السلام” و”التسوية” التي ترجمت الخلاف إلى مفاوضات ثنائية. هذه الدينامية السياسية أعادت تشكيل المفردات: “تحرير” استبدِل بـ”حلّ”، “عودة” استُبدِل بـ”ممّا هو ممكن”، وميدانًا للمقاومة تحوّل إلى طاولة مفاوضات.
إدوارد سعيد، من جانبه، نبّه إلى كيف يمكن للخطاب أن يستأثر على المكانة السياسية؛ عندما يتحكّم الخطاب الدولي في تعريف الحالة الفلسطينية، يصبح من الصعب إنتاج قراءة مغايرة داخل المجال العام الغربي. بمعنى آخر، استبدال الأرض بـ«النصّ» (أي إدارة السؤال عبر الخطاب) يؤدي إلى خفض سعر الفعل كخيار سياسي، ويزيد من فرص بقاء المصطلح كقناعٍ على واقعٍ معقّد.
المقاومة اللغوية: كيف نُعيد للفكرة حيويتها؟
إذا كانت المشكلة لغوية-خطابية وسياسية في آنٍ معًا، فالحل لا يكون مجرد استبدال كلمة بكلمة، بل إعادة بناء مشهدٍ دلالي وسياسي قادر على تحويل العلامات الفارغة إلى مضامينٍ عملية. هذه المهمة تتألف من عناصر متكاملة:
- استعادة الفعل في الخطاب: استبدال الصيغ السلبية (قضية، نزاع، مفاوضات) بصيغ تُظهِر الفعل والاستمرارية (فعل التحرير، برامج استراتجية، بناء المؤسسات).
- تفكيك الهيمنة الخطابية الدولية: إنتاج سردية موازية وموثّقة تُعيد التاريخ والواقع الفلسطينيين إلى مركز المعنى لا إلى هامش الخطاب الدولي.
- ربط المصطلح بالبرنامج: تحويل أي تسمية عامة إلى برنامج تنفيذ واضح ومؤشرات أداء تُقاس بها النتائج على الأرض (مساحات معيّنة تعاد، مؤسسات تُبنى، شبكات مدنيّة تُنشأ).
- تجريد المصطلح من الوصمة الاستهلاكية: مقاومة تحويل المعاني إلى شعاراتٍ تلقائية عبر تعليم نقدي وتثقيف ثقافي يعيد للغة طاقتها الفعلية.
هذه الخطوات ليست وصفة سحرية فورية؛ لكنها شروط ضرورية لخلق خطابٍ فلسطيني-عربي لا يكتفي بالتسمية بل يطالب بالتحقّق.
هوامش: التحوّل من شعارٍ إلى برنامج يستلزم أدوات قياس وسياسات ملموسة — دراسات مفهومية عن السياسات التحررية توفّر إطارًا لذلك.
خاتمة: إعادة تسمية الفعل بدل تسمية الجراح
إنّ ما نؤكّده هنا ليس إنكارًا لواقع الألم أو تهميشًا لتضامن الشعوب، بل نقدٌ لآليةٍ لغوية وسياسية عملت على تجميد الفعل وتحييد الفاعلية عبر تحويل ما كان فعلًا إلى لفظٍ يُستهلك. عندما نصير علاّمةً فارغةً، نصبح عرضةً للاستثمار الخفيض للفعل، نصبح عنوانًا يهدأ أمامه الضمير دون أن يطالب بالتحوّل إلى فعل.
لذلك، لا يُطلب من الخطاب الفلسطيني أن يتخلى عن رمزيته أو وحدته، بل أن يعيد لنفسه أدوات التحديد والبرمجة: أن يجعل من “القضية” مشروعًا، ومن المصطلح مهمةً قابلة للقياس والتنفيذ، ومن اللغة جسرًا يؤدّي إلى الفعل لا قارورة تُحتفظ بها الذّاكرة وتعتّق عليها الأجيال. هذا هو معنى إعادة الحياة للمصطلح: أن نجعله حيًا بالفعل، لا حيًّا في الذاكرة وحدها.
هوامش الخاتمة: هذا الاستنتاج يلتقِط تحذيرات نظرية حول مخاطر بقاء المصطلحات كعلامات فارغة ويدعو إلى سياسة لغوية-عملية.
[1] رولان بارت، أسطوريات، ترجمة محمد البكري، دار توبقال، الدار البيضاء، 1993، ص. 22.
[2] لودفيغ فيتغنشتاين، رسالة منطقية فلسفية، ترجمة فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1983، ص. 88.
[3] إرنستو لاكلو وشانتال موف، الهيمنة والاستراتيجية الاشتراكية، ترجمة فواز طرابلسي، دار الطليعة، بيروت، 1992، ص. 57.
[4] عبد الوهاب المسيري، الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ، دار الشروق، القاهرة، 2003، ص. 15.
[5] إدوارد سعيد، مسألة فلسطين، ترجمة فواز طرابلسي، دار الآداب، بيروت، 1992، ص. 44.
[6] تعريف لاكلو حول العلامة الفارغة وشرحها مفيد لتشخيص هذه الظاهرة كما طُوّرت في الأدبيات النقدية المعاصرة.
[7] تحليل بارت للـ mythologies يفسّر كيف تتحوّل المصطلحات إلى آليات تطهير رمزي تخفي الواقع الاجتماعي والسياسي.