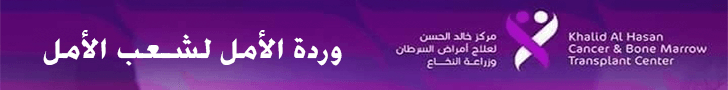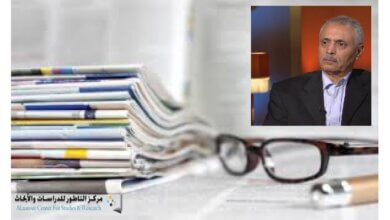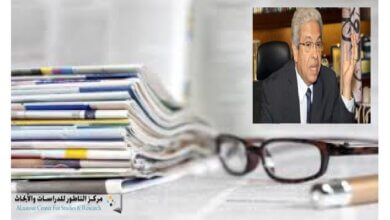د. عمرو حمزاوي: فرص إنهاء المأساة الإنسانية وإعادة إعمار غزة

د. عمرو حمزاوي 7-10-2025: فرص إنهاء المأساة الإنسانية وإعادة إعمار غزة
يشكّل القبول المتزامن من قبل الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس لخطة ترامب للسلام، المعلنة في أكتوبر 2025، لحظة سياسية غير مسبوقة في مسار الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي. فبعد أعوام من المواجهة المفتوحة، ومن حروب إبادة وتدمير ممنهج للبنية التحتية في قطاع غزة، ومن انهيار شبه كامل للمؤسسات المدنية والاقتصادية، يلوح في الأفق احتمال واقعي لبدء مسار جديد يعيد الاعتبار للسياسة بعد هيمنة العنف. وفي ظل الإرهاق الذي أصاب جميع الأطراف الإقليمية والدولية، يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن توظيف هذا القبول المشترك لإنهاء المأساة الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار على أسس تضمن الأمن والاستقرار؟
لا يمكن فهم التحول في موقفي إسرائيل وحماس إلا في ضوء الإرهاق البنيوي الناتج عن الحرب الطويلة على غزة، وضغوط الرأي العام الدولي، والتغيرات التي أصابت البيئة الإقليمية خلال العامين الماضيين. فالحرب الأخيرة كشفت هشاشة الوضع الإنساني في غزة، وأظهرت حدود القوة الإسرائيلية، كما دفعت حماس إلى مراجعة أدواتها السياسية والعسكرية بعد خسائر بشرية ومؤسساتية جسيمة. من جهة أخرى، مثّل تراجع الانخراط الأمريكي المباشر في إدارة الصراع خلال السنوات الماضية، وعودة واشنطن مؤخرًا إلى الساحة عبر خطة ترامب الجديدة، عامل جذب للطرفين الباحثين عن مخرج سياسي يوقف النزيف ويعيد ترميم الشرعية أمام جمهور مرهق من الحروب.
على المستوى الدولي، لم يعد بالإمكان تبرير استمرار الوضع القائم. فالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول الجنوب العالمي التي صارت تمتلك نفوذًا دبلوماسيًا متناميًا، تتعامل اليوم مع غزة بوصفها أزمة إنسانية كبرى لا يمكن احتواؤها بآليات المساعدات المؤقتة. وقد جاء إعلان الخطة في أكتوبر 2025 كتعبير عن هذا الإدراك الجماعي بضرورة الانتقال من إدارة الأزمة إلى تسويتها السياسية.
يجد القبول الإسرائيلي بالخطة جذوره في ثلاثة عوامل رئيسية: أولها الاحساس المتزايد في إسرائيل بأن الردع العسكري فقد فاعليته تجاه غزة، وأن استمرار الحرب يهدد تماسك المجتمع الإسرائيلي نفسه. ثانيها ضغوط الحليف الأمريكي الذي أعاد ربط المساعدات والتعاون الاستراتيجي بمسار سياسي واقعي يخفف حدة الصراع. وثالثها الرغبة في كسر العزلة الدولية التي تزايدت بعد تقارير الجرائم الإنسانية وتراجع الدعم الأوروبي.
أما حماس، فقد وجدت في الخطة مخرجًا واقعيًا من مأزق الحصار والانهيار الداخلي. فالقبول بالخطة لا يعني التخلي عن سردية المقاومة، بل إعادة صياغتها ضمن مشروع سياسي يعترف بوجود دولة فلسطينية محدودة السيادة في غزة وأجزاء من الضفة، مع ترتيبات أمنية تضمن بقاء الحركة طرفًا رئيسًيا في إدارة القطاع. هذا التحول في موقف حماس يمثل انتقالامن منطق المواجهة الوجودية إلى منطق التعايش المشروط، وهو انتقال فرضته الوقائع لا الاختيار الحر.
تقوم الخطة على ثلاث ركائز مترابطة: التهدئة الدائمة، والإعمار الاقتصادي، والضمانات الأمنية الإقليمية والدولية.
في البعد الإنساني، تنص الخطة على إنشاء “آلية إعادة إعمار غزة” بإدارة مشتركة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي ودول مانحة عربية وغربية، تتولى الإشراف على تدفق المساعدات، وإعادة بناء المساكن والبنى التحتية، وإعادة تشغيل المؤسسات الخدمية.
في البعد الاقتصادي، تُطرح رؤية لتكامل اقتصادي بين غزة وجوارها الإقليمي عبر مشاريع طاقة وموانئ واتصالات، تتيح فرص عمل وتخفف من الاعتماد على المساعدات.
أما البعد الأمني، فيقوم على ترتيبات مراقبة مشتركة تضمن وقف إطلاق النار، ومنع تهريب السلاح، وتحديد دور الأجهزة الأمنية في غزة ضمن إطار فلسطيني موحّد بإشراف دولي.
هذه العناصر لا تمثل حلولانهائية، لكنها تتيح فرصة أولى منذ سنوات لوقف الدمار المستمر وإعادة بناء الحد الأدنى من الحياة الإنسانية الطبيعية في القطاع.
يحتاج تحويل القبول السياسي بالخطة إلى مسار عملي إلى شبكة من التفاعلات الإقليمية والدولية المنسقة. فعلى الصعيد العربي، تملك دول الخليج موارد مالية واستثمارية تؤهلها لدعم مشاريع الإعمار الكبرى، بينما تمتلك الأردن وقطر خبرات تفاوضية وإدارية يمكن توظيفها في ترتيبات الأمن والإدارة المدنية.
أما على الصعيد الدولي، فالتنسيق بين واشنطن وبروكسل والأمم المتحدة هو الشرط الضروري لتوفير ضمانات مالية وسياسية ملزمة للطرفين.
وفي المحصلة، لا بد من قيام “تحالف إعادة إعمار” يربط المانحين بالدول الإقليمية الفاعلة والمؤسسات الدولية، بحيث لا تتحول المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي أو مجال للفساد الداخلي.
يُضاف إلى ذلك أن قبول حماس بالخطة، إن تم تثبيته فعليًا، يفتح الباب أمام إدماجها التدريجي في منظومة التفاعلات السياسية العربية والدولية، ويعيد تعريفها كفاعل سياسي يمكن التفاوض معه، لا كتنظيم معزول. وهذا التحول يحمل إمكانية تخفيف الضغوط الأمنية على غزة، ويُسهم في بناء مسار أكثر استقرارًا لإدارة العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين.
مع ذلك، فإن فرص النجاح ليست مضمونة. فقبول إسرائيل وحماس بالخطة لا يعني اتفاقهما على تفاصيل التنفيذ، ولا يضمن تخليهما عن حساباتهما الخاصة. داخل إسرائيل، قد تعرقل قوى اليمين المتطرف أي تنازل يُفسر على أنه اعتراف بكيان فلسطيني دائم، فيما قد تواجه حماس انقسامات داخلية بين جناح سياسي منفتح وآخر يرفض أي تسوية دائمة.
كما أن غياب الثقة بين الطرفين يهدد بتحويل ترتيبات الأمن والإعمار إلى ساحة تجاذب جديدة. ومن ناحية أخرى، ثمة خشية مشروعة من أن تتحول الخطة إلى مشروع اقتصادي ـ أمني يكرس الانقسام الفلسطيني بدل تجاوزه، إذا لم تُدمج مؤسسات السلطة الفلسطينية في مسار التنفيذ.
على الصعيد الدولي، يبقى التحدي الأكبر في ضمان استدامة التمويل والإشراف، إذ أثبتت التجارب السابقة أن تعب التعبئة الدولية يتراجع سريعًا بعد انتهاء الأزمات الحادة. كما أن استمرار بعض القوى الإقليمية في توظيف القضية الفلسطينية لأهدافها الخاصة قد يضعف الزخم الدبلوماسي المطلوب لتفعيل الخطة.
إن توظيف القبول بالخطة يجب أن ينطلق من الاعتراف بحدودها، ومن استثمار ما تتيحه دون المبالغة في التوقعات. فالمأساة الإنسانية في غزة لن تنتهي بين ليلة وضحاها، لكنها تحتاج إلى مسار متدرج يُعيد بناء الثقة بين الأطراف، ويعيد تعريف الأمن لا بوصفه حماية حدود فقط، بل ضمان الحق في الحياة والكرامة.
وهنا تكمن القيمة الواقعية للخطة: في قدرتها على فتح نافذة سياسية يمكن من خلالها إدخال البعد الإنساني والاقتصادي إلى صميم الحسابات الأمنية.
قبول إسرائيل وحماس بها ليس نهاية الصراع، بل بداية اختبار جديد: هل تستطيع الأطراف الإقليمية والدولية تحويل لحظة التوافق النادرة إلى مشروع مستدام يعيد للغزيين حقهم في الحياة، وللمنطقة استقرارها المفقود؟