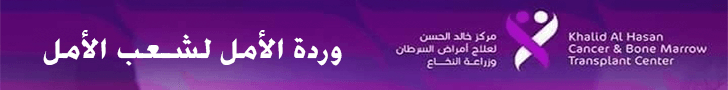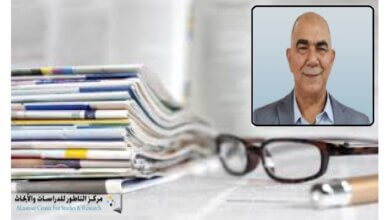د. صباح علي السليمان: جدلية اللفظ والمعنى في معيار العلم في فن المنطق للإمام الغزالي (ت 505هـ)

د. صباح علي السليمان 29-9-2025: جدلية اللفظ والمعنى في معيار العلم في فن المنطق للإمام الغزالي (ت 505هـ)
تعدُّ الفلسفة دائرة جدال قائمة بين العلوم ؛ لتأكيد الحجج ، واقناع العقول، وبيان الأدلة ، وعمق الأفكار للوصول إلى المعنى المراد . وكان اللفظ والمعنى متلازمين لبيان حقيقة هذه العلوم وحججها واستنباطتها ؛ فاللفظ والمعنى بؤرة الإشكالية والحل في كافة موضوعات المنطق ؛ لمخاطبة العقول الناشئة والمثقفة والمتفلسفة . و بهذا تم اختيار كتاب معيار العلم في فن المنطق للإمام الغزالي ليكون حاضراً في هذه الجدلية التي ما تزال تحتاج إلى فرضيات وأدلة للوصول إلى الحقيقة .
ومن موضوعات جدلية اللفظ والمعنى عند العزالي :
1-تقسيم اللفظ:
قال الغزالي : واللفظ ينقسم إلى جزئي وكلي، والجزئي ما يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة في مفهومه، كقولك زيد وهذا الشجر وهذا الفرس، فإنَّ المتصور من لفظ زيد شخص معين لا يشاركه غيره في كونه مفهوما من لفظ زيد. والكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه عن وقوع الشركة فيه، فإنْ امتنع امتنع ؛بسبب خارج عن نفس مفهومه ومقتضى لفظه، كقولك الإنسان والفرس والشجر وهي أسماء الأجناس والأنواع والمعاني الكلية العامة، وهو جار في لغة العرب في كل اسم أدخل عليه الألف واللام لا في معرض الحوالة على معلوم معين سابق، كالرجل فهو اسم جنس، فإنك قد تطلق وتريد به رجلا معينا عرفه المخاطب من قبل، فتقول: أقبل الرجل فتكون الألف واللام فيه للتعريف أي الرجل الذي جاءني من قبل. فإذا لم تكن مثل هذه القرينة، كان اسم الرجل اسما كليا يشترك في الإندراج تحته كل شخص من أشخاص الرجال. (معيار العلم في فن المنطق ص: 73)
2-تقسيم المركب:
قال الغزالي : المركب التام هو الذي كل لفظ منه يدل على معنى والمجموع بدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه، فيكون من إسمين ويكون من اسم وفعل. والمنطقي يسمى الفعل كلمة والمركب الناقص بخلافه.
فقولك: زيد يمشي والناطق حيوان؛ مركب تام، وقولك: في الدار أو انسان؛ مركب ناقص ؛لأنَّه مركب من اسم وأداة لا من إسمين ولا من اسم وفعل، فإنَّ مجرد قولك ” زيد في ” أو ” زيد لا ” لا يدل على المعنى الذي يراد الدلالة عليه في المحاورة ما لم يقل زيد في الدار أو زيد لا يظلم، فإنه بذلك الإقتران والتتميم يدل دلالة تامة بحيث يصح السكوت عليه. (معيار العلم في فن المنطق ص: 78)
3-المعنى في أقسام الكلام:
قال الغزالي : الفعل وهو الكلمة فإنّه صوت دال بتواطؤ على الوجه الذي ذكرناه في الاسم، إنما يباينه في أنه يدل على معنى وقوعه في زمان كقولنا قام ويقوم، وليس يكفي في كونه فعلا أنْ يدل على الزمان فحسب؛ فإنَّ قولنا أمس واليوم وغدا وعام أول ومضرب الناقة ومقدم الحاج يدل على الزمان، وليس بفعل، حيث أنَّ الفعل يدل على معنى وزمان يقع فيه المعنى فيكون الفعل أبدا دليلا على معنى محمول على غيره، فإذن الفرق بين الاسم والفعل تضمن معنى الزمان فقط .وأمّا الحرف وهو الأداة فهو كل ما يدل على معنى لا يمكن أن يفهم بنفسه ما لم يقدر اقتران غيره به، مثل من وعلى وما أشبه ذلك. وقد أوجز هذه الحدود فقيل في الاسم: إنه لفظ مفرد يدل على معنى من غير أنْ يدل على زمان وجود ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة، ثم منه ما هو محصل كزيد ومنه ما هو غير محصل، كما إذا اقترن به حرف سلب فقيل لا إنسان. والكلمة هي لفظة مفردة تدل على معنى وعلى الزمان الذي ذلك المعنى موجود فيه لموضوع ما غير معين، والحرف أو الأداة ما لا يدل على معنى باقترانه بغيره. (معيار العلم في فن المنطق ص: 80)
4-أثر المعنى في نسبة الألفاظ :
قال الغزالي : اعلم أنّ الألفاظ من المعاني على أربعة منازل: المشتركة والمتواطئة والمترادفة والمتزايلة.أما المشتركة فهي اللفظ الواحد الذي يطلق على موجودات مختلفة بالحد والحقيقة إطلاقا متساويا كالعين تطلق على العين الباصرة، وينبوع الماء وقرص الشمس وهذه مختلفة الحدود والحقائق.
وأما المتواطئة فهي التي تدل على أعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينها، كدلالة اسم الإنسان على زيد وعمرو، ودلالة اسم الحيوان على الإنسان والفرس والطير ؛لأنّها متشاركة في معنى الحيوانية والاسم بإزاء ذلك المعنى المشترك المتواطىء، بخلاف العين الباصرة وينبوع الماء وأما المترادفة: فهي الأسماء المختلفة الدالة على معنى يندرج تحت حد واحد كالخمر والراح والعقار؛ فإنّ المسمى بهذه يجمعه حد واحد وهو المائع المسكر المعتصر من العنب والأسامي مترادفة عليه.وأمّا المتزايلة: فهي الأسماء المتباينة التي ليس بينها شيء من هذه النسب كالفرس والذهب والثياب؛ فإنها ألفاظ مختلفة تدل على معان مختلفة بالحد والحقيقة، والمشترك ينبغي أنْ يجتنب استعماله في المخاطبات فضلا عن البراهين، وأما المتواطئة فتستعلم في الجميع لا سيما البراهين.. (معيار العلم في فن المنطق ص: 81)
5-أثر المعنى بين الاسم والوصف:
قال الغزالي : ولا يخفى أنَّ الموضوعات إذ تباينت مع تباين الحدود فالأسامي متباينة متزايلة كالفرس والحجر، ولكن قد يتحد الموضوع ويتعدد الاسم بحسب اختلاف اعتبارات، فيظن أنها مترادفة ولا تكون كذلك؛ فمن ذلك أنْ يكون أحد الاسمين له من حيث موضوعه، والآخر من حيث له وصفن كقولنا سيف وصارم؛ فإنَّ الصارم دل على موضوع موصوف بصفة الحدة بخلاف السيف، ومن ذلك أنْ يدل كل واحد على وصف للموضوع الواحد كالصارم والمهند، فإنْ هما يدل على حدته والآخر على نسبته، ومن ذلك أنْ يكون أحدهما بسبب وصف، والآخر بسبب وصف الوصف كالناطق والفصيح. ومن المتباينة المشتق والمنسوب مع المشتق منه والمنسوب إليه كالنحو والنحوي، والحديد والحداد، والمال والمتمول، والعدل والعادل، فإنَّ العادل لو سمي عدلا كما سميت العدالة عدلا كان ذلك من قبيل ما يقال باشتباه فاسم، ولكن غيرت الصيغة وبقيت المادة والمعنى الأول زيد فيه ما دل على زيادة المعنى فسمي مشتقا. (معيار العلم في فن المنطق ص:84- 85)
6-أثر المعنى في الإشارة:
قال الغزالي : وكذلك كون كل عدد إما مساو لغيره أو مفاوت فإنه لازم ليس بذاتي، وربما لا يقدر الإنسان على رفعه في الوهم، نعم من اللوازم ما يقدر على رفعه ككون المثلث مساوي الزوايا القائمتين فإنه لازم لا يعرف لزومه للمثلث بغير وسط بل بوسط، فلم يكن هذا مطردا فنعدل إلى المعيار الثاني عند العجز عن الأول ونقول: إنّ كل معنى إذا أحضرته في الذهن مع الشيء الذي شككت في أنه لازم له أو ذاتي، فإنْ لم يمكنك أنْ تفهم ذات الشيء إلا أنْ يكون قد فهمت له ذلك المعنى أولا، مساوية لقائمتين فهو كالحيوان وانسان فإنك إذا فهمت ما الإنسان وما الحيوان فلا تفهم الإنسان إلا وقد فهمت أولا أنه حيوان فاعلم أنه ذاتي. (معيار العلم في فن المنطق96)
7-أثر المعنى في اللازم والعارض:
قال الغزالي : إنك إذا فهمت ما الإنسان وما الحيوان فلا تفهم الإنسان إلا وقد فهمت أولا أنه حيوان فاعلم أنه ذاتي. وإنْ أمكنك أنْ تفهم ذات الشيء دون أنْ تفهم المعنى أو أمكنك الغفلة عن المعنى بالتقدير، فاعلم أنه غير ذاتي. ثُمَّ إنْ كان يرتفع وجوده إما سريعا كالقيام والقعود للإنسان أو بطيئا شابا فاعلم أنه عرضي مفارق، وإنْ كان لا يفارقه أصلا ككون الزوايا من المثلث لازم، ورب لازم للشخص كأزرق العين أو أسود البشرة في الزنجي، فهو لا يفارق في الوجود للإنسان الزنجي فهو بالإضافة إلى ذلك الشخص لا يبعد أنْ يسمى لازما، وإنْ كان لزومه بالإتفاق لا بالضرورة في الجنس إذ يمكن وجود إنسان ليس كذلك، ولو أمكنت حيلة في إزالة زرقة العين وسواد البشرة لبقي هذا الإنسان إنسانا، ولو قدرت حيلة لإخراج زوايا المثلث عن كونها مساوية لقائمتين لم يبق المثلث وبطل وجوده، فلتدرك هذه الدقيقة في الفرق بين اللازم الضروري وبين اللازم الوجودي. معيار العلم في فن المنطق (ص: 97 -98)
8-أثر المعنى في الحكم:
قال الغزالي : فإن قيل: فهل يمكن إثبات كون المعنى الجامع علة للحكم بأنْ نرى أنَّ الحكم أجزاء العلة وشروطها، ولا يوجد بوجود ذلك البعض، فمهما ارتفع الحياة ارتفع الإنسان ومهما وجدت لم يلزم وجود الإنسان، بل ربما يوجد الفرس أو غيره ولكن الأمر بالضد من هذا، وهو أنه مهما وجد الحكم دل على وجود المعنى الجامع، فإما أنْ يدل وجود المعنى على وجود الحكم بمجرد كون الحكم مرتفعا بارتفاعه فلا، فمهما وجد الإنسان فقد وجدت الحياة، ومهما وجدت صحة الصلاة فقد وجد الشرط وهو الطهارة، ومهما وجدت الطهارة لم يلزم وجود الصلاة. (معيار العلم في فن المنطق ص: 168)
9-أثر المعنى في الاتحاد والمفارقة:
قال الغزالي : أنْ يكون المعنى الجامع أمرا معينا متحدا، وما فيه الإفتراق أيضا أمرا معينا أو أمورا معينة، ولم يكن للجامع مناسبة وتأثير، إلا أنه إنْ كان الجامع موهما أنَّ المعنى المصلحي – الخفي، الملحوظ بعين الإعتبار من جهة الشرع، مودع في طيه، وإنطواؤه على ذلك المعنى، الذي هو المقتضي للحكم عند الله، أغلب من احتواء المعنى الذي فيه المفارقة، كان الحكم بالاشتراك لذلك أولى من الحكم بالافتراق. (معيار العلم في فن المنطق ص: 173)
10-الاقتصار على المعنى :
قال الغزالي : اعلم أنَّ الألفاظ القياسية المستعملة في المخاطبات والتعليمات، وفي الكتب والتصنيفات، لا تكون ملخصة في غالب الأمر على الوجه الذي فصلناه، بل تكون مائلة عنه إما بنقصان، وإما بزيادة، وإما بتركيب وخلط جنس بجنس، فلا ينبغي أنْ يلتبس عليك الأمر، فتظن أن المائل عما ذكرناه ليس بقياس، بل ينبغي أن يكون عين عقلك مقصورة على المعنى، وموجهة إليه لا إلى الأشكال اللفظية، فكل قول أمكن أن يحصل مقصوده، ويرد إلى ما ذكرناه من القياس، فقوته قوة قياس، وهو حجة، وإنْ لم يكن تأليفه ما قدمناه، إلا أنه إذا تؤمل وامتحن لمتحصل منه نتيجة، فليس بحجة.
أما المائل للنقصان فهو أنْ نترك إحدى المقدمتين أو النتيجة. أما ترك المقدمة الكبرى فمثاله قولك: هذان متساويان لأنهما قد ساويا شيئا واحدا، فقد ذكرت المقدمة الصغرى والنتيجة، وتركت الكبرى وهي قولك: والأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، وبه تمام القياس، ولكن قد تتركب لوضوحها، وعلى هذا أكثر الأقيسة في الكتب والمخاطبات. (معيار العلم في فن المنطق ص: 177-178)
11-أثر المعنى في العمد
قال الغزالي : أما من حيث المعنى فمنها ما يحصل من تخيل العكس، فإنا إذا قلنا: كل قود فسببه عمد، فيظن أنَّ كل عمد فهو سبب قود، فإن العمد رؤى ملازما للقود فظن أنَّ القود أيضا ملازم للعمد، وهذا الجنس سباق إلى الفهم، ولا يزال الإنسان مع عدم التنبه لأصله ينخدع به ويسبق إلى تخيله من حيث لا يدري إلى أنْ ينبه عليه. ومنها ما سببه تنزيل لازم الشيء منزلة الشيء حتى إذا حكم على شيء بحكم ظن أنه يصح على لازمه، فإذا قيل: الصلاة طاعة وكل صلاة تفتقر إلى نية، ظن أنَّ كل طاعة تفتقر إلى نية من حيث ان الطاعة لازمة للصلاة وليس كذلك، فإنَّ أصل الإيمان ومعرفة الله تعالى طاعة، ويستحيل إفتقارها إلى نية ؛لأنّ نية التقرب إلى المعبود لا تتقدم على معرفة المعبود، وهذا أيضا كثير التغليط في العقليات والفقهيات، وأسباب الأغاليط مما يعسر إحصاؤها، وفيما ذكرناه تنبيه على ما لم نذكره. (معيار العلم في فن المنطق ص: 201)
12-عموم المعنى
قول الشافعي: إذا نهشته حية أو عقرباء فإن كانت من حيات مصر أو عقارب نصيبين وجب القصاص. وليس غرضه التخصيص بل كل ما يكون قاتلا في الغالب، ولكن ذكر المشهور وعبر به عن الكل، فإذا ورد من هذا الجنس لفظ خاص ألغينا خصوصه وأخذنا المعنى الكلي المراد به وقلنا: كل تبرم بالوالدين فهو حرام، وكل إتلاف لمال اليتامى حرام؛ فيحصل معنا مقدمة كلية. فإن قيل: فالمعلوم بواقعة مخصوصة هل هو قضية كلية يفتقر تخصيصها إلى دليل أم هو جزئية فيفتقر تعميمها إلى دليل، وذلك كقوله للأعرابي: (اعتق رقبة) لما قال جامعت في نهار رمضان، وكرجمه ماعزا لما زنى، فهل ينزل ذلك منزلة قوله: كل من زنى فارجموه وكل من جامع أهله في نهار رمضان فليعتق رقبة؟ قلنا: هو كقولك: كل موصوف بصفة ماعز إذا زنى فارجموه، ولك موصوف بصفة الأعرابي إذا هلك وأهلك بجماع أهله في نهار رمضان فليعتق رقبو. ثم صفة الجماع هو الذي وصفه السائل والمعتبر من صفات الأعرابي ما عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كانت السعادة في الدنيا والآخرة لا تنال إلا بالعلم والعمل، وكان يشتبه العلم الحقيقي بما لا حقيقة له، وافتقر بسببه إلى معيار فكذلك يشتبه العمل الصالح النافع في الآخرة بغيره، فيفتقر إلى ميزان تدرك به حقيته. (معيار العلم في فن المنطق ص: 205)
13-اقتصار اللفظ لا المعنى:
قال الغزالي : ونقول: لا دن واحد في شراب، ولا نقول: لا شراب واحد دن، فنقول: نحن ادعينا أنّ ذات المحمول مهما عكس على ذات الموضوع بعينه اقتضى ما ذكرناه لا دن واحد شراب فلا جرم يلزم بالضرورة إنه لا شراب واحد دن؛لأنّ المباينة إذا وقعت فلا جرم يلزم بالضرورة إنه لا شراب واحد دن، لأن المباينة وقعت بين شيئين كلية كانت من الجانبين، إذ لو فرض الإتصال في البعض كذبت كون المباينة كلية، وهذا المثال لم يعكس على وجهه ولم يحصل المعنيات اللذان المباينة بينهما، فإذا حصل لزم العكس، فإنا إذا قلنا: لا حائط واحد في الوتد، فالمحمول قولنا في الوتد لامجرد الوتد، فإذا وقعت المباينة بين الحائط وبين الشيء الذي قدرناه في الوتد فعكسه لازم، وهو أن كل ما هو في الوتد فليس بحائط، فلا جرم نقول: لا شيء واحد مما هو في الوتد حائط ولا شيء واحد مما هو في الشراب دن، وحل هذا إنما يعسر على من يتلقى هذه الأمور من اللفظ لا من المعنى. وأكثر الأذهان يعسر عليها درك مجردات المعاني من غير التفات إلى الألفاظ. (معيار العلم في فن المنطق ص: 220)
14-تخيّل المعنى:
قال الغزالي : بالإضافة إلى رأس الآدمي ورجله حتى لو لم يكن آدمي لم يكن أسفل ولا أعلى ولو انتكس آدمي لصار جهة الأسفل أعلى وهو محال، وإما أنْ يكون الأسفل هو أبعد المواضع عن الفلك المحيط وهو المركز، والأعلى هو أقرب المواضع إلى المحيط، فإن صح هذا فالأرض إذا كانت في المركز فهي في أسفل سافلين، فلا يتصور أنْ تنتقل ؛لأنّ أسفل سافلين غاية البعد عن المحيط وهو المركز، ومهما جاوزت المركز في أي جانب كان، فارقت الأسفل إلى جهة الأعلى، فإنْ كان المعنى بالأسفل هذا فما ذكروه ليس بمحال، وأن كان المعنى بالأعلى والأسفل ما يحاذي جهة رأسنا وقدمنا فما ذكروه محال فتأمل جدا حد الأسفل حتى يتبين لك أحد الأمرين، وإنما تعرف ذلك بالنظر في حقيقة الجهة وأنها بما تتحد أطرافها المتقابلة، ولا يمكن شرحه في هذا الكتاب. فإذن هذه الأغاليط نشأت من تسليم مقدمات ليست واجبة التسليم، ومثاراتها قد جرى التنبيه عليها، فليقس بما ذكرناه ما لم نذكره. معيار العلم في فن المنطق (ص: 229)
15-تصور المعنى
قال الغزالي : وأما العقلي الكلي وعقل الكل والنفس الكلي ونفس الكل، فبيانه أنَّ الموجودات عندهم ثلاثة أقسام: أجسام وهي أخسها، وعقول فعالة وهي أشرفها لبراءتها عن المادة وعلاقة المادة، حتى أنها لا تحرك المواد أيضا غلا بالشوق، وأوسطها النفوس وهي التي تنفعل من العقل وتفعل في الأجسام، وهي واسطة، ويعنون بالملائكة السماوية نفوس الأفلاك فإنها حية عندهم وبالملائكة المقربين العقول الفعالة. والعقل الكلي يعنون به المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين بالعدد من العقول التي لإشخاص الناس، ولا وجود لها في القوام بل في التصور، فإنك إذا قلت الإنسان الكلي أشرت به إلى المعنى المعقول من الإنسان الموجود في سائر الأشخاص، الذي هو للعقل صورة واحدة تطابق سائر أشخاص الناس، ولا وجود لإنسانية واحدة هي إنسانية زيد، وهي بعينها إنسانية عمرو، ولكن في العقل تحصل صورة الإنسان من شخص زيد مثلا، ويطابق سائر أشخاص الناس كلهم فيسمى ذلك الإنسانية الكلية ،وأما عقل الكل فيطلق على معنيين: أحدهما وهو الأوفق للفظ أن يراد بالكل جملة العالم، فعقل الكل على هذا المعنى بمعنى شرح اسمه أنه جملة الذوات المجردة عن المادة، من جميع الجهات التي لا تتحرك لا بالذات ولا بالعرض، ولا تحرك إلا بالشوق، وآخر رتبة هذه الجملة هي العقل الفعال المخرج للنفس الإنسانية في العلوم العقلية من القوة إلى الفعل، وهذه الجملة هي مبادي الكل بعد المبدأ الأول. والمبدأ الأول هو مبدع الكل، وأما الكل بالمعنى الثاني فهو الجرم الأقصى، أعني الفلك التاسع الذي يدور في اليوم والليلة مرة فيتحرك كل ما هو حشوه من السموات كلها، فيقال لجرمه جرم الكل، ولحركته حركة الكل، وهو أعظم المخلوقات، وهو المراد بالعرش عندهم.
فعقل الكل بهذا المعنى هو جوهر يجرد عن المادة من كل الجهات، وهو المحرك لحركة الكل على سبيل التشويق لنفسه ووجوده أول وجود مستفاد عن الأول، ويزعمون أنه المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: ” أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فاقبل ” الحديث إلى آخره. وأما النفس الكلي فالمراد به المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين في العدد، في جواب ما هو التي كل واحدة منها نفس خاصة لشخص، كما ذكرنا في العقل الكلي. معيار العلم في فن المنطق (ص: 291-292)
16-المعنى الافتراضي:
قال الغزالي : وهو المعنى الذي وجوده بالقياس إلى شيء آخر ليس له وجود غيره البتة، كالأبوة بالقياس إلى البنوة لا كالأب، فإنّ له وجودا يخصه كالإنسانية مثلا، وتميز هذا المعنى عن الكيف والكم لا خفاء به فهذا أصله. وأما أقسامه فإنه ينقسم بحسب سائر المقولات التي تعرض فيها الإضافة، فإنها تعرض للجواهر والأعراض، فإن عرضت للجوهر حدث منه الأب والإبن والمولى والعبد ونظيرها، وإنْ عرضت في الكم حدث منه الصغير والكبير والقليل والكثير والنصف والضعف ونظيره، وإن عرضت في الكيفية كانت منه الملكة والحال والحس والمحسوس والعلم والمعلوم، وإن عرضت في الأين ظهر منه فوق وأسفل وقدام وتحت ويمين وشمال، وإذا عرضت في المتى حصل منه السريع والبطيء والمتقدم والمتأخر، وكذلك باقي المقولات. (معيار العلم في فن المنطق ص: 320)
17-أهمية المعنى في الوجود والعدم:
قال الغزالي : والحاصل أنَّ كل ممكن بذاته فهو واجب بغيره، فالممكن أنْ اعتبرت علته وقدر وجودها كان واجب الوجود، وإن قدر عدم علته كان ممتنع الوجود، وإن لم يلتفت إلى علته لا باعتبار العدم ولا باعتبار الوجود كان له في ذاته المعنى الثالث، وهو الإمكان، فإذن كل ممكن فهو ممتنع وواجب أي ممتنع عند تقدير عدم العلة، فيكون ممتنعا بغيره لا لذاته أو ممكنا من حيث ذاته إذا لم تعتبر معه علته نفيا وإثباتا، وليس الجمع بين هذه الأمور متناقضا، بل نزيد عيه فنقول: الممتنع أيضا منقسم إلى ممتنع لذاته وإلى ممتنع لغيره، فإجتماع السواد والبياض ممتنع لذاته، وكون السلب والإثبات في شيء واحد صادقا ممتنعا لذاته، وفرض القيامة اليوم، وقد علم الله تعالى أنه لا يقيمها اليوم مستحيل، ولكن لا لذاته كاستحالة الجمع بين البياض والسواد، ولكن لسبق علم الله بأنه لا يكون وإستحالة كون العلم جهلا، فكان امتناعه لغيره لا لذاته. معيار العلم في فن المنطق (ص: 346)
المصادر
المصدر :معيار العلم في فن المنطق لأبي حامد الغزالي(ت: 505هـ) ، تأليف أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، تح : الدكتور سليمان دنيا ، د.ط ، دار المعارف، مصر ، 1961 م.
نبذة عن حياة الإمام أبو حامد الغزالي وسيرته العلمية / نهضة الشريفي (مقال )