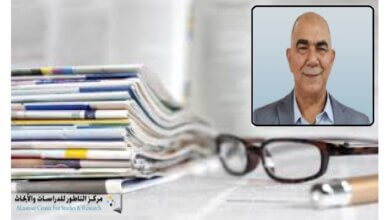أحمد دخيل: أطفال شاتيلا: حين تتحوّل الذاكرة إلى جرحٍ وراثي

أحمد دخيل 20-9-2025: أطفال شاتيلا: حين تتحوّل الذاكرة إلى جرحٍ وراثي
قلّبت اليوتيوب ليلة الأمس، باحثًا عن الأخبار، فاقترح عليّ مشكورا فيلم أطفال شاتيلا، قد يكون الاقتراح متربطًا بذكرى المجزرة الشهيرة صبرا وشاتيلا، التي حدثت قبل ثلاثة و أربعين عامًا.
من يشاهد فيلم مي مصري “أطفال شاتيلا” (1998)، يخرج بانطباع مزدوج: أنك أمام عمل وثائقي، وأمام مرثية شخصية في آنٍ واحد. ليس سهلًا أن تُمسك الكاميرا ندبةً وتتركها تنزف أمامنا، لكن هذا بالضبط ما فعلته مصري وهي تعيدنا إلى المخيم بعد ستة عشر عامًا من المجزرة.
الفيلم لا يلهث وراء صور الدم، ولا يفرّ من فخّ الاستعطاف.
إنّه يبني لغته على النقيض: صمت طويل، لقطة مقرّبة، عين تتهرّب من المواجهة، صوت يتردّد قبل أن يكتمل. هذه التفاصيل الصغيرة تُنشئ أثرًا أكبر من أي خطاب سياسي مباشر.
حين ينكسر الكلام، تدرك أنّ الذاكرة أقوى من اللغة.
ما يجعل الفيلم مختلفًا هو أنه لا يعرض الضحية كشخصية مسطّحة. لكل ناجٍ حكايته: من فقد أمّه، من حمل صورة الجثث كذكرى أولى في طفولته، من لم يفهم الصراخ إلا بعدما شبّ. لا يوجد “شاهد نموذجي”، بل فسيفساء من التجارب الفردية التي تشكّل، مجتمعة، لوحةً لجرح جماعي.
غير أنّ السؤال الذي يطلّ فجأة من بين المشاهد هو: لماذا الآن؟ والجواب الذي يقترحه الفيلم أعمق من مجرد استعادة للتاريخ. الناجون صاروا شبابًا ثم آباءً، والصدمة لم تتوقف عند حدودهم. كأنّها دمٌ عاطفي ينتقل في الأسرة، فيصحو الابن على خوفٍ لم يعشه، أو يحمل غضبًا لا يعرف مصدره. هنا يتجاوز الوثائقي كونه شهادة عن الماضي، ليصير بحثًا في انتقال الرعب كإرث غير معلن.
على المستوى الجمالي، تعاملت مصري مع الكاميرا كرفيق أكثر منها كأداة مراقبة. لم تكن العين محايدة، ولا متطفلة، بل أقرب إلى شخص يجلس أمام الناجي، ينتظر منه أن ينهار أو يسكت. هذه الحميمية هي ما يرفع الفيلم من مجرد مادة تسجيلية إلى تجربة مواجهة.
أخيرًا، يبدو “أطفال شاتيلا” أكثر من فيلم عن 1982.
إنه تحذير عن حاضرٍ مهدّد بأن يبقى أسيرًا لذاك الماضي. بل يمكن قراءته اليوم كتمهيد لذاكرة أخرى تتكوّن في غزة: أطفال سيكبرون ليصيروا شهودًا على مذبحة لم يختاروها.
وكما لم يتوقف جرح صبرا وشاتيلا عند لحظته، لن يتوقف جرح غزة عند شاشات الأخبار.