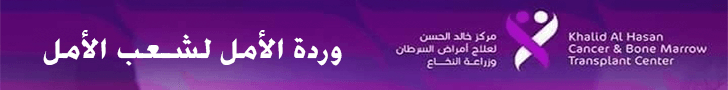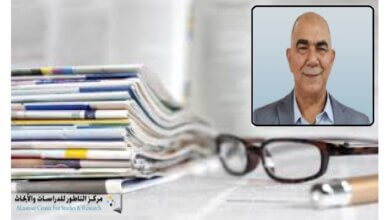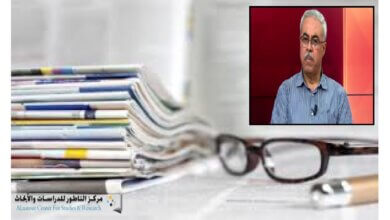المجلة: 7 أكتوبر 2023… كيف غيّر الشرق الأوسط؟
قبل عامين، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقعت هجمات “حماس” على غلاف غزة، فأحدثت زلزالا سياسيا وأمنيا لا تزال ارتداداته تضرب المنطقة. لم يكن ممكنا أن تمر الذكرى الثانية من دون التوقف عندها، لأنها لم تكن مجرد مواجهة بين “حماس” وإسرائيل، بل لحظة مفصلية دشّنت مرحلة جديدة في المنطقة.
إبراهيم حميدي: الشرق الأوسط بعد “7 أكتوبر”… خريطة جديدة وخاسر أكبر
منذ ذلك اليوم، توالت الأحداث بوتيرة غير مسبوقة. الحروب لم تتوقف. المبادرات الدبلوماسية لم تجف. بعضها نجح وبعضها الآخر بقي حبيس الأمنيات. والخرائط لم تستقر. لكن الأكيد أن “محور إيران” خرج من هذه المرحلة أضعف بكثير مما كان يتصوّر. الضربات الإسرائيلية تلاحقت، من الضاحية الجنوبية لبيروت إلى دمشق وبغداد وصنعاء وصولا إلى طهران. مواقع ومستودعات دُمّرت، قادة بارزون قُتلوا، وحلفاء طهران وجدوا أنفسهم في مواجهات مكلفة وطويلة. في العراق، تراجع “الحشد” إلى موقع دفاعي. في لبنان، انخرط “حزب الله” في حرب استنزاف في الجنوب ارتدت عليه في بيروت. في اليمن، حُوصر “الحوثيون” بين ضربات عسكرية وضغوط سياسية.
لكن الضربة الأقسى لطهران، كانت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول حين طُرد الرئيس بشار الأسد من الحكم في دمشق. الأسد لم يكن مجرد “حليف” لإيران، بل حجر الزاوية في تمددها غربا، وممرها الاستراتيجي إلى لبنان والبحر المتوسط. سقوطه مثّل هزة استراتيجية لـ”المرشد”، لأنه حرم طهران من أهم منصة لنفوذها وأحد أبرز حلفائها الذين صمدوا معها خلال العقود الماضية. بذلك خسر “محور الممانعة” ركيزة مركزية، ما جعلها أكثر عزلة وأضعف حضورا في معادلة الإقليم.
إيران هي الخاسر الأكبر. هذا لا يعني أن المحور انهار كليا، لكنه فقد زخمه. كلفته ارتفعت، قدرته على المبادرة تراجعت، وصورته كقوة صاعدة تآكلت. وأوضح تعبير عن ذلك، كان عجز “الوكلاء” و”الحلفاء” في الدفاع عن إيران وبرنامجها النووي ضد الضربات الإسرائيلية والأميركية في منتصف العام. حتى في الداخل، ارتفع النقاش حول جدوى المغامرات الخارجية في وقت يواجه فيه الاقتصاد تحديات عميقة والشارع الإيراني ضغوطا متزايدة.
في المقابل، أعادت إسرائيل التموضع بسرعة. صحيح أنها تعرضت في السابع من أكتوبر لصدمة وجودية، وصحيح أن صورتها الأمنية تضررت وبدا وكأن “محور” إيران وجه ضربة كبيرة. لكنها فرضت نفسها خلال عامين لاعبا أساسيا. صعّدت عملياتها ضد امتدادات إيران، وعززت تعاونها مع شركاء يرون في التنسيق معها ضمانة لأمنهم أو فرصة للانفتاح على التكنولوجيا والتحديث. وعلى الرغم من خلافاتها المتكررة مع واشنطن، حافظت على المظلة الأميركية التي عززتها عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما باتت حاضرة أكثر في الحسابات الأوروبية والآسيوية.
لكن الداخل لم يكن مستقرا. بنيامين نتنياهو، الذي يُلقب بـ”السياسي الأطول عمرا” في إسرائيل ويسعى لرسم خريطة جديدة في الشرق الأوسط، يواجه قضايا فساد وضغوطا متصاعدة من المعارضة، إضافة إلى انقسام اجتماعي حاد. صورته في الداخل اهتزت، وإن حاول تصدير صورة القائد القوي في الخارج. علاقة نتنياهو الملتبسة مع ترمب زادت المشهد تعقيدا، فهو يستند إلى إرث ولايته الأولى و”الاتفاقات الإبراهيمية”، لكنه كان يدرك أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض حملت فرصا وتحديات في آن. آخرها، إعلان ترمب بوجوده ومن البيت الأبيض، خطة لوقف الحرب المجنونة التي يدفع المدنيون ثمنها منذ سنتين نزوحا وقتلا وتجويعا، أعادت خلط الأوراق وأظهرت كيف أن مستقبل القطاع بات ورقة تفاوضية في التنافس بين القوى الكبرى والفاعلين، وليس فقط بين “حماس” وإسرائيل.
ومن بارقات الأمل، كان نجاح المبادرة السعودية-الفرنسية في عقد قمة دولية لـ”حل الدولتين” على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، حصدت اعترافات كبيرة من دول بينها فرنسا وبريطانيا وكندا بـ”الدولة الفلسطينية”.
اليوم، بعد سنتين، يمكن القول إن الشرق الأوسط لم يعد كما كان. المفارقة أن الحرب لم تعد شأنا فلسطينيا–إسرائيليا صرفا. غزة تحولت إلى ساحة اختبار لصراعات أوسع: بين إيران وإسرائيل، بين قوى إقليمية ساعية لترسيخ نفوذها، وقوى كبرى تعيد ترتيب أولوياتها في عالم مأزوم من أوكرانيا إلى شرق آسيا.
السؤال اليوم لم يعد حول غزة فقط، بل من يملك الكلمة العليا في الشرق الأوسط الجديد. المنطقة كلها تقف على مفترق طرق سيحدد شكلها لعقد مقبل على الأقل.
اختيارنا هذا الملف لا يهدف إلى استعادة حدث مضى فحسب، بل إلى قراءة حاضر متحرك ومستقبل مفتوح على احتمالات كثيرة.
بول سالم: عامان على “7 أكتوبر”… الشرق الأوسط بين الفوضى والانتقال
مع اقتراب الذكرى الثانية للصراع الإقليمي الواسع الذي اندلع عقب هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تبرز الحاجة إلى تقييم الكيفية التي غيّر بها تعدد الأزمات وجه الشرق الأوسط، واحتمالات تطور مساراته خلال الأشهر المقبلة.
انطلق الصراع بمواجهة بين إسرائيل وحركة “حماس” في غزة، ثم ما لبث أن تحوّل إلى لحظة مفصلية أعادت رسم موازين القوى في المنطقة، ودفعت الأطراف الفاعلة الأساسية، وهي إسرائيل وإيران وتركيا ودول الخليج والولايات المتحدة، إلى اتخاذ قرارات استراتيجية من شأنها أن تحدد ما إذا كان الشرق الأوسط مقبلا على عهد جديد من التكامل والاستقرار أو في طريقه إلى مزيد من الصراع والتفكك.
تُطرح في هذه المرحلة الحاسمة أسئلة كبرى ترسم ملامح النظام الإقليمي الجديد. هل ستتمكن إسرائيل من استثمار تفوقها العسكري غير المسبوق من خلال دفع عجلة التطبيع والتكامل الإقليمي والتسوية السياسية مع جيرانها؟ وهل تعيد إيران النظر في نهج التدخل المباشر وتبحث عن مقاربة أمنية ودبلوماسية أكثر استقرارا؟ وهل تنجح الولايات المتحدة ودول الخليج في تسخير نفوذهما لإرساء الاستقرار بدلا من الاكتفاء برد الفعل؟ وهل يمكن أن تتحوّل الفرص المحدودة في إعادة بناء الدولة في كل من لبنان وسوريا إلى عوامل نهوض إقليمي، أم إنها ستتبدد في خضم موجة جديدة من التصعيد الإقليمي؟
الرابحون والخاسرون
برزت إسرائيل بوضوح بصفتها القوة العسكرية الإقليمية الأولى. فقد شكّلت عملياتها مسار الأحداث ليس فقط في غزة، بل كذلك في لبنان وسوريا واليمن وداخل الأراضي الإيرانية. وأظهرت قدرتها على استهداف المنشآت الإيرانية دون خشية من عواقب انهيار فرضيات الردع السابقة، ما أعاد تشكيل التوازن العسكري في المنطقة.
وعلى النقيض، ظهرت إيران بوصفها الخاسر الأكبر. إذ تفكك “محور المقاومة” الذي طالما افتخرت به طهران، والذي حافظ على توازن هش مع إسرائيل طوال سنوات. مما اضطر إيران إلى الانسحاب من سوريا، وتراجع نفوذ “حزب الله” بشكل لافت في لبنان، فيما بدت طهران غير قادرة حتى على منع الهجمات المباشرة التي طالت أراضيها.
في المقابل، واصلت تركيا تعزيز نفوذها بهدوء. فقد شكّل صعود أحمد الشرع، الذي حظي بدعم تركي ووصل إلى رئاسة سوريا، مصدر نفوذ جديد لأنقرة في دمشق، وأعاد لها جزءا من حضورها الإقليمي. أما دول الخليج، فقد نجحت حتى وقت قريب في تجنّب الدخول في مواجهة مباشرة، إلا أن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قطر الأسبوع الماضي وضعتها في صلب التوتر، وقد تدفعها إلى التورط في عمق الصراع.
انهار النظام الإقليمي الذي ساد لعقود، والمبني على توازن القوى بين إسرائيل من جهة، وإيران وشبكة حلفائها من جهة أخرى. غير أن نظاما جديدا لم يولد بعد.
منظور القوة الإسرائيلي
من موقعها الجديد بصفتها القوة المهيمنة، بات لإسرائيل الدور الأكبر في رسم ملامح النظام الإقليمي المقبل. إذ بإمكانها استثمار مكاسبها الميدانية كنقطة انطلاق نحو إطار أمني إقليمي يكرّس اندماجها الدائم في الشرق الأوسط. ويقتضي ذلك إنهاء الحرب في غزة، وتسريع وتيرة التطبيع مع السعودية، وتقديم أفق سياسي موثوق للفلسطينيين، إضافة إلى فتح باب المصالحة مع سوريا ولبنان ودول عربية وإسلامية أخرى.
غير أن المسار الذي ينتهجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاليا يبدو بعيدا عن هذا التوجه. فقد دخلت الحرب في غزة عامها الثالث، بعدما سعى نتنياهو إلى إفشال المبادرات الدبلوماسية لإنهائها من خلال استهداف فريق التفاوض التابع لحركة “حماس” في الدوحة. ويبدو أن الهجوم على قطر هو ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى العودة بقوة إلى المشهد، حيث أطلق خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، متعهدا في الوقت ذاته بتقديم ضمانة أمنية لقطر، ومؤكدا بوضوح: “لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.”
قد تُمنى خطة ترمب بالفشل في نهاية المطاف، إذ ما تزال حركة “حماس” تتفاوض بشأن بعض تفاصيل الاتفاق، غير أنه إذا كُتب للخطة أن تمضي قدما، فسيكون ترمب قد أرغم إسرائيل على إنهاء الحرب، وتأجيل خطط ضم الضفة الغربية، وفتح الطريق أمام صفقة محتملة مع السعودية. أما في حال انهيار الخطة، فإن الحرب ستستمر في عامها الثالث، ما يعيد المنطقة إلى حالة التوتر التي سادت قبل أسابيع قليلة.
في الواقع، أشار الهجوم على قطر وتصاعد التوتر مع تركيا في مطلع سبتمبر/أيلول إلى احتمال اندلاع تصعيد إقليمي واسع. وحتى “الانتصارات” التي حققتها إسرائيل في لبنان وسوريا ما تزال ذات طابع عسكري غير محسوم. وبدلا من ترجمة نجاحها الميداني إلى هيكل أمني إقليمي جديد، يبدو أن نتنياهو، في ظل غياب ضغط أميركي فعّال، يخاطر بإبقاء إسرائيل والمنطقة في حلقة مفرغة من الصراع المفتوح دون أفق سياسي واضح.
الدور الإيراني
تواجه طهران لحظة حاسمة لإعادة النظر في حساباتها. فقد أثبتت استراتيجيتها، التي تعتمد على الدفع بالميليشيات إلى خطوط “الدفاع الأمامي” والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، فشلها الذريع. وتجد إيران نفسها اليوم من دون قدرة ردع فعّالة، مع حلفاء ضعفاء، ونفوذ آخذ في الانحسار.
ورغم هذا التراجع، لم تقدم طهران على أي مراجعة استراتيجية جذرية حتى الآن. حيث يواصل النظام الإيراني دعم وكلائه الذين نجوا من الضربات، ويظل متمسكا بموقفه السابق بشأن برنامجه النووي. ويشكّل هذا الجمود خطرا حقيقيا، إذ يفتح المجال أمام مزيد من التصعيد من جانب إسرائيل، ويعرّض إيران لمزيد من العزلة والضعف.
ومع ذلك، ثمة مسار بديل يمكن لإيران السير فيه؛ مسار يسهم في حماية حدودها واستعادة مكانتها في الإقليم. فالدبلوماسية مع جيرانها العرب ما تزال خيارا متاحا، ويمكنها أن تتخلى عن نهج الميليشيات وتسعى إلى تسويات تفاوضية للنزاعات المستمرة، بما في ذلك القضية الفلسطينية. كما يمكن لإيران أن تركز على بناء منفعة عامة إقليمية، عبر إنشاء أطر أمنية، وممرات اقتصادية، وشبكات لإمداد الطاقة، من شأنها أن تعزز أمن النظام ومصلحة الشعب، وتمنح طهران فرصة حقيقية للمساهمة في استقرار المنطقة.
دول الخليج ونفوذها المحدود
تميل دول الخليج إلى نظام إقليمي أكثر استقرارا وتكاملا، غير أنها تبقى لاعبا محدود التأثير في المعادلة العسكرية القائمة. ويُعد عرض السعودية للتطبيع مع إسرائيل الورقة الدبلوماسية الأقوى التي تملكها. وقد يكون لهذا العرض أثر تحويلي في العلاقات العربية-الإسرائيلية، إلا أنه لم ينجح حتى الآن في تغيير موقف الائتلاف اليميني المتشدد بقيادة نتنياهو. كما أن المبادرات الخليجية المتكررة لم تُفلح بعد في تعديل مواقف إيران الإقليمية.
دور واشنطن: بين رد الفعل والرؤية الاستراتيجية
يشترك الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي قطع شوطا في ولايته الثانية، مع دول الخليج في السعي لبناء نظام إقليمي مستقر ومتكامل، تكون فيه الولايات المتحدة الوسيط والمستفيد الرئيس. فبين انتخابه وتنصيبه، مارس ترمب ضغوطا كبيرة على نتنياهو للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. إلا أن واشنطن سرعان ما عادت إلى موقف رد الفعل، حيث اكتفت بالتعامل مع الأزمات التي تُدار في جزء كبير منها من خلال القرار الإسرائيلي.
غير أن الهجوم على قطر أعاد ترمب، كما ذُكر سابقا، إلى صدارة المشهد. فقد أكد أن أهدافه الطموحة تتضمن استكمال اتفاقات إبراهام مع السعودية وسوريا ولبنان، وإيجاد حل دائم للتحدي النووي الإيراني، وتسوية القضية الفلسطينية بما يُرضي السعودية ويضمن أمن إسرائيل في آن واحد. وإذا ما قُدّر لمبادرته الأخيرة أن تحقق ما أعلنه صراحة من طموحات، فقد تُشكّل هذه المبادرة المرحلة التالية في التعامل مع هذه الأزمة الإقليمية المتشابكة، بل وربما تُحدّد إرثه في السياسة الخارجية.
الساحات المحلية في حالة تغير مستمر
وعلى الرغم من أن رقعة الشطرنج الاستراتيجية ما تزال غير مستقرة، فالتطورات على الأرض في كل دولة على حدة تتغير بطرق قد تؤدي إلى تعزيز الاستقرار أو إشعال فتيل أزمات جديدة.
لبنان: عودة ظهور الدولة
يقدم لبنان إحدى القصص الواعدة في مجال نهضة الدولة. فبعد عقود من الشلل والانهيار، تعيد مؤسسات بيروت تثبيت أقدامها تدريجيا، وتتراخي قبضة “حزب الله”، فيما يتقلص نفوذ إيران بشكل حاد.
وبفضل الدعم الدولي القوي، يحظى لبنان بفرصة نادرة لاستعادة سيادته، وإصلاح نظامه المالي والمصرفي المتداعي، وإحياء نموذج التعددية والازدهار الذي جعله ذات يوم مركزا مشعا في الإقليم. ورغم أن مسيرة التعافي ما تزال هشة، لا سيما في ظل قدرة “حزب الله” على عرقلة التقدم، وتباطؤ إسرائيل في تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار، فإن الزخم العام يميل نحو تعزيز الدولة وترسيخ مؤسساتها.
سوريا: انتقال هش
في المقابل، تبدو المرحلة الانتقالية في سوريا ضبابية بالقدر ذاته. فقد تعهّد الرئيس أحمد الشرع ببناء دولة جامعة، تسعى إلى إعادة دمج سوريا في العالم العربي. غير أن رد حكومته العنيف على المعارضة في المنطقة الساحلية العلوية وفي السويداء أثار تساؤلات حول صدقية هذا التوجه. كما أن جمود المفاوضات مع “قوات سوريا الديمقراطية” التي يسيطر عليها الأكراد يعكس حالة انعدام الثقة بين المكونات السورية المختلفة.
مع ذلك، يواصل الرئيس الشرع الدفع برؤيته لإعادة بناء دولة سورية قابلة للحياة، تشمل جميع الأطياف وتسعى إلى استعادة مكانتها في الإقليم وعلى الساحة الدولية بعد عقود من العزلة والتصادم. ويحظى في هذا المسار بدعم إقليمي ودولي واسع. وكما في الحالة اللبنانية، فإن قيام دولة فاعلة واقتصاد مزدهر لا يلبي فقط تطلعات السوريين واحتياجاتهم العاجلة، بل يمكن أن يسهم أيضا في إرساء دعائم الاستقرار على مستوى المنطقة بأسرها.
نظام إقليمي جديد أم فوضى شاملة
بعد عامين على هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يقف الشرق الأوسط على مفترق طرق حاسم. فقد انهار النظام القديم، بينما لم يتبلور النظام الجديد بعد. تمتلك إسرائيل قوة عسكرية غير مسبوقة، فيما تجد إيران نفسها في موقع دفاعي، وتبحث دول الخليج والولايات المتحدة عن إطار للاستقرار، بينما تشهد الساحات المحلية، من بيروت إلى دمشق، موجات من الحراك والاضطراب.
ويُطرح في هذا السياق سؤال محوري: هل ستُوظَّف هذه التحولات في بناء هيكل إقليمي جديد قائم على الأمن والدبلوماسية والتكامل الاقتصادي؟ أم إن المنطقة ستنزلق نحو جولة جديدة من المواجهة، توسّع دائرة الحروب وتعمّق حالة عدم الاستقرار؟
إنها لحظة فارقة يمر بها الشرق الأوسط، تختزن في طياتها مزيجا من الخطر والفرص. ولا تزال الفرصة متاحة أمام الأطراف الفاعلة في الإقليم، ومعها الولايات المتحدة، لتحويل مسار الصراعات الراهنة نحو استقرار دائم وبناء نظام إقليمي قادر على تحقيق الرخاء للجميع. فإما أن يُحتضن هذا المسار، أو يستمر التخبط من أزمة إلى أخرى، حتى يُعيد الانفجار التالي رسم خريطة المنطقة من جديد.
وينبغي على صانعي السياسات أن يغتنموا هذه اللحظة بدل انتظار الصدمة المقبلة. إذ توجد فرصة حقيقية لصياغة استراتيجية إقليمية جريئة تربط بين مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، والتقدم نحو حل للقضية الإسرائيلية-الفلسطينية، والتطبيع العربي الإسرائيلي، والتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع إيران، إلى جانب إرساء إطار أمني واقتصادي أوسع. لكن النافذة آخذة في الانغلاق بسرعة، وثمن التقاعس سيكون باهظا، يُدفع من خلال مزيد من الأرواح المهدرة والسنوات المفقودة.
مايكل هوروفيتز: كيف غيّر “7 أكتوبر” إسرائيل في الداخل والخارج؟
لا يوم يُشبه السابع من أكتوبر/تشرين الأول في تاريخ إسرائيل، سوى البداية المشؤومة لحرب “يوم الغفران” المُفاجئة عام 1973. أعادتني مشاعر ذلك اليوم إلى محادثة دارت بيني وبين جنرال إسرائيلي سابق كان متمركزاً في سيناء بداية حرب عام 1973، حين استذكر المفاجأة الصاعقة مع تحليق الطائرات المصرية فوق سماء قاعدته العسكرية، وهرع الجنود من طاولاتهم لاستعادة زمام المبادرة. تلك الفوضى، وذلك الشعور الغامر بالهزيمة حتى قبل أن تبدأ المعركة.
يتقاسَم هذه المشاعر جيلان يفصلهما نصف قرن. فالناجون من هجمات السابع من أكتوبر، التي شهدت اقتحام الآلاف من مقاتلي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” للمستوطنات والبلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، يستعيدون ذاك الرعب نفسه. ذلك الانعدام الكامل للتوجيه الذي لم يُجدِ في تبديده سوى المبادرة الفردية. فمن طيارين حلّقوا دون أوامر، إلى جنود انضموا للقتال بلا زيّ رسمي، إلى جهاز أمني تحرّك بلا قيادة أو خطة موحدة. ويؤكد غالبية من عاشوا تلك الحوادث أن الأمر قد استغرق من الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية أسابيع، إن لم يكن أكثر، للخروج من دوامة الفوضى التي أعقبت تلك الهجمات.
على مستوى القيادة أيضا، لم يكن التردد والارتباك أقل وضوحا. فقد استغرق الأمر من إسرائيل ثلاثة أسابيع كاملة لشن عملية برية في غزة بعد هجمات السابع من أكتوبر. وكان مردُّ ذلك جزئيا إلى ضرورة تأمين الحدود ومنع أي هجمات إضافية قد تشنها “حماس”، لكنه لم يكن العامل الوحيد. فمن بين الأسباب الجوهرية للتأخير غياب خطة استجابة واضحة لهجوم بهذا الحجم، فضلا عن تردد واضح في أوساط النخبة الإسرائيلية العليا في خوض غمار غزو كامل لقطاع غزة. وعلى وجه الخصوص، أبدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترددا ملحوظا في منح الثقة للجيش بعد هجمات أكتوبر في مهمة غير مسبوقة كهذه. فخلال المناقشات الاستراتيجية على مر السنوات بشأن غزة، عارض كثير من المسؤولين أي عمليات برية كبرى خشية أن يُكلف التقدم العميق في القطاع إسرائيل خسائر فادحة في الأرواح (مئات، بل آلاف الجنود)، كما يهدد مشروعيتها الدولية في ضوء ما يتسم به القتال الحضري من فظاعة وحتمية وقوع خسائر بشرية كبيرة.
خلال آخر عملية برية رئيسة شُنت في غزة عام 2014، اتّبعت إسرائيل استراتيجية محدودة الأهداف، إذ ركز الجيش الإسرائيلي على نحو أساسي على تدمير “أنفاق الهجوم” (تلك الأنفاق العابرة للحدود والتي تمتد من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية). وقد تقدمت القوات الإسرائيلية حينها بضعة كيلومترات فقط داخل القطاع، متجنبة معظم المناطق المأهولة بالسكان. وعندما حاول الجيش التقدم بشكل أعمق، واجه مقاومة شرسة، كما حدث في كمين حي الشجاعية في مدينة غزة. استحضر نتنياهو تلك الدروس خلال المداولات الأخيرة، خاصة مع تزايد الوضوح حول ضرورة اعتماد منهجية مختلفة. وبناءً على ذلك، وافق رئيس الوزراء على خطة متدرجة تركّز في مرحلتها الأولى على شمال غزة قبل الانتقال إلى مناطق أخرى، عوضا عن شن غزو شامل وفوري. كما استندت الخطة إلى تحديثات في العقيدة العسكرية الإسرائيلية تركّز على استخدام القوة النارية الساحقة لتغطية التقدم البري. بيد أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مفارقة مأساوية: ففي البيئة الحضرية، غالبا ما تتحول المعادلة الأمنية إلى معادلة محصلتها صفر، إذ إن الحماية المفرطة لقوات أحد الطرفين تعني بالضرورة زيادة المخاطر على الطرف الآخر.
وكما هو الحال في الكثير من المنعطفات السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم تكن الاعتبارات السياسية بعيدة عن دائرة القرار. فخلال الأيام الأولى التي أعقبت هجمات السابع من أكتوبر، سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى تأمين قبول واسع لأي رد عسكري إضافي في غزة، من خلال إقامة حكومة وحدة وطنية. وجاء تشكيل حكومة الطوارئ في 11 أكتوبر 2023، والتي ضمت زعيم المعارضة بيني غانتس إلى “مجلس الحرب” إلى جانب نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ليعبّر عن خطورة المرحلة ويُتيح لنتنياهو استعادة الحد الأدنى من الشرعية بعد أحد أكثر الأيام كارثية في تاريخ إسرائيل. إن هذا التوافق السياسي غير المسبوق يعكس الإجماع على أن إسرائيل تواجه تحديا وجوديا يتطلب استجابة تتجاوز الانقسامات السياسية العادية.
تغيير “قواعد اللعبة”… من الاحتواء إلى التصفية
لقد حطم السابع من أكتوبر الافتراضات الاستراتيجية الإسرائيلية الراسخة بشأن الردع والاحتواء. ولأكثر من عقد، اتبعت إسرائيل ما أسماه المحللون استراتيجية “جزّ العشب”- وهي عمليات عسكرية دورية تهدف إلى إضعاف قدرات “حماس” مع تجنب تكاليف احتلال غزة بالكامل. استند هذا النهج إلى الاعتقاد بأن “حماس”، كجهة شبه حكومية تحكم غزة، ستتصرف بعقلانية ويمكن ردعها من خلال ضغط عسكري محدود.
أثبتت تعقيدات هجمات السابع من أكتوبر ووحشيتها بطلان هذا الافتراض على نحو جذري. فقد أمضت حركة “حماس” سنوات عديدة في التخطيط والإعداد لما أسماه قادتها “الحرب الأخيرة”، إذ استغلّت فترات الهدوء لبناء شبكة أنفاق معقدة، وتخزين ترسانات أسلحة ضخمة، والتخطيط لعملية استراتيجية تهدف إلى جرِّ إسرائيل إلى صراع طويل الأمد، في محاولة لإضفاء الطابع الدولي على القضية الفلسطينية.
تجاوز التحول الاستراتيجي الإسرائيلي نطاق غزة بكثير. فقد تخلت إسرائيل عن نهجها التقليدي القائم على التصعيد المدروس، وتبنّت ما يمكن تسميته “عقلية السابع من أكتوبر” التي أولت الأولوية للضربات الاستباقية، مستخدمة القوة العسكرية لإعادة تشكيل الديناميكيات الإقليمية بدلا من الاكتفاء بإدارتها. لقد مثّل هذا التحول قطيعة جذرية مع عقود من التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي الذي ارتكز على ما يُعرف بـ”المعركة بين الحروب”- وهي استراتيجية هدفت إلى إضعاف خصوم إسرائيل تدريجيا دون الدخول في مواجهات شاملة. وفي الأشهر التي أعقبت ذلك، ازداد وضوح هذا التحول الاستراتيجي، إذ تبنت إسرائيل موقفا أكثر عدوانية يهدف إلى تحقيق هزيمة حاسمة للخصوم وإنشاء “مناطق عازلة”.
تغييرات من الداخل
لقد شهد المشهد الداخلي الإسرائيلي تحولا جذريا تحت وطأة هجمات السابع من أكتوبر وتداعياتها. ورغم أن معظم التحديات التي تميز مرحلة ما بعد الهجمات كانت موجودة أصلا قبل حوادث أكتوبر، فإن هذه الهجمات قد عمقتها وأعطتها أبعادا جديدة. فقد مرت إسرائيل بفترة استقطاب سياسي حاد، في الوقت الذي كانت فيه حكومة نتنياهو تدفع بإصلاح قضائي مثير للجدل.
اعتبرت شرائح واسعة من الجمهور الإسرائيلي هذا الإصلاح تهديدا مباشرا للهوية الديمقراطية للبلاد، ومن شأنه أن يضعف السلطة الوحيدة التي تُوازن سلطة الحكومة التنفيذية. وقد عزز إصرار نتنياهو على التمسك بمنصبه، وسعيه إلى التملص من المسؤولية عن إخفاقات السابع من أكتوبر، الاعتقاد السائد بأن هدفه الأساسي هو حماية نفسه من المساءلة. في المقابل، صوّر نتنياهو هذه المعارضة كمحاولة غير ديمقراطية تقودها ما يُسمى “الدولة العميقة” في إسرائيل لاستعادة السيطرة على الشؤون العامة عبر التوسع القضائي المفرط.
تسبق هذه الأزمة المتعلقة بقواعد اللعبة الديمقراطية الأزمة الراهنة، وهي تعكس غياب دستور رسمي للبلاد. ولا شكَّ أن هذا الغموض الدستوري كان قائما قبل حوادث السابع من أكتوبر، لكن الأزمات التي أعقبت الهجوم أضفتْ شعورا غير مسبوق بالإلحاح، دفَعَ نحو ضرورة حل هذا التوتر التاريخي. وتظل إسرائيل واحدة من الدول القليلة في العالم التي تعيش منذ فترة طويلة على حافة أزمة دستورية مزمنة، في ظل غياب للدستور.
بالتأكيد، ستحدث الأشهر الطويلة من الاحتجاجات ضد الحكومة، والسعي الدؤوب لإبرام صفقة للإفراج عن الرهائن، تحولا جوهريا في بنية المعارضة الإسرائيلية. فقد خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع أسبوعيا، وبلغت بعض تلك المظاهرات أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ البلاد القصير. وإلى الوقت الحالي، قد تكون حركة الاحتجاج قد فشلت في ردع نتنياهو أو تغيير مسار الحرب على نحو مباشر، لكن من المؤكد أن إرثها سيستمر من خلال القادة الجدد الذين أبرزتهم وأطلقَتْهم إلى الواجهة.
كما أن الحركة الاحتجاجية المماثلة التي طالبت بـ”العدالة الاجتماعية” عام 2011، كانت قد جلبت بدورها دماءً جديدة إلى الساحة السياسية، على الرغم من فشلها في إحداث تغيير جذري حقيقي. لكن حجم الأزمة الحالية أكبر بكثير. وهناك قناعة متنامية بأن الديمقراطية الإسرائيلية لم تعد مضمونة ولا يمكن التعامل معها كأمر مُسَلَّم به، وأن الهوية المزدوجة لإسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية لن تصمد إلا إذا عبّرت الأغلبية الصامتة عن رأيها.
يُغذّي هذا الانقسام الاجتماعي العميق أيضا تصور مفاده أن الشريحة التي تهمشها الحكومة الإسرائيلية وتهملها أكثر هي نفسها التي تدفع ثمن قراراتها. لطالما كانت قضية التجنيد الإلزامي للتيار المتشدد (الحريديم) مصدرا للانقسام الحاد في المجتمع الإسرائيلي، لكنها وصلت حاليا إلى ذروة غير مسبوقة. وقد صدم إصرار التيار المتشدد على تمرير قانون جديد يكرّس عدم مساواتهم ويضمن حقهم في الإعفاء من الخدمة العسكرية، شرائح كبيرة من الشعب الإسرائيلي، من ضمنها بعض مؤيدي نتنياهو وائتلافه الحاكم.
لطالما اعتمدت الحوكمة في إسرائيل على ضرورة مراعاة مصالح الأقليات. فعمليا، أي ائتلاف حاكم في إسرائيل مُلزم بالتفاوض مع أحزاب صغيرة، غالبا ما تدفع بأجندات ضيقة وتهتم بمصالح فئوية محددة. وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت، فإن الأزمة التي أعقبت السابع من أكتوبر ربما أظهرت حدود النظام الذي يولي أولوية قصوى لمصالح “القبائل” المختلفة على حساب المصلحة الوطنية الجامعة.
حملة اغتيالات منهجية
شهد السابع من أكتوبر/تشرين الأول انطلاق حملة من أشد حملات الاغتيالات المستهدفة منهجية ونجاحا في تاريخ إسرائيل. وقد أدى اتساع نطاق هذه العمليات ودقتها، إلى تغير جذري في الهياكل القيادية لـ”حماس” و”حزب الله” وشبكة إيران الإقليمية، كاشفة بذلك عن مستوى من الاختراق الاستخباراتي والقدرة العملياتية فاجآ حتى أقرب حلفاء إسرائيل.
بدأت الحملة باستهداف ممنهج لقيادة “حماس”. فقتل محمد الضيف، القائد الغامض للجناح العسكري لـ”حماس” و”مهندس” هجمات 7 أكتوبر، في غارة جوية في 13 يوليو/تموز 2024 على خان يونس. وقتل إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ”حماس”، في إحدى دور الضيافة في قلب طهران. وقتل يحيى السنوار، الذي خلف هنية في قيادة “حماس”، في مواجهة وقعت صدفة مع القوات الإسرائيلية في رفح في أكتوبر 2024.
امتدت حملة الاغتيالات إلى ما هو أبعد من “حماس” بكثير. وقد تبين أن استهداف إسرائيل لقيادات “حزب الله” كان أشد تدميرا لشبكة إيران الإقليمية. كما أن هجمات سبتمبر/أيلول 2024 التي استهدفت أجهزة (البيجر)، الاستدعاء اللاسلكي، التي أسفرت عن مقتل العشرات وجرح الآلاف من عناصر “حزب الله”، كشفت عن قدرة إسرائيل على اختراق حتى أكثر المنظمات حرصا على أمنها. وتلا ذلك تصفية ممنهجة لكبار قادة “حزب الله”، بلغت ذروتها مع مقتل الأمين العام حسن نصرالله في سبتمبر.
أبرزت هذه الاغتيالات سياسة “الذراع الطويلة” التي تتبعها إسرائيل، أي قدرتها على الوصول إلى أي مكان يوجد فيه أعداؤها، سواء كانوا في أعماق الأرض أو بعيدا عن حدودها. ولعل خير دليل على ذلك محاولة إسرائيل في شهر سبتمبر/أيلول استهداف قادة لـ”حماس” أثناء اجتماع لهم في العاصمة القطرية الدوحة، ما يعد نقطة مفصلية للضغط على جميع الأطراف الإقليمية الفاعلة.
وعلى الرغم من أن الحملات نفسها نفذت ضد مجموعات مختلفة، فإنها أسفرت عن نتائج مختلفة. فالتصفية المنهجية لقادة “حزب الله” عبر سلسلة من الغارات الجوية، إلى جانب العملية البرية في جنوب لبنان، التي تدربت عليها إسرائيل منذ فترة طويلة، أثبتتا فعاليتهما الشديدة في إجبار “حزب الله” على التراجع عن موقفه الأولي، بأنه سيواصل قتال إسرائيل ما دامت إسرائيل تقاتل في غزة. وبلغ “حزب الله” أضعف حال له منذ تأسيسه، ففتح ذلك أمام الحكومة اللبنانية نافذة نادرة لاستعادة السيطرة على “احتكار العنف” الذي يميز أي دولة ذات سيادة.
أما في غزة، فلم تفضِ عمليات الاغتيال المستهدفة إلى أي اختراق حقيقي ولا إلى إطلاق سراح الرهائن. وتتخذ إسرائيل الآن خطوات استراتيجية أشد وضوحا لما يراه نتنياهو “نهاية اللعبة”، أي استسلام “حماس” على نحو يمكنه من تصويره على أنه “نصر كامل”. وهذا يعني موافقة الحركة على تسليم أسلحتها وخروج قيادتها المتبقية في غزة من القطاع الفلسطيني إلى المنفى، وهو ما يتوافق جزئيا مع خطة الرئيس الأميركي ترمب لوقف الحرب، والتي وافقت عليها “حماس” في مطلع أكتوبر/تشرين الأول، قبل أيام قليلة من دخول الحرب عامها الثالث.
المواجهة مع إيران… من “حرب الوكالة” إلى الاشتباك المباشر
غيرت أحداث السابع من أكتوبر مسار المواجهة بين إيران وإسرائيل بطريقة ستؤثر حتما على المنطقة في السنوات المقبلة. من المرجح أن يدون التاريخ قرار إيران بشن هجومين مباشرين على إسرائيل كواحد من أخطر الأخطاء التي ارتكبتها.
فقد أظهرت عمليات الانتقام الإسرائيلية في أبريل/نيسان وفي أكتوبر 2024 قدرتها على اختراق المجال الجوي الإيراني وضرب أهداف استراتيجية في جميع أنحاء البلاد. واستهدفت عملية أكتوبر، التي سميت “أيام التوبة”، أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية، ومنشآت إنتاج الصواريخ، والمنشآت العسكرية، مما أدى فعليا إلى شل القدرات الدفاعية الإيرانية وشل قدرة إيران على إنتاج الصواريخ.
كشف التصعيد عن تغيرات جوهرية في التوازن الاستراتيجي. فخلافا للمواجهات السابقة، حيث دأب كلا الطرفين على ضبط ردود أفعالهما بعناية لتجنب حرب شاملة، شهدت فترة ما بعد 7 أكتوبر تبني إسرائيل موقفا أكثر عدوانية، وكشف استعدادها للمخاطرة بصراع أوسع نطاقا بغية تحقيق أهداف استراتيجية. شكل هذا خروجا عن “قواعد اللعبة” التقليدية، التي حكمت العلاقات الإيرانية الإسرائيلية طيلة عقود. فلم تعد إسرائيل تدير الصراع، بل تبنت استراتيجية للفوز خطوة خطوة. فاتخذت أكبر خطوة منها في يونيو/حزيران 2025، حين شنت عملية “الأسود الصاعدة”، ونجحت في شل ما تبقى من الدفاعات الجوية الإيرانية، وشل جزء كبير من قوتها الرئيسة للرد الصاروخي، بينما نفذت مرة أخرى عملية اغتيال مستهدفة ناجحة ضد قيادة أعدائها. كما تمكنت إسرائيل من توجيه ضربة قوية للقدرات النووية الإيرانية، من خلال نجاحها في إقناع الرئيس ترمب بضرب منشآت نووية مخفية عميقا في باطن الأرض.
لكن هل سيكون ذلك كافيا؟ على الرغم من موافقة نتنياهو على مضض على الغزو البري لغزة، ورفضه في البداية اقتراحا لوزير الدفاع غالانت بشن هجوم استباقي على “حزب الله”، إلا أنه يدرك السياسة التي طالما دعا إليها “المتطرفون” في إسرائيل. حيث يتمثل موقفهم في أن إسرائيل وحلفاءها لا يستطيعون التعامل على نحو منفصل مع مختلف ركائز التهديد الإيراني، أي البرنامج النووي، والقدرات الباليستية والطائرات المسيرة، والوكلاء الإقليميين. وبينما سعى البعض إلى تجزئة هذه القضايا والتعامل معها واحدة تلو الأخرى، مع عدّ القضية النووية القضية الأكثر إلحاحا، أكد المتطرفون على ضرورة اتباع نهج أكثر شمولية (وعدوانية). وفي الواقع فقد دفع التصعيد الإقليمي الذي أعقب 7 أكتوبر إسرائيل- وسواء كان ذلك متعمدا أم لا- إلى الانخراط في “حرب كليّة” أكثر شمولا ضد إيران. ونادرا ما يكون هدف هذا النوع من الحروب، العودة المضطربة إلى مزيد من الحروب بالوكالة التي نشهدها حاليا بين الخصمين، بل هدفها الهزيمة الكاملة لأحد الطرفين المتحاربين.
الزلزال السوري
لعل انهيار نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، قد شكل التحول الجيوسياسي الأبرز في الشرق الأوسط منذ الربيع العربي. وبالنسبة لإسرائيل، التي تخوض حربا متعددة الجبهات، شكل سقوط الأسد مجموعة من الفرص والمخاطر في آن واحد، وهو ما تطلب منها تعديلا استراتيجيا فوريا.
كان توقيت السقوط بالغ الأهمية. فنظام الأسد كان ركيزة أساسية في “محور المقاومة” الإيراني، إذ مثّل مركزا استراتيجيا لنقل الأسلحة إلى “حزب الله”، واستضاف قوات ووكلاء إيرانيين. وجاء انهياره في وقت كانت فيه إسرائيل قد أضعفت قدرات “حزب الله” إلى حد كبير، وحطمت شبكة إيران الإقليمية، ووجهت ضربة مميتة لطموحات إيران الإقليمية.
ومع ذلك، جاء رد القيادة الإسرائيلية على نحو قد يشكل تهديدات جديدة، بإنشائها منطقة عازلة جديدة في جنوب سوريا، وسعيها لإيجاد حلفاء جدد يمكنهم أن يشكلوا ثقلا موازنا لأي قوة مركزية قوية في دمشق. وهذا الرهان على ضعف سوريا بدلا من قوتها هو رهان ينطوي على مخاطر عالية: فعلى الرغم من سعي إسرائيل لحماية نفسها من التهديدات المستقبلية، فإن تسرعها في النظر إلى سوريا من منظور الأمن فقط، قد يكون نبوءة محققة لذاتها. وبذلك، تقامر إسرائيل بمصير اتفاق أوسع لتطبيع العلاقات مع سوريا، وتوفر الفرصة التي تحتاجها الأطراف الإقليمية الأخرى، التي تسعى إلى تعويض خسارتها (إيران) أو ترى فرصا جديدة لتشديد قبضتها على سوريا (تركيا).
الإرث الدائم لـ7 أكتوبر
سيذكر يوم السابع من أكتوبر 2023 كواحد من أهم الأيام في تاريخ الشرق الأوسط. فما بدأ كمحاولة طموحة من “حماس” لتدويل القضية الفلسطينية وشل حركة إسرائيل، حفز بدلا من ذلك أهم تحول في هياكل القوة الإقليمية منذ عقود.
كما أظهر رد إسرائيل كلا من نقاط الضعف في الدولة، ومكامن قدرتها على الصمود. فقد كانت الإخفاقات الاستخباراتية والعملياتية الأولية التي سمحت بهجمات 7 أكتوبر، إخفاقات مدمرة، لكنها دفعت إلى إعادة تقييم استراتيجي غيّر جذريا موقع إسرائيل في المنطقة. كما يمثل التحول من الردع الدفاعي إلى إعادة التشكيل الهجومي للديناميات الإقليمية مرحلة جديدة في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي، مرحلة تعطي الأولوية للعمل الحاسم على إدارة الصراعات.
لقد حقق السابع من أكتوبر لإسرائيل، ما عجزت عن تحقيقه عقود من التخطيط الاستراتيجي، أي نشوء توازن قوى إقليمي يصب في مصلحة إسرائيل. إلا أن هذه الفرصة لن تكون متاحة إلا إذا كانت إسرائيل مستعدة لتحويل نجاحاتها العسكرية إلى نجاحات سياسية. ويتطلب تحويل هذا النجاح التكتيكي إلى مكاسب استراتيجية مستدامة، حكمة سياسية، وانخراطا دبلوماسيا، واستعدادا لتجاوز النزعة العسكرية المتطرفة، التي اتسمت بها فترة ما بعد السابع من أكتوبر.