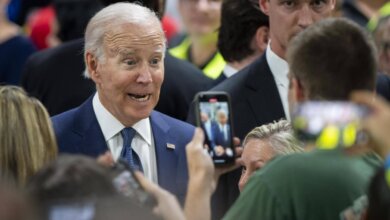وورلد بوليتيكس ريفيو – السياسة الفلسطينية أكثر انقساماً من أي وقت مضى

معهد واشنطن – وورلد بوليتيكس ريفيو – بقلم غيث العمري *– 15/6/2021
مقالات وشهادة
مع استمرار الهدنة الهشة بين غزة وإسرائيل، يبدو أن الصراع على السلطة بين أكبر حزبين فلسطينيين – «حماس» وخصمها «فتح» – مهيّأ للتصعيد. وقد جرّبت كلتا الحركتين كل آلية يمكن تصورها لتقاسم السلطة دون جدوى، ويشعر العديد من الفلسطينيين الآن بالاستبعاد من كلا النوعين من الاستبداد.
أدّى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 21 أيار/مايو إلى إنهاء 11 يوماً من القتال بين إسرائيل و«حماس»، مخلّفاً ما لا يقل عن 248 قتيلاً من الفلسطينيين و12 من الإسرائيليين، بالإضافة إلى دمار لا يوصف في غزة. ومع ذلك، فحتى مع استمرار الهدنة الهشة، يبدو أن الصراع على السلطة بين أكبر حزبين فلسطينيين – «حماس» وخصمها «فتح» – مهيّأ للتصعيد.
إن الجولة الأخيرة من أعمال العنف هي الرابعة منذ عام 2007، عندما انتزعت «حماس» بقسوة السيطرة على غزة بعد فوزها في الانتخابات التي جرت في العام الذي سبق. وجاء ذلك على خلفية أزمة سياسية حادة أثارها قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الدعوة، إلى إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الوطنية الفلسطينية منذ تصويت عام 2006 ومن ثم إلغائها لاحقاً. وفيما يتعلق بحركة «فتح» بزعامة عباس، التي تسيطر على “السلطة الفلسطينية” من مدينة رام الله في الضفة الغربية، فكان يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها غير ذات أهمية خلال الصراع الأخير بين غزة وإسرائيل، وتعاني من انقسامات داخلية انكشفت وتعمّقت بسبب المناورة الانتخابية غير المدروسة.
ومن ناحية أخرى، تسعى «حماس» إلى الاستفادة من ضعف «فتح» والتعاطف الذي ولّدته حربها مع إسرائيل، لتأكيد مكانتها كالحزب المهيمن على الساحة السياسة الفلسطينية. ومع ذلك، فمع انقشاع الغبار وبدء عملية إعادة الإعمار البطيئة، سيبقى الخلل السياسي الفلسطيني قائماً، حيث تكون الوحدة الوطنية الهادفة بعيدة المنال وسط الاغتراب العام المتزايد عن النظام السياسي.
وكَوْن «حماس» منظمة إسلامية مصنّفة كجماعة إرهابية في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من العالم العربي، ظهرت الحركة خلال التسعينيات كمنافس رئيسي لـ «فتح» – الحركة العلمانية التي هيمنت على السياسة والمؤسسات الفلسطينية منذ الستينيات. وكان صعود «حماس» مدفوعاً بفشل عملية السلام التي عارضتها الحركة بشدة منذ البداية، والفساد وسوء الإدارة التي ابتليت بها حركة «فتح». وأدى فوز «حماس» المقنع في انتخابات عام 2006 إلى أزمة بلغت ذروتها في حرب أهلية مصغرة في عام 2007، تركت «حماس» تسيطر على قطاع غزة و”السلطة الفلسطينية” تسيطر على أجزاء من الضفة الغربية.
وحدث التصعيد الأخير في غزة على خلفية لحظة مشحونة بشكل خاص في السياسة الفلسطينية. ففي كانون الثاني/يناير، دعا عباس إلى إجراء سلسلة من الانتخابات الوطنية، تبدأ بالتصويت البرلماني المقرر إجراؤه في أواخر أيار/مايو، يليه تصويت رئاسي في تموز/يوليو. لكن الاستياء الذي طال أمده من زعامة عباس سرعان ما ظهر على السطح، مع تسجيل ثلاث قوائم رئيسية تابعة لـ «فتح» للتنافس في الانتخابات. وفي مواجهة احتمال تكرار انتخابات عام 2006، عندما ساهمت الانقسامات الداخلية داخل «فتح» بشكل كبير في هزيمتها ضد «حماس»، قرر عباس إلغاء الانتخابات. وفي غضون ذلك، أثارت الاشتباكات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في القدس، والتي شملت مداهمات قوات الأمن الإسرائيلية للمسجد الأقصى شديد الحساسية، غضباً فلسطينياً واسع النطاق.
لقد رأت «حماس» فرصة للاستفادة من فوضى «فتح» وتقديم نفسها على أنها المدافع عن الفلسطينيين. وفي الواقع، يمكن القول إن السياسة الداخلية كانت الدافع الرئيسي لـ «حماس» لإطلاق صواريخ على القدس في 10 أيار/مايو، وهي تعلم جيداً أن ذلك سيؤدي إلى رد إسرائيلي مدمّر. وأثبتت المناورة نجاحها. فطوال فترة الصراع، كانت “السلطة الفلسطينية” غير فعالة، وغير قادرة على حشد حتى الحد الأدنى من الاستجابة الدبلوماسية أو السياسية للقتال في غزة، وتم تجاهلها إلى حد كبير في جهود الوساطة الدولية والإقليمية، بما يتجاوز بعض الإيماءات الشكلية لعباس. وأدى هذا الغياب إلى تفاقم خيبة الأمل العامة القائمة مسبقاً من “السلطة الفلسطينية”، والتي ينظر إليها عدد متزايد من الفلسطينيين – 51 في المائة، وفقاً لاستطلاع حديث – على أنها تشكل مسؤولية وليست تشريفاً.
وعلى الصعيد الداخلي، تواجه «فتح» إحدى أسوأ أزماتها منذ تأسيسها. فالانقسامات التي ظهرت في الفترة التي سبقت الانتخابات الملغاة لن تزول لأنها متجذرة في مظالم قديمة وفي عدم الرضا من أسلوب عباس الاستبدادي في القيادة. والواقع أن جزءاً كبيراً من أنصار «فتح» يشعرون بهذا السخط، حيث أن رئيس الحركة السابق محمد دحلان، الذي طرده عباس ونفاه، حشد أعضاء «فتح» في غزة الذين يشعرون بأن عباس تخلى عنهم، في حين أن الزعيم الشعبي في حركة «فتح»، مروان البرغوثي، الذي يقضي خمسة أحكام بالسجن المؤبد في سجن إسرائيلي بتهم القتل المتعمد، نجح في تحفيز العديد من الناشطين الشباب حين أعلن في أواخر آذار/مارس أنه سيدعم قائمةً مستقلة عن المرشحين الرسميين لـ «فتح». وهو الأمر بالنسبة لناصر القدوة، ابن شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات الذي حكم لفترة طويلة، حيث قام بتوجيه مشاعر السخط التي يشعر بها العديد من الأعضاء الأكبر سناً في حركة «فتح». وإذا لم يتم التعامل مع هذه الانقسامات، فستتعمق فقط ويمكن أن تكون تقديماً لانهيار داخلي محتمل داخل «فتح»، لا سيما وأن عباس البالغ من العمر 85 عاماً لم يضع آلية خلافة واضحة.
ومن جانبها، انتعشت «حماس» في أعقاب الصراع مباشرة، حيث سارع قادة الحركة لإعلان النصر. وفي الساعات والأيام التي أعقبت وقف إطلاق النار، تجمع متظاهرون فلسطينيون قرب المسجد الأقصى، مرددين هتافات مؤيدة لـ «حماس» وملوّحين بعلم الحركة. لكن إلى جانب الارتفاع الفوري في شعبيتها، ستواجه «حماس» تحديات. وفي حين أنه من السابق لأوانه تقييم الحجم الكامل للأضرار التي لحقت بالجناح العسكري لـ «حماس» من القتال الأخير مع إسرائيل، فلا شك في أن قدراتها المسلحة قد تدهورت بشدة. ومن الناحية الدبلوماسية، أبرزت جولة القتال الأخيرة عزلة «حماس» الدولية والإقليمية. والجدير بالذكر أن داعمي «حماس» في المنطقة – قطر وتركيا – قاما بدور ثانوي لمصر خلال المفاوضات حول وقف إطلاق النار، على عكس حرب عام 2014، عندما حاولا استبدال القاهرة كالوسيط الرئيسي للسلام في غزة.
وكما في جولات القتال السابقة في عامي 2008 و2014، من المرجح أن تتلاشى التأثيرات الأولية لظاهرة “الالتفاف حول العلم” في غزة لتفسح المجال أمام مشاعر المرارة عندما يتم استيعاب حجم الدمار، وعدم تحقق أموال المساعدات الدولية كما هو محتّم، وحين يبدأ الرأي العام في غزة بالتساؤل مرة أخرى عما إذا كانت معاناته من أجل لاشيء. وفي الواقع، حالما ينقشع الغبار، من المحتمل أن تجد «حماس» أن شعبيتها بين الفلسطينيين خارج غزة هي أكبر من شعبيتها داخل القطاع. وستحاول «حماس» استخدام ذلك [الفرق] للتحريض في الضفة الغربية ومحاولة تنظيم احتجاجات جماهيرية من أجل الضغط على “السلطة الفلسطينية”، كما كانت تحاول فعل ذلك منذ اندلاع القتال الأخير. ومع هذا، لم تنجح هذه الجهود، ويرجع ذلك على الأرجح إلى عدم وجود رغبة عامة في التصعيد والتدابير الوقائية التي اتخذتها قوات الأمن الإسرائيلية و”السلطة الفلسطينية”. وقد يتغير ذلك، لكن في الوقت الحالي يبدو أن «حماس» غير قادرة على ترجمة شعبيتها المتزايدة إلى نفوذ سياسي ملموس.
وبغض النظر عن التكتيكات والمواقف، فمن المرجح أن يخرج المشهد السياسي الفلسطيني الأوسع من هذه الجولة من القتال أكثر انقساماً، مع إضعاف أيدي كل جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية. ويثير انهيار الانتخابات تساؤلات جدية حول إمكانية المصالحة الفلسطينية. ففي السنوات التي أعقبت سيطرة «حماس» على غزة، جرّبت «فتح» و«حماس» كل آلية يمكن تصوّرها لتقاسم السلطة – كاتفاقات مصالحة شاملة، وترتيبات محدودة، ومحاولات متتالية لتشكيل حكومات وحدة [وطنية] وإجراء انتخابات – بوساطة مجموعة من الجهات الفاعلة الإقليمية بما فيها السعودية ومصر وقطر وتركيا. وقد فشلت جميعها. وبالتالي، من الإنصاف التساؤل عما إذا كان من الممكن حتى إجراء مصالحة أو إذا كانت الأسباب الجذرية للانقسام بين «فتح» و«حماس» – لأسباب إيديولوجية وسياسية وأمنية – عميقة الجذور في هذا الوقت بحيث لا يمكن معالجتها.
ومع استمرار المناورات السياسية الحزبية، يشعر عدد متزايد من الفلسطينيين بالتهميش من كلا الطرفين: استبداد «حماس» المتهكم في غزة واستبداد «فتح» غير المجدي في الضفة الغربية. وكلتا الحركتين عاجزتان عن وضع رؤية مقنعة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الرخاء والحكم الرشيد لشعبهما. إن العدد المتزايد من الفلسطينيين الذين لا يؤمنون بقادتهم وبمؤسساتهم وأيديولوجياتهم السياسية لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الحركة الوطنية الفلسطينية أو الاستقرار.
لكن بينما يبدو المستقبل قاتماً، هناك خطوات يستطيع المجتمع الدولي اتخاذها للتأثير على عملية المصالحة، وبشكل رئيسي من خلال إضعاف «حماس» وتقوية “السلطة الفلسطينية” – التي، رغم كل عيوبها، تظل ملتزمة بالدبلوماسية. وصحيحٌ أن دفع “السلطة الفلسطينية” وإسرائيل إلى إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق سلام شامل قد يكون مهمة حمقاء في هذه المرحلة، إلا أنه تتوفر فرصٌ محددة وملموسة، والتي وفقاً لبعض التقارير كانت إدارة بايدن تنظر في بعضها حتى قبل بدء الجولة الأخيرة من القتال. وكان الإعلان الشهر الماضي عن استئناف الولايات المتحدة المساعدات للفلسطينيين – والتي توفقت في عهد الرئيس دونالد ترامب – بداية جيدة، لكن يمكن لإدارة بايدن أيضاً تشجيع التعاون العملي الملموس بين إسرائيل و”السلطة الفلسطينية” لتحسين الحياة اليومية للفلسطينيين. ومثل هذا التقدم سيسمح لـ “السلطة الفلسطينية” بالإدعاء بأن النهج التعاوني غير العنيف يمكن أن يؤتي ثماره.
وفي الوقت نفسه، بإمكان الشركاء الدوليين للفلسطينيين توجيه المساعدات مباشرةً إلى المستفيدين في غزة وبعيداً عن «حماس»، مع اتخاذ إجراءات لعرقلة إعادة تسلّح الحركة. ويمكن للدول العربية – لا سيما تلك التي لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل -دعم إعادة إعمار غزة لتخفيف نفوذ قَطَر، الذي يصب في مصلحة «حماس». كما أن الضغط على “السلطة الفلسطينية” للانخراط في إصلاحات مجدية يمكن أن يسهم إسهاماً كبيراً في إعادة بناء شرعيتها في الداخل.
بإمكان جميع هذه الخطوات أن تلعب دوراً داعماً مهماً. لكن في النهاية، سيحتاج الفلسطينيون أنفسهم إلى العمل معاً لمعالجة انقساماتهم.
*غيث العمري هو زميل أقدم في معهد واشنطن ومستشار سابق لفريق التفاوض الفلسطيني . وتم نشر هذه المقالة في الأصل على موقع “وورلد بوليتيكس ريفيو”.