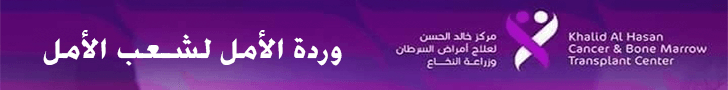معهد بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية: نقطة تحول مثل العام 1967: فرصة لمرة واحدة كل 60 سنة

معهد بيغن السادات للدراسات الاستراتيجية 22/10/2025، شاي شبتاي: نقطة تحول مثل العام 1967 : فرصة لمرة واحدة كل 60 سنة
تُمثل حرب إيران ووقف إطلاق النار الذي طال انتظاره في غزة نقطتي تحول في الشرق الأوسط، على غرار حرب الأيام الستة في العام 1967. تستند المقارنة إلى عدة خصائص رئيسية:
انتصار عسكري إسرائيلي حاسم على عدة جبهات، يُغير الاستقرار الاستراتيجي الإقليمي.
النموذج الأيديولوجي الراديكالي الرائد (الناصرية آنذاك و”المقاومة” اليوم) يتعرض للتقويض والتراجع.
تعززت مكانة الولايات المتحدة الإقليمية بشكل ملحوظ. تحدث تحولات إيجابية في الولاءات تجاه واشنطن (مصر آنذاك، وسوريا، وربما قطر اليوم)، ولكن في الوقت نفسه، تعتمد قوى أخرى بشكل أكبر على القوى العظمى الأخرى (روسيا آنذاك، وروسيا والصين اليوم).
تمتلك إسرائيل أصولًا استراتيجية مهمة تحت تصرفها – أراضي في الماضي، وتفوق أمني اليوم، وعليها أن تقرر كيفية استخدامها بشكل إيجابي.
الجمود ليس خيارًا. يسعى الخصوم إلى تغيير الوضع (من خلال حرب أكتوبر والنضال الفلسطيني، والآن من خلال نزع الشرعية والقوة المضادة)، لذا لا بد من اتخاذ خطوات جوهرية لتشكيل المنطقة بشكل إيجابي.
ماذا نتعلم من اليوم التالي لحرب 1967 على الجانب العربي؟
بعد حرب الأيام الستة، ظهرت خمس مدارس فكرية رئيسية في العالم العربي:
بدأت بعض الأصوات الليبرالية – مجموعة شجاعة من المثقفين – بالحديث عن السلام والاعتراف بإسرائيل. من أبرزهم المصري محمد سيد أحمد، الذي ألّف كتاب “في صمت البنادق” بعد حرب أكتوبر عام 1973، والذي استبق فيه التغيير في القيادة المصرية في عهد السادات.
نهج اللاءات الثلاث – قاد قادة عرب متطرفون قمة الخرطوم، ورسخت نهجًا متشددًا قائمًا على “لا سلام، لا اعتراف، لا مفاوضات مع إسرائيل” سيطر على العالم العربي حتى حرب الخليج الأولى ومؤتمر مدريد.
لقد حددت رؤية أنور السادات – أبرز القادة العرب في القرن العشرين من حيث الرؤية والاستعداد للتغيير – الحاجة إلى تحول نموذجي نحو الولايات المتحدة والسلام مع إسرائيل.
أفسح صعود الإسلام المتطرف – وتراجع الاشتراكية العربية (الناصرية والبعثية) المجال للإسلام المتطرف، الذي بشر بعصر الإرهاب الجهادي.
سيطرة الخطاب الفلسطيني – مع تراجع النضال القومي العربي، سيطرت منظمة التحرير الفلسطينية وياسر عرفات على الخطاب، ومثّل الانتصار الإسرائيلي بداية تحول دولي لصالح “الفلسطيني الضعيف”.
الاستنتاج الرئيسي هو إدراك أن التحول الاستراتيجي في الاستقرار الإقليمي يميل إلى التسريع – وخاصة في الرأي العام – باستجابة أكثر راديكالية منها عملية. ويتمثل التحدي الحالي في جعل الفترة التي تلت حرب إيران ووقف إطلاق النار في غزة فترةً يقودها نهج السادات-بيغن بدلاً من نهج الخميني-بن لادن-حماس.
النماذج السائدة حاليًا قد عفا عليها الزمن
في هذه المرحلة الحرجة، من المناسب تبني نهج جديد للتفكير في الجيواستراتيجية الإقليمية. يجب التخلي عن النماذج القديمة، التي يعود بعضها إلى نقطة تحول العام 1967، أو تحديثها، والتي فشلت في تحقيق الأمن في المنطقة على مدى نصف القرن الماضي. وللتعامل بشكل صحيح مع التحدي المعقد المتمثل في تعظيم الفرص والتحوط من المخاطر، من الضروري استبدال “الأفكار الكبرى” القديمة، بما في ذلك:
“اتفاقيات السلام” و”التطبيع” الرسمي: في العصر الحالي، أصبحت الاتفاقيات الرسمية أقل أهمية. وبدلًا منها، هناك حاجة إلى بروتوكولات أمنية ومدنية واقتصادية مرنة (مذكرات تفاهم)، دون الحاجة إلى شكليات مفرطة تعيق التقدم في القضية الفلسطينية مع سوريا ولبنان، ومع دول “اتفاقيات إبراهيم”، مع التركيز على المملكة العربية السعودية.
حل “الدولتين” (قرار مجلس الأمن رقم 242): إن عشرين عامًا من فشل “السيادة” الفلسطينية في غزة تُعدّ الدليل الأبرز على أن حل القضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى مناهج هجينة جديدة، لا إلى مفاهيم قديمة للسيادة.
“المحاور” الإقليمية: إن وصف العلاقات في الشرق الأوسط بمصطلحات “محور” (راديكالي، جهادي، إسلامي، براغماتي…) غير فعال، بل مُضلل. يُبسط هذا المفهوم التعقيد الجيوستراتيجي في الشرق الأوسط. قد يكون مفهوم مرن للتحليل والعمل أكثر فائدة في التعامل مع التحديات الهائلة. يجب على إسرائيل التصرف بمرونة وتحديد المصالح المشتركة حتى مع الجهات الفاعلة التي كانت تُعتبر في السابق مُعادية. على سبيل المثال، يُعد الضغط الذي مارسته قطر وتركيا على حماس لتحقيق مصالح إسرائيلية مُتميزة في مفاوضات وقف إطلاق النار الأخيرة في غزة تعبيرًا عن هذا التعقيد.
“الديمقراطية”: الدول العربية الأكثر تقدمًا واستقرارًا وبراغماتية وابتكارًا في المنطقة ليست ديمقراطية. يبدو أن أشكال الحكم الهجينة في الشرق الأوسط ضرورية أحيانًا لتحقيق التقدم والسيطرة.
“الشارع العربي”: غالبًا ما يرتكز الرأي العام الإقليمي على الخوف والكراهية، ولذلك لا ينبغي اعتباره أساسًا للدفع بالسياسات. يجب أن تتجاوز الحلول العملية مسألة الرأي العام هذه، ويجب أن تُشكّل القيادة الحقيقية الرأي العام، لا أن تتحكم به.
طرق جديدة للتفكير في الجيواستراتيجية الإقليمية
لإحداث تغيير إقليمي، يجب التخلي عن النماذج القديمة واعتماد نماذج جديدة. تتضمن قائمة أولية بالأفكار التي قد تكون مناسبة لصياغة الموقف الاستراتيجي الإقليمي الجديد ما يلي:
الشراكات الأمنية: بدلاً من “التحالفات” الرسمية، ينبغي إرساء تعاون غير رسمي ومرن قائم على مذكرات تفاهم. هكذا تعاملت إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وحلفائها الآخرين خلال حرب إيران. قد تكون “التحالفات” و”الائتلافات” الأمنية رسمية وعلنية للغاية بحيث لا يمكنها التعامل مع تحديات كبيرة، مثل الرد الإيراني المحتمل على الهزيمة العسكرية، أو التحرك لنزع سلاح غزة، أو كبح نشاط الحوثيين، أو الاستجابة لعدم الاستقرار الدموي في سوريا. ينبغي على الولايات المتحدة وإسرائيل والقوى الإقليمية والعالمية ذات التوجهات المماثلة استخدام أطر تعاون أقل رسمية، تستند إلى مذكرات تفاهم أكثر من الاتفاقيات. ويبدو أن هذا النهج كان واضحًا بالفعل خلال حرب إيران، عندما نُفذت جهود الدفاع ضد العدوان العسكري الإيراني في إطار آليات تنسيق عملياتية وثنائية ومتعددة الجنسيات.
شبكة بنية تحتية إقليمية: إن أفضل سبيل لبناء علاقات طويلة الأمد هو من خلال الاعتماد المتبادل الدائم على البنية التحتية المشتركة (لتوطيد العلاقات، إن جاز التعبير). هذا هو السبيل للتغلب على التقلبات الطبيعية في العلاقات السياسية والشخصية. تحتاج دول الشرق الأوسط إلى التواصل فيما بينها من خلال شبكات حيوية للطاقة والمياه والنقل والاتصالات. ولأن هذه جهود طويلة الأمد، يجب أن تبدأ هذه المشاريع الآن. ويمكن أن تستند إلى مبادرة الممر الاقتصادي الهندي-الشرق أوسطي-الأوروبي (IMEEC) التي تقودها الولايات المتحدة، وبناء البنية التحتية والممر الاقتصادي كطريق بديل إلى البحر الأحمر غير المستقر.
الرؤية المدنية: ينبغي بناء الرؤية الإقليمية الجديدة بمعزل عن معالجة القضايا السياسية والأمنية، والتركيز على تطوير التحديات المدنية والاقتصادية ومواجهتها بقيادة القطاع المدني والجانب المدني-الاقتصادي للحكومات. إن التحديات المستقبلية في هذه المجالات، مثل التحول التكنولوجي السريع وعواقب التغير البيئي، كبيرة بما يكفي لتأسيس رؤية مشتركة متينة.
المساءلة غير الانتخابية: الديمقراطية ليست شرطًا أساسيًا لمنطقة براغماتية مزدهرة. ينبغي أن تستند هذه المساءلة إلى اتفاق متبادل على مبادئ سلوكية أساسية مشتركة من شأنها تعزيز رفاهية سكان المنطقة والتعاون البنّاء. يمكن أن تشمل هذه المبادئ عدم دعم الإرهاب؛ وعدم الإضرار المادي بالأقليات؛ واحترام الحقوق الفردية؛ والعلاقات الاقتصادية المفتوحة، إلخ. ويمكن تحديد هذه المبادئ من خلال إعلانات مشتركة للجهات الفاعلة الإقليمية والعالمية.
سيادة الدولة الهجينة: لا يمكن حل مشاكل الشرق الأوسط على أساس مبادئ السيادة المقبولة. وهذا ينطبق ليس فقط على القضية الفلسطينية المعقدة، بل أيضًا على القضايا الإقليمية المهمة مثل الأكراد والدروز والأقليات المسيحية والوضع في اليمن والسودان وليبيا والصومال. لقد أصبح العالم هجينًا ومعقدًا على المستوى الفردي، وقد حان الوقت للانتقال إلى مستوى الدولة أيضًا. يجب على المجتمع الدولي والإقليمي قبول أشكال أخرى من الوجود من خلال فصل طبقات الدولة المختلفة (السكان – الإقليم – الحكومة – الاعتراف الدولي) المنفصلة عن اتفاقية مونتيفيديو.
في القضية الفلسطينية، تتزايد بشكل متزايد أفكارٌ من نوعٍ مختلف (نموذج بورتوريكو، والترتيبات السياسية الخاصة، واتحادٌ بين كياناتٍ بعضها ليس دولًا ذات سيادة، وغيرها). يمكن للمرء أن يتصوّر نموذجًا يحظى فيه الشعب الفلسطيني بحمايةٍ كاملةٍ في مجال الجنسية غير الإسرائيلية، وتتولى إسرائيل السيطرة الأمنية على الأراضي التي يقيمون فيها، وتُدار شؤونهم المدنية من قِبل هيئةٍ حاكمةٍ ليست حكومةً ذات سيادة، ويحافظ على علاقاتٍ – بما في ذلك تمثيليات – في مجالات نشاطه مع دولٍ حول العالم.
تهميش المتطرفين: بدلًا من تفكيك التطرف، يجب عزل العناصر المتطرفة ومحاصرتها. بحرمانهم من القدرة على إلحاق الأذى، سيتم القضاء على حوافزٍ كبيرةٍ لدعمهم، وستُتاح الفرصة لأنصارهم الشعبيين للعودة إلى رشدهم والتخلي عنهم. هذا بدلًا من جهود “إعادة التأهيل” التي تُشكك فعاليتها بشدة.
الحكم شبه الذاتي: ((SSG يسمح هذا المبدأ للقوات المحلية بإدارة شؤونها بشكل مستقل لتحسين حياة السكان المدنيين، مع إضفاء الشرعية على التدخل الخارجي عند ظهور مشاكل تُشكل مخاطر داخلية محتملة (إبادة جماعية، إلحاق الضرر بالأقليات) وخارجية (التسلح النووي والصاروخي، تصدير الإرهاب، وموجات اللاجئين). في الواقع، ينعكس هذا المبدأ في التحرك الأمريكي والإسرائيلي ضد الحوثيين، وفي الحرب على إيران (التي ركزت على تهديد أسلحة الدمار الشامل بدلاً من تغيير النظام)، وفي التدخل الإسرائيلي لمنع الإبادة الجماعية للدروز في سوريا.
التغيير الاستراتيجي الإسرائيلي
في ظل الوضع الجيوستراتيجي الإقليمي الجديد، وتطبيق هذه النماذج، أصبح لإسرائيل دور جديد. أصبحت إسرائيل قوة أمنية إقليمية. وهذا موقف مختلف تمامًا عن استراتيجيتها الأصلية للأمن القومي، التي كانت تقوم على فرضية العمل المتمثلة في الدونية الأساسية والهيكلية مقارنةً بـ “التحالف الشامل” للدول العربية. من خلال أن تصبح إسرائيل قوة إقليمية، يُمكنها الموازنة بين الردع الأساسي الحقيقي – دون استخدام القوة – واستخدام أكثر دقة للقوة العسكرية لإزالة التهديدات عند الضرورة.
يجب على إسرائيل صياغة استراتيجية شراكات ذكية تُخاطب جميع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وبناء تعاون مرن ثنائي ومتعدد الأطراف لتلبية احتياجاتها واحتياجات شركائها المتنوعة. يجب أن تبدأ باغتنام الفرصة الفريدة التي يتيحها نهج إدارة ترامب، وتوطيد شبكة البنية التحتية الإقليمية.
شاي شبتاي : نائب مدير المركز في الجيش الإسرائيلي، وخبير في الأمن القومي والتخطيط الاستراتيجي والاتصالات الاستراتيجية. خبير استراتيجي في مجال الدفاع السيبراني، ومستشار لشركات رائدة في إسرائيل.