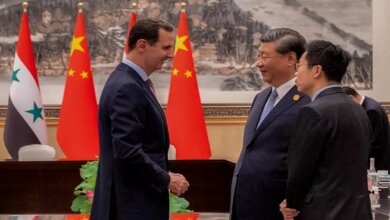مشاهد من أعماق الدولة المصرية(*)
مركز الناطور للدراسات والابحاث
للوهلة الأولى، تبدو الاضطرابات التي ضربت مصر منذ منتصف تشرين الثاني، في الغالب، اختباراً للأداء المتواضع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في تولي معالجة مسألة العملية الانتقالية بعيداً عن حكم حسني مبارك. فمع تسلمه السلطة في 10 شباط، انتقل المجلس الأعلى بسرعة للحصول على ختم الشرعية الشعبية من خلال استفتاء 14 آذار حول التعديلات الدستورية. في كل الأحوال، ومنذ ذلك الحين، واجتماع الجنرالات السري يتعثر بسبب منطق خطته الانتقالية المشوبة بالعيوب، بالإضافة إلى صناعة القرار المرتجل وموقف متعسف رافض تجاه الحياة السياسية الجديدة للبلاد. باختصار، كانت خطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع تصميم وتدبير لاستعادة حكم مدني كان يحمي الصلاحيات السياسية والاقتصادية للجيش من المراقبة المدنية، وربما تعزيز تلك الأدوار، وتطويع نظام لا يختلف عن “الدولة العميقة” التي هيمنت لعقود في تركيا. بالواقع، لقد كان النظام في مصر هكذا بظل حكم مبارك.
في الوقت الذي تلوح فيه حكومة مدنية بالأفق، مع تحديد إعادة فتح البرلمان والانتخابات الرئاسية المقررة في تموز 2012 كحد أقصى، يبدو المجلس العسكري للقوات المسلحة أكثر ابتعاداً عن ضمان هذا النوع من الهيمنة للجيش خلف الكواليس وأبعد عن الفوز بالقبول الشعبي لذلك الترتيب. بالواقع، وبما يتعلق بقسم كبير من الطبقة السياسية، وشريحة هامة ومنطقية من الرأي العام، فإن العنف الذي حصل في أوائل الشتاء خفض السلطة المعنوية للجيش إلى مستوى غير مسبوق منذ هزيمته على يد إسرائيل في العام 1967.
نزع الشرعية هذا لا يختلف، في بعض جوانبه، عن تآكل سلطة مبارك في العقد الأخير من القرن الماضي: تماماً كما كان الحال مع الرئيس المخلوع، الذي ما أن اعتبر محظوراً لمسه حتى أصبح هدف وأضحوكة الناشطين وسخرية وسائل الإعلام. منذ أواخر العام 2004 فصاعداً، يجد الجيش نفسه الآن عرضة لنقد وتدقيق غير مسبوقين. الفرق هو أن سقوط المجلس الأعلى من مكانته السامية يحدث بخطوات متسارعة، مدفوعاً بالإيمان الجديد بحياة سياسية تشاركية أطلقت عنانها ثورة يناير والتصرف الأخرق للجيش.
المثلث المصيري
في نظر البعض، تتقاسم حركة التظاهرات والطبقة السياسية اللوم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن توقف العملية الانتقالية ما بعد مبارك، الأولى بسبب النزول الى الشوارع من دون أجندة واضحة للأمد الطويل، والأخيرة بسبب الفشل بصياغة عمل متجانس متناغم بسبب سوء إدارة المجلس الأعلى. فبدلاً من العمل معاً، انخرط السياسيون من كل الشرائح في جدل عقيم حول هوية مصر، والتحول في نهاية المطاف إلى المجلس الأعلى للتحكيم.
إن الإخوان المسلمين، أكبر وأكثر قوة حزبية سياسية مصرية محاكة بشكل دقيق، مرتاحة للعلاقة الدافئة مع الجنرالات، الذين كانوا بدورهم مرتاحين بسبب قدرة الإخوان المفترضة على السيطرة على الشوارع. فالإخوان، الذين كانوا خارج القانون رسمياً في عهد مبارك والذين سبقوه، حصلوا على درجة من ” التطبيع”، بالإضافة إلى خطة انتقالية لمصلحتهم. وقد ترأس القاضي السابق طارق البشري، مفكر إسلامي لامع، لجنة مهمتها إعادة صياغة المواد الدستورية الست المتعلقة باستفتاء 19 آذار. ولم تضم هذه الهيئة ممثلين عن الأحزاب العلمانية والجماعات الثورية الشبابية، ما عدا أحد السياسيين، عضو البرلمان المصري السابق في الإخوان من مدينة الإسكندرية صبحي صالح. وقام الإخوان وإسلاميون آخرون بحملة للمصادقة بـ “نعم” على التعديلات الدستورية كواجب ديني أحياناً. وبعدما أدلى 79 من المصوتين بـ “نعم”، أُدرجت البنود المعدلة في المادة 62 من “الإعلان الدستوري” الذي صدر، وببساطة، بمرسوم من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة. إلا أن الإخوان انجذبوا إلى مخطط الجنرالات الذي يضع الانتخابات البرلمانية في المقام الأول ـ أمام دستور جديد بالكامل يعين السلطات البرلمانية ـ لأن تنظيمهم وأعدادهم المتفوقة جعلتهم الأكثر احتمالاً بالنجاح.
أما الأحزاب العلمانية، من جانبها، فجاهدت في هذا السياق لجعل الموافقة الرسمية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة موجودة في الخطوط العريضة لدستور جديد. وسعى بعض هذه الأحزاب، تحديداً الأحزاب المسجلة حديثاً التي اختارت التجنيد من صفوف الحزب الديمقراطي الوطني الحاكم سابقاً، البائد الآن، إلى المساندة الضمنية من النظام القديم.
ساهم تشكيل هذا المثلث الإسلامي ـ المجلس الأعلى ـ العلماني، بأن كان، وبشكل طبيعي، في مصلحة الجنرالات. فكبار الضباط الحاكمين وضعوا أنفسهم كحكام لما كان، في معظم الأحيان، لا جدال فيه بخصوص مصطلحات كـ “إسلامي” و “مدني” وما ينبغي تصوره في تعريف وتحديد دولة ما بعد مبارك. لقد سقط العلمانيون في فخ الإسلاميين بالجدل حول الهوية، حيث لا يمكنهم الفوز أبداً، بدلاً من التجاوب مع مطالب الشعب بالعدالة الاجتماعية، والازدهار، وفرض القانون والنظام.
في غضون ذلك، أقرض السياسيون بعض العون لحركة التظاهرات ـ طاقم متعدد الألوان من الشباب الليبرالي، مع نكهة من الراديكاليين وعدة آلاف من المتعاطفين غير المنتمين التي تعتبر ثورة يناير بالنسبة لهم ذكرى لا تمحى. هؤلاء الناشطون الذين يرفضون السياسات الرسمية أو يرغبون بالعمل بشكل مستقل وجدوا أنفسهم هدفاً للأجهزة الأمنية المعاد تنشيطها؛ آلة إعلام الدولة التي رسمتهم كمشاغبين وصناع قلاقل وخونة على نحو متزايد؛ ومشروع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المروِّج “للاستقرار” مقابل “الفوضى” و”المطالب الفئوية”، شيفرة لهواجس ضيقة مفترضة التعبير عنها كان مضراً بالتقدم الوطني.
لقد سبق وتم إرسال عدد من الناشطين إلى محاكم عسكرية في منتصف شباط، والتي لا تقدم إمكانية للاستئناف. واستمر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجعل الأجهزة الأمنية المدنية تعمل على فرض قانون الطوارئ المكروه منذ عام 1981. وفي الخريف، تم التذرع ببنود أخرى لهذا القانون، كحظر التجمعات العامة التي يفوق عددها 5 أشخاص. أما الإدانة بالقتل التي يواجهها المدون علاء عبد الفتاح فهي واحدة من التهم الغريبة المضحكة المرمية على متظاهرين معروفين جداً.
غيوم سوداء فوق القاهرة
بدأت مزاعم الجيش بأنه حامي الثورة تضعف بعد وقت قصير من الإطاحة بمبارك. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة كان بطيئاً في اعتقال جبابرة النظام القديم، وأساءت شرطته العسكرية معاملة المتظاهرين في آذار ونيسان، كما حصل في مسألة “فحص العذرية” الشائن للنساء. ووصل سخط حركة التظاهرات إلى ذروته في إعادة احتلال ميدان التحرير في تموز. وكان هناك نقطة تحول أخرى في مواجهة 9 تشرين الأول في المقر الرئيس للبث الإذاعي والتلفزيوني المعروف بـ “ماسبيرو”، حيث مات 25 متظاهراً يطالبون بالحقوق القبطية على أيدي جنود الجيش المصري (يزعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة موت عدد غير معروف من الجنود أيضاً؛ عبد الفتاح متهم بجريمة قتل في هذا الصدد). وإذا كان عدد من المصريين قد تقبلوا أن تكون هذه الوفيات ناتجة عن الذعر في أوساط الجنود، فإن سيطرة المجلس الأعلى على التعاطف الشعبي قد بدأت تتراخى وتنزلق من بين أيديه وسط صدامات تشرين الثاني وكانون الأول.
وعلى خلاف أمثلة سابقة، باستثناء ماسبيرو وأمثلة قليلة أخرى، كانت معظم المواجهات الأخيرة ـ في القاهرة، الإسكندرية، والسويس ـ دموية جداً، إذ أودت بحياة 57 شخصاً على الأقل وجرح أكثر من 1500. بدأت هذه الصدامات في 19 تشرين الثاني، بعد يوم من “مسيرة المليون السلمية” في آذار في ميدان التحرير، بقيادة مجموعات إسلامية لكنها اجتذبت أيضاً مشاركة علمانية هامة وبارزة.
وقد ركز المتظاهرون غضبهم وحنقهم على “المبادئ الدستورية أعلاه” التي صاغها نائب رئيس الوزراء آنذاك علي السالمي، في محاولة لتحديد العقائد الأساسية لدستور جديد مسبقاً بالإضافة الى تحديد مسبق لقوانين الجمعية العامة الدستورية المستقبلية. ومن بين الإجراءات المقترحة ضمان سرية الموازنة العسكرية وسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لفرض جمعيته التأسيسية الخاصة إذا ما فشلت الهيئة المعينة من قبل البرلمان بالموافقة على مسوّدة الميثاق الوطني. ومر يوم التظاهر ضد إمساك الجيش بالسلطة من دون حوادث.
كان قرار الجماعات السلفية والإخوان المسلمين بدعم تظاهرة 18 تشرين الثاني/نوفمبر علامة مميزة على أول خرق علني للقوى الإسلامية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فالخرق الذي جاء قبل أقل من أسبوعين من بدء الانتخابات البرلمانية كان تحدياً مهماً للجيش. في كل الأحوال، كان الإسلاميون واثقين من فرصهم الانتخابية، ومن السابق للأوان إعلان الطلاق بينهم وبين الجيش. ولم يلجأ الإخوان إلى التظاهرات إلا في مناسبة نادرة فقط. بالواقع، وبما يتعلق بمعظم الفترة الانتقالية، فقد وقفت كوادرهم جانباً، قرار يراه كثيرون من رواد ميدان التحرير دليلاً على وجود صفقة مع المجلس الأعلى. ما يعزز هذا التحليل واقع انسحاب الإخوان، بالاضافة إلى السلفيين، من ميدان التحرير، بشكل كبير، في الساعة السادسة مساءً في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر، تاركين الناشطين الآخرين خلفهم. وفي الصباح التالي، لم يكن قد بقي إلا بضع مئات فقط من المتعصبين مع عائلات ضحايا ثورة يناير في المعسكر الصغير. وكانت العائلات قد ثبتت خيامها قبل بضعة أسابيع للمطالبة بالتحقيق في موت أحبائها ودفع التعويضات الموعودة.
إن عنف تشرين الثاني/ نوفمبر ـ كانون الأول/ ديسمبر نابع من قرار الدولة بإرسال شرطة مكافحة الشغب لتطهير المكان من المتظاهرين الباقين. واستخدمت الشرطة قوة لا بأس بها، ما استفز الناس على إعادة احتلال كامل لميدان التحرير وحصول مشاجرة في شارع محمد محمود المحاذي للميدان، والذي أسفر عن سقوط 40 ضحية وجرح المئات، عدد منهم في حالة حرجة. وقد عُلم بأن قناصة الشرطة كانوا يصوّبون على رؤوس المتظاهرين؛ وقد فقد عدد من الناشطين إحدى عينيه، بمن فيهم شخص سبق له وأن فقد إحدى عينيه في يناير وعاد وفقد الأخرى لاحقاً. إن الاستخدام الهائل للغازات المسيلة للدموع على مدى الأسبوع الذي تلا غطى وسط القاهرة بسحابة حادة من الدخان، جعلت المئات، إن لم يكن أكثر، يعانون من أمراض خطيرة. وقد شهد الأطباء في المستشفى الميداني الذي أسسه متطوعون حالات عديدة من النوبات بسبب تنشق الغاز المسيل للدموع. وسواء تم استخدام مادة غير غاز CS العادية، كما يشك البعض، أم لا، فإن هذا يبقى محل تحقيق وبحث. ويزعم بعض الناشطين بأنه قد تم نشر أسلحة كيميائية عسكرية عندما أثبت الغاز المسيل للدموع العادي عدم فعاليته.
إن ظروف القرار بإعطاء الأمر للشرطة بالتدخل غير الضروري في 18 تشرين الثاني/نوفمبر أمر محير. وقد صرح عدد من الوزراء بأنهم يعارضون خطوة كهذه، بما في ذلك، وهذا غريب، وزير الداخلية، الذي يشرف رسمياً على شرطة مكافحة الشغب، القوى الأمنية المركزية. وقد يكون المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو ضباط أمن آخرون نقضوا حكم سلطة عليا وعملوا بخلافها. كما إن من الغريب بصورة مشابهة السماح باستمرار القتال عدة أيام قبل تدخل الجيش، مستفيداً من هدنة لبناء جدار يفصل شرطة مكافحة الشغب عن المتظاهرين.
لقد أثارت صدامات شارع محمد محمود، التي استدعت مشاهد وحشية الشرطة في أواخر كانون الثاني، الشعب. وقام المجلس الأعلى ببعض التنازلات الهامة، بموافقته على إجراء انتخابات رئاسية بحلول تموز 2012 (كان يقول سابقاً إنها قد تجرى في منتصف العام 2013) وإقالة حكومة عصام شرف غير الفعالة، وزير النقل السابق في حقبة مبارك الذي جعله موقفه المبكر الموالي للثورة يكسب تعاطف المتظاهرين في شباط. وتحول الاهتمام بسرعة بعيداً عن ميدان التحرير ما إن بدأت الانتخابات البرلمانية في 28 تشرين الثاني، ساحبة معها حشوداً كبيرة إلى مراكز التصويت.
على مدى الأسبوعين التاليين، أعيد فتح ميدان التحرير وبدأ محتلوه اعتصاماً على بعد ثلاثة بلوكات جنوباً، أمام مكتب رئيس الوزراء في شارع مجلس الشعب، حيث يوجد البرلمان أيضاً. وتقدم المتظاهرون بمطالب عديدة، بعضها قديم وبعضها حديث المنشأ. ودعوا، على سبيل المثال، إلى إنهاء المحاكمات العسكرية ومحاسبة الشرطة على وحشيتها، بالإضافة إلى معارضة تعيين كمال الجنزوري، رئيس وزراء في حقبة مبارك (1996ـ1999)، رئيسَ وزراء مؤقتاً.
وبعد طرد عصام شرف، كان هناك أمل بأن يتقاسم الجيش السلطة مع مجلس رئاسي مدني. وقد تحمل وثبت المعتصمون في الأسابيع الأولى من كانون الأول من دون مشاكل، عدا عشرات الحالات المتعلقة بالتسمم الغذائي. وكانت البلاد مسمّرة بسبب الانتخابات وتحديداً، بسبب نجاح الإخوان المسلمين والسلفيين، الذين حصلوا على حوالي 40 و20 بالمئة من المقاعد، على التوالي، في الجولة الأولى.
بدأت الجولة الثانية من القتال في الصباح الباكر يوم 17 كانون الأول، عندما رفس أحد الأفراد المعتصمين طابة إلى داخل حدائق البرلمان وتسلق السور لجلبها، بحسب معظم الروايات. وبعد احتجازه من قبل الشرطة العسكرية عدة ساعات، أعيد الى المتظاهرين مضروباً ومكدوماً.. وفي الصباح التالي، سد شارع مجلس الشعب متراس مؤقت بدءاً من شارع القصر العيني شريان المواصلات الرئيس للبلد الذي يقود الى ميدان التحرير. وأخذ المتظاهرون يلقون، من أحد جانبي الطريق، الحجارة، ومن الجانب الآخر قام رجال بثياب مدنية وجنود ببزاتهم العسكرية بالمثل. ووصفت السلطات المقاتلين بالثياب المدنية بأنهم من الأهالي الغاضبين، رغم أنه لا منازل في ذلك الشارع بالتحديد؛ ورد المتظاهرون عليهم بأن هؤلاء هم ضباط شرطة سريون. كما وقفت مجموعات من الجنود ورجال آخرون على سطوح المباني، لإلقاء الحجارة، وقنابل المولوتوف البدائية، وأثاث المكاتب والحطام على رؤوس المتظاهرين. ومن وقت لآخر، كان كل فريق يتوقف ليطلق الإهانات والإشارات البذيئة لمعارضيه.
وقد اتهم المعارضون، وعدد من المتعاطفين، المتظاهرين برمي الحجارة لإلقاء الرعب في النفوس أو للثأر. في كل الأحوال، إن أكثر ما أذهل المصريين هو سلوك الشرطة العسكرية والجنود الآخرين. وقالوا وهم يهزون رؤوسهم، إنه لم يكن يُسمح، إطلاقاً، لرجال يرتدون البزة الكاكية بالتصرف بهذه الطريقة التعسفية المستهترة للغاية. وقد تم استخدام القناصة لقتل المتظاهرين بحسب الظاهر، بمن فيهم الناشطة البارزة أزهار الشيخ وعماد عفت، اللذان توصلا إلى رعاية هدنة.
وقد التقطت عدسات الكاميرا جنوداً وهم يبولون على متظاهرين من أعالي المباني ويهاجمون النساء، كـ “الفتاة صاحبة حمالة الصدر الزرقاء”، وهي طبيبة متطوعة في المستشفى الميداني في ميدان التحرير والتي أدى الدوس الوحشي عليها إلى حبس أنفاس الناس الآن في العالم أجمع. ومعظم هذا الوقت، كان جنود مكافحة الشغب ورجال الشرطة النظاميون الآخرون غائبين. لم يكن هناك من معلومات عن سبب عدم معالجة وزارة الداخلية للتظاهرات، كما تفعل بشكل طبيعي. فالجنود لم يكونوا على استعداد لمعاملة المصريين بوضاعة كما تفعل الشرطة فحسب، بل إنهم تخلوا أيضاً عن الانضباط الذي يتوقعه المرء من رجال عسكريين، وبالتأكيد من أولئك الذين كيل لهم الثناء بشدة بسبب تراجعهم عن إطلاق النار على المتظاهرين في كانون الثاني وشباط.
تلاشت المعركة من أمام مكتب الحكومة على مدى الأيام القليلة التالية، مع عمليات اقتحام مميتة للجيش لدفع المتظاهرين إلى الوراء باتجاه ميدان التحرير.
وانضم شارعان رئيسان قرب البلازا، هما شارع الشيخ ريحان والقصر العيني، إلى شارع محمد محمود بإغلاقه بجدار من الخرسانة بعرض 12 قدماً، ما أدى إلى فوضى مرورية أكبر في القاهرة المزدحمة أصلاً. وبالنسبة للحكومة وقسم كبير من الإعلام الموالي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، المتظاهرون هم مثيرو شغب وبعيدون جداً عن “ثورات يناير الحقيقية”. هذا الخط قد يستعيد بعضاً من المصداقية لدى الشعب، أي القلق من الاضطرابات. لكن ما لا يمكن إنكاره هو أن مصداقية ومشروعية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمؤسسة العسكرية ككل بالطبع، قد عانت من ضرر بالغ.
ما تحت السطح
بمجيئهم كما فعلوا وسط الانتخابات، كان لدى المتظاهرين الإمكانية لتحويل الطريق الى الحكم المدني. ففي أوساط الإسلاميين، تحديداً، كان المتظاهرون قلقين بعمق. وكان الإخوان المسلمون أكثرهم قلقاً على الإطلاق، الذين تخوفوا من حالة اضطرابات مطولة يمكن أن تقود الى إلغاء الانتخابات. فمع رفعهم تعليق المشاركة في الانتخابات في تظاهرات كبيرة في 18 تشرين الثاني، رفض الإخوان دعم أية تظاهرات لاحقة. وقد تبنت منشوراتهم ـ باللغتين العربية والإنكليزية ـ على المواقع الإلكترونية وفي الصحيفة اليومية لحزبهم حزب الحرية والعدالة ـ الغموض المتعمد حول الموضوع. أما القياديون في الإخوان الذين برزوا في ثورة يناير، كالنائب السابق في البرلمان محمود البلتاجي، فقد كانوا يشعرون بالأسى بشكل واضح بسبب تحفّظ المنظمة على الحياة السياسية الشاملة، لكنهم أذعنوا في نهاية المطاف.
تحدث كثيرون عن فخ نصبه المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تحديداً خلال الموجة الثانية من التظاهرات قرب مبنى الحكومة، عندما بدا أن الجيش يقوم بالاستفزاز ليبدأ معارك الشوارع. إن قتل العالم الجليل الشيخ عفت، العضو في دار الإفتاء الذي فوضته السلطة إصدار الفتاوى لمصلحة الدولة المصرية، كان صدمة بالنسبة للإسلاميين. أما ابو العلاء مهدي، رئيس حزب الوسط، فرع من الإخوان منذ العام 1995، فقد تعرض لصيحات الاستهجان وأُبعد عن جنازة عفت في جامع الأزهر لأنه كان يعمل في هيئة تم تعيينها بعد تظاهرات شارع محمد محمود لتقديم المشورة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.. واستقال المهدي في اليوم التالي.
إن قرار الإخوان بالبقاء خارج الشارع، وإصرارهم الأساسي على الانتخابات، وازدراءهم لحركة التظاهرات ـ الذي كان يجد صداه أحياناً لدى المجلس الأعلى ـ كل هذا أكسبهم الخزي بنظر عدد من الناشطين. ففي نظر كثيرين، الإخوان مهتمون علناً بالانتخابات التي فازوا فيها من حيث الجوهر. ويشتبه بأنهم يحضرون لمفاوضات مع الجيش حول السلطة التشريعية وكتابة دستور جديد، بصفته أكبر حزب مقبل في المجلس التشريعي وربما صانع الملوك في الانتخابات الرئاسية. ومن المرجح، بالتالي، أن يكون الإخوان مشغولين، وقد يصادق البعض ضمنياً، بالواقع، على إجراءات صارمة ضد متظاهرين علمانيين بغالبيتهم، لكن العامل الإسلامي لا يفسر سبب أخذ الأحداث الى تحوّل قاتم كهذا. فإذا ما كان المجلس الأعلى والإخوان في حالة تعاون وثيق، فلن يكون الجيش بحاجة إلى عرض عضلاته كما فعل في شارع مجلس الشعب. بل لو كان المجلس الأعلى يقصد تأكيد احتكاره للعنف كرسالة للإخوان، ولقوى سياسية أخرى أيضاً، فإنه قام بذلك بكلفة هائلة هي تمزيق سمعة قائده، المشير محمد حسين طنطاوي، وتلطيخ صورة الجيش في الداخل والخارج.
بعيداً عن العجز وعدم الكفاءة، لأفعال الجيش تفسير آخر: إعادة تأكيد “الدولة العميقة” التي أصيبت بكدمات سيئة خلال ثورة يناير وأخذت بعض الوقت لاستعادة موطئ لقدمها. وفي حين أنه ربما كان الجيش حجر الأساس للدولة المصرية ما بعد عام 1952، فإن نظام البلد من الأجهزة الأمنية يعبر الحدود الموجودة بين ما هو مدني وعسكري. فقد تلقت أجهزة وزارة الداخلية، تحديداً، ضربة بسبب الثورة وسقوط وزير الداخلية السابق حبيب العادلي، الذي حشد نفوذاً لا نظير له في سنواته الطويلة في عمله. ومن غير الواضح من الذي يسيطر اليوم على وزارة الداخلية، لكن من المؤكد تقريباً أن منصور العيساوي رجل الشرطة المتمرس المسؤول عندما اندلعت الصدامات في الشتاء، لم يكن سيد بيته الخاص.
إن أقوى جهاز أمني في مصر اليوم هو وكالة الاستخبارات العامة، التي تلتقط وتجمع كبار موظفيها من الجيش والتي كانت خسارتها الوحيدة في كانون الثاني رئيسها، عمر سليمان، الذي عمل لفترة وجيزة نائباً أولَ وأخيراً للرئيس مبارك. وكان سليمان الوريث الظاهر للرئيس من تعيينه نائباً للرئيس في 29 كانون الثاني حتى 5 شباط، عندما فشلت محاولة اغتيال ضده (محاولة تم تنفيذها على الأرجح من قبل عناصر من الجيش). ولم يُشاهد الرجل منذ رحيل مبارك (الذي كان هو من أعلن عنه)، عدا زيارته الى مكة عندما اجتمع بولي العهد السعودي الأمير نايف.
أما خليفة سليمان فهو أحد نوابه السابقين، مراد موافي، جندي عريق وسياسي محنك في الوساطة المصرية في الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. وكان موافي عضواً كاملاً في المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويلعب دوراً أساسياً هناك إلى جانب “الجنرالات الثلاثة الكبار” الذين يُعتقد بأنهم يديرون الهيئة: طنطاوي، رئيس أركان القوات المسلحة، سامي عنان وقائد القيادة الوسطى للجيش حسن رويني. ويميل موافي لقيادة المفاوضات مع شخصيات سياسية، في حين أن وكالة الاستخبارات العامة هي المصدر الرئيس للمعلومات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بما فيه التقارير المقدمة للجنرالات التي تذكر تكراراً تلميحات عن مؤامرة خارجية ضد مصر، بحسب مسؤولين خارجيين اجتمعوا مع أعضاء المجلس الأعلى. بمعنى آخر، إن وكالة الاستخبارات العامة هي عين وأذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. فالزمرة المصرية الحاكمة معتمدة بشكل غير عادي على مصدر واحد للمعلومات، مصدر يبدو أنه استولى على الروح المعنوية لوزارة الداخلية وعازم على الثأر من موجوداته. أما محمد إبراهيم، وزير الداخلية الجديد في حكومة الجنزوري، فيشاع أنه قريب من وكالة الاستخبارات العامة.
من الجدير استذكار ما هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أو بالأحرى، ما ليس هو: المجلس الأعلى ليس مقولباً في سلسلة القيادة في القوات المسلحة، ولدى أعضائه درجات تفاعل مختلفة بشكل واسع مع الشؤون المدنية، والتأثير عليها. نصف الهيئة فقط مؤلف من ضباط عسكريين يحتلون أرفع المناصب في الجيش، كقائد سلاح الجو أو البحرية. أما الباقون فهم جنود عريقون متمرسون، مساعدو طنطاوي، بشكل رئيس، الذين يحتلون مناصب رفيعة في وزارة الدفاع (والذين غالباً ما يظهرون على التلفزيون كناطقين رسميين)، أو مسؤولون قادمون من وكالة الاستخبارات العامة أو وكالة الاستخبارات التابعة للجيش (غالباً ما تكون مهنة مقدِّمة للتعيين في وكالة الاستخبارات العامة). أما الطريقة التي يتخذ بها المجلس قراراته، وبُطْئُه المتكرر بالقيام بذلك، والإرباك الذي يسوده (أو المسموح له بالتباطؤ) حول الأسلوب الذي ينبغي به معالجة قضايا أمنية، تحديداً، فكلها أمور غامضة، حتى بمعايير الغموض المعتادة للجيش.
يتنامى في الدوائر المصرية النخبوية، وبين الإخوان المسلمين ووسط عدد متزايد من الناشطين، الهاجس بأن تكون اليد اليمنى للمجلس الأعلى لا تعلم بما تفعله اليد اليسرى. فالمجلس الأعلى الأخرق والمتلعثم سيساعد على توفير تفسير ما لسوء معالجة الجيش المتوقعة للتظاهرات بعد أشهر من بناء شعبيته على امتناعه عن إطلاق النار على المتظاهرين دفاعاً عن نظام مبارك. وفي حين أن عدم الكفاءة تفسير مغرٍ ـ من السهل تصوير الجنرالات كزمرة من العجائز الذين لا يمكن لمسهم ـ فإنه لم يعد كافياً ولا مقنعاً. وبالنسبة إلى كثير من الناشطين، فإن التفسير الرئيس للأحداث الأخيرة هو أن المجلس الأعلى كان في نيته دوماً اللجوء إلى ممارسات نظام مبارك. لكن هذه النظرية أيضاً، لا ترقى للواقع، حيث إن الآليات الداخلية لصنع القرار في المجلس الأعلى، واعتماده على وكالات الاستخبارات التي لديها أجندتها الخاصة والاحتمال ألا يكون الجنرالات جميعاً على نفس الموجة، أمور ينبغي إدخالها كعوامل. وفي الوقت الذي ينحسر فيه المجلس الأعلى عن المسرح في العام 2012 في نهاية المطاف، يمكن للدولة العميقة المدنية ـ العسكرية وتلاعباتها ومناوراتها أن تكون السبب الأعظم للقلق.
(*) ينشر بالتزامن مع “مجموعة الخدمات البحثية”
بقلم إسكندر العمراني 1/1/2012
Middle East Resaerch and Information Project