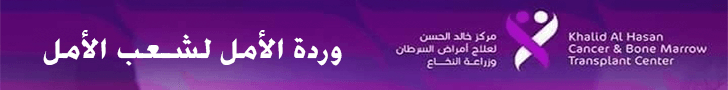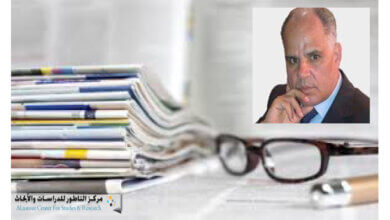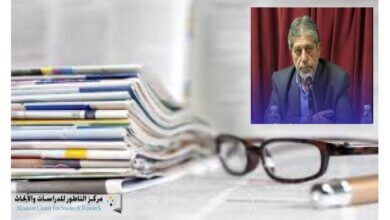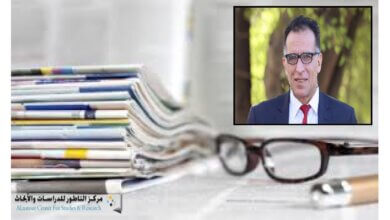عبد المجيد سويلم: تفكّك بنية المشروع الإسرائيلي (المسألة الديموغرافية)

عبد المجيد سويلم 3-11-2025: تفكّك بنية المشروع الإسرائيلي (المسألة الديموغرافية)
عبد المجيد سويلم 30-10-2025: شيءٌ ما يتفكّك في دولة الاحتلال!
قلنا في المقال السابق، إن شيئاً ما يتفكّك في دولة الاحتلال، وقلنا إننا سنبدأ من هذا المقال بمحاولة استظهار ومعالجة مظاهر هذا التفكّك.
إذا جاز لنا أن نعتبر «اتفاق شرم الشيخ» هو بمثابة اتفاق سيُنهي الحرب العدوانية عند درجة معيّنة من انتقاله إلى المرحلتين الثانية والثالثة، وأنه سيؤدّي في نهاية المطاف إلى وقف الإبادة الجماعية بالشكل والوتيرة والوحشية التي سارت عليها حتى بدء وقف إطلاق النار، فإن بالإمكان الاستنتاج أن خطّة الاقتلاع قد فشلت، وأن مسألة التهجير قد تحوّلت إلى خطط فرعية ومتفرّعة، وأنها لم تعد هدفاً قابلاً للتحقيق كما خطّطت لها الإدارة الأميركية، وكما سعت إليها دولة الاحتلال بكل الوسائل والسبل والإجرام المنفلت من كل القيود، وبما تجاوز بصورة جنونية كل أنواع الحدود.
سنبدأ انطلاقاً ممّا تقدّم بمناقشة ومعالجة المسألة الديموغرافية كأحد أشكال تجلّي تفكك بنية الدولة الإسرائيلية، والذي يعني في الواقع تفكّك بنية المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية.
كما هو معروف، فإن المسألة الديموغرافية تمثل مرتكزاً أساسياً من مرتكزات المشروع الصهيوني، ولكونها الرابط العضوي بين مفهومَيّ الاقتلاع والاستيطان، وتمثل آلية الإحلال إستراتيجية منظّمة في إطار هذا المرتكز.
هناك كما هو معروف، أيضاً، مئات الكتب والدراسات والمقالات والتحقيقات التي عالجت المسألة الديموغرافية، ناهيكم عن كم هائل من المعلومات والمعطيات السرّية وشبه السرّية التي يتم تقديمها للمستويات السياسية والمؤسّسات المختصة على هيئة تقارير خاصة محدودة التداول في دولة الاحتلال.
الأمر الذي يهمّنا هو جديد هذه المسألة من حيث وتيرة تعمّق المأزق الإسرائيلي، ومن حيث الأبعاد الكمّية والنوعية لهذا المأزق، ومن حيث تحوّله من الطابع المتأرجح، صعوداً أو هبوطاً إلى الطابع النوعي الجديد، والذي أصبح اتجاهاً بعد أن كان مجرّد تردّدات نزعاتيّة، أو مجرّد تذبذبات في الهوّة ما بين الهجرة إلى الكيان والهجرة منه، أو ما تسمّى الهجرة المعاكسة.
يمكن الإشارة، وبدرجةٍ عالية من الثقة واليقين، إلى أن هذا التحول قد بات واقعاً مكرّساً سيصعب أن تتم العودة به إلى ما كان عليه الأمر قبل «طوفان الأقصى».
وحسب تقارير رسمية إسرائيلية، أفصحت عنها «لجنة الهجرة» في الكنيست، فإن الهوّة ما بين القادمين الجُدد، وما بين المغادرين بلا عودة قد تجاوزت الـ 150,000، وأن هذه الهوّة الكبيرة، بل والهائلة هي ظاهرة جديدة وغير مسبوقة.
تحوّلت الأرقام الحقيقية، وبمعزل عن «إفصاح» اللجنة إلى أحجية تتضارب من خلالها الأرقام الحقيقية، وتثير جدلاً يؤشّر على أن الأرقام الحقيقية، وليس التقارير الرسمية قد أصبحت من أهم «أسرار الدولة»، وأنها قد بلغت من الخطورة ومن الحساسية ما يجعلها أقرب من حيث تأثيرها على معنويات الجمهور الإسرائيلي أقرب إلى التهديد «القومي»، أو إلى تهديد مباشر لأحد أهم مرتكزات المشروع الصهيوني في واقع دولة الاحتلال.
هذا من حيث الهوّة فقط، أي أن الذين غادروا دولة الاحتلال باتوا أكثر بـ 150,000 عن الذين وفدوا إليها، وهذا يعني أن هذه الهوّة الهائلة بالأرقام الرسمية قد تكون أكبر بكثير إذا ما أخذنا بعين الاعتبار «الإخفاء» الرسمي لهذه الأرقام ارتباطاً بما أشرنا إليه من اعتبارات التأثير المعنوي الخطير على الجمهور ومسألة التهديد والتحدّي الذي تمثله هذه الهوّة. أما فيما يتعلق بالأبعاد الكمّية والنوعية للمغادرين والقادمين، فإن للمسألة أهمية كبيرة وخاصة.
تفيد بعض المعطيات بأن المغادرين بلا عودة هم من فئة الشباب، وأن الغالبية منهم هم من أكثر القطاعات تأهيلاً بشكل عام، وتتركّز هذه الأغلبية في القطاعات الاقتصادية الريادية، وفي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة أكثر تحديداً.
مغادرة عشرات آلاف الشباب عالي التأهيل يعتبر نزفاً بشرياً واقتصادياً هائلاً بكل المقاييس، خصوصاً أن هذه المغادرة تؤدّي بصورة مباشرة إلى هجرة الاستثمارات التي كان يعمل فيها هؤلاء الشباب.
والحقيقة على هذا الصعيد أن الحديث يدور عن كارثة سياسية واقتصادية على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي من حيث الميزات النسبية النوعية لهذا الاقتصاد، وهي ضربة كبيرة لقوة الجذب الذي كانت تتمتّع بها دولة الاحتلال على هذا الصعيد.
وتتمثّل هذه الكارثة، وتتجلّى على هيئة مأساة حقيقية عندما نقارن ما بين كمية «القادمين الجدد»، ونوعية مستوى تأهيل هؤلاء القادمين، وطبيعة الأعمال التي يمكن أن يزاولوها.
إذ تفيد المعطيات هنا بأن الغالبية منهم هم من الفئات المتديّنة، وأن الأعمال التي يمكن أن يزاولوها هي الأعمال البسيطة والهامشية، وربما كانت – وهذا هو الأرجح ــ يفضلون الالتحاق بالمدارس والمعاهد الدينية لممارسة «الصلوات»، والتهرّب من الخدمة في الجيش، والتحوّل إلى أعباء وعالات على موازنة دولة الاحتلال.
فبين أن تفقد دولة الاحتلال فئاتها الأكثر تأهيلاً، وتستقبل بدلاً منهم فئات طفيلية تعيش وتعتاش على موازنة الدولة دون مقابل أو مردود، يصبح الوجه الكارثي والمأساوي لهذه الهجرة شديد الوضوح.
لا يقتصر الأمر على كل هذا فقط، لأن المسألة ستنعكس بكل تأكيد على القدرة التعبوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي يعاني كما هو معلن ومعروف من نقص حادّ في مجال موارده البشرية. كما أن التحاق فئات واسعة من هؤلاء «الوافدين الجُدد» بالمدارس الدينية، وبالأعمال البسيطة والهامشية سيفاقم من «أزمة الحريديم»، في الدولة والمجتمع الإسرائيلي، والتي هي أصلاً متفاقمة، وقابلة للانفجار الواسع في أي لحظة قادمة.
وتزداد قتامة المشهد الإسرائيلي عندما تدرك أن جنود الاحتياط في جيش الاحتلال هم في وضع تعبوي سيئ للغاية حسب المعطيات الرسمية الإسرائيلية نفسها.
وفي هذا الإطار، أيضاً، فإن المعطيات الأخيرة، التي نُشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول عدم تمكن ما يقارب الـ 50% من جنود الاحتياط الذين «خدموا» في الجيش أثناء هذه الحرب الهمجية، العودة إلى أعمالهم بصورة سلسة أو طبيعية، إضافة إلى بروز حالات حادّة وشديدة من الانعزال والاكتئاب والشعور باليأس والإحباط، ودرجات خطرة من الوساوس، ونوبات من التوتّر الحادّ بسبب عدم القدرة على التواصل مع محيط العمل والأسرة والعلاقات السابقة على الحرب العدوانية.
وإذا أضفنا إلى ذلك كلّه بدء نضوب «الوعاء» اليهودي لهذه الهجرة، وبروز منظّمات يهودية على مستوى العالم كلّه منادية بالتنصّل الكامل من حرب الإبادة التي تشّنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، خاصة في البلدان الغربية، وخصوصاً تيار [ليس باسمنا]، بل والشجاعة العالية في تصدر هذه المنظمات الانتفاضة العالمية التي ترفع عالياً شعار الحرّية لفلسطين، إنّما ينذر بأوجه جديدة من مأساوية وقتامة المشهد الذي يعيشه الكيان الكولونيالي.
ليس واضحاً بعد كيف ستتصرّف دولة الاحتلال بهذه الأزمة المتفاقمة، ويبدو أن قطاعات معيّنة من «اليمين الفاشي» مرتاحة لنوعية هؤلاء «القادمين» لما يمكن أن يمثّلوه من «قطيع» لها، كما يبدو أن الفئات المهاجرة من دولة الاحتلال لا تُقلق الفئات الأكثر رجعية من هذا «اليمين» كونها أقرب إلى «العلمانية» منها إلى «الصهيونية الدينية».
المسألة الديموغرافية، ثم إلى إستراتيجية تحويل الحياة في قطاع غزّة إلى مستحيل اجتماعي «لتحفيز» التهجير والاقتلاع، ويستمرّون على نفس النهج في الضفة الغربية، وهم ما زالوا يراهنون على إبقاء الفصل بين الضفة والقطاع للتخفيف من وطأة المسألة الديموغرافية. لكن دون جدوى حقيقية حتى الآن.
فهل أدّت هذه الحرب إلى تهجير معاكس؟ وهل بات التهجير معضلة إسرائيلية أكثر ممّا هي معضلة فلسطينية؟ هل انقلب السّحر على السّاحر؟