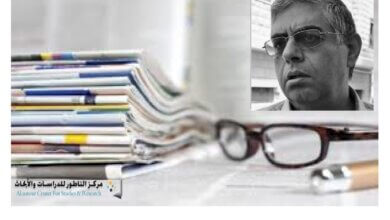عبد المجيد سويلم: تفكّك الخيار النووي الإسرائيلي!

من بين المسائل، غير الرائجة، وغير المطروقة، وربما غير المطروحة من حيث المبدأ مسألة الخيار النووي الإسرائيلي في ضوء تبعات الصراع في الإقليم بعد سنتين كاملتين من الحرب الإبادية.
ويعود السبب في ذلك إلى أن الملف النووي الإسرائيلي ما زال يلفّه الغموض الذي نعرف دوافعه وأبعاده لجهة تعمّد الإبقاء عليه على هذه الشاكلة «المريحة» لدولة الاحتلال.
من بين ثنايا هذا الغموض يمكننا تسجيل الملاحظات الأساسية الآتية:
1- هي أن هناك ما يكفي من المبالغات، ومن سوء التقديرات ومن الاستنتاجات المتسرّعة أحياناً، والسطحية في أحيانٍ أخرى.
2- هي، وبصرف النظر عن هذا الغموض، فإن صعود الفاشية في دولة الاحتلال، وما وصلت إليه الأزمة الداخلية الإسرائيلية من تفاقم، وما قاد إليه الإخفاق الإسرائيلي جرّاء هذه الحرب الهمجية من رواج حول «التهديدات الوجودية»، التي باتت مطروحة في سوق التداول السياسي.. فقد تحوّل الردع النووي الإسرائيلي من سلاح مطروح للردع أساساً، كما هو الحال في كل البلدان النووية إلى خيارٍ قابلٍ للاستخدام في حالات معيّنة، سنأتي عليها في سياق هذا المقال، وبذلك يمكن القول إن ما قامت به دولة الاحتلال من إبادة جماعية وتجويعية في قطاع غزّة قد يتحوّل إلى الشكل النووي من هذه الإبادة عند درجة معيّنة من ازدياد منسوب وضغط عامل «التهديد» من جهة، ومن تفاقم الأزمة الداخلية من جهة أخرى، وخصوصاً إذا ما لجأ «اليمين الكهاني» إليه كخيار «لدرء» خطر خسارته لمستقبله السياسي كلّه، أو لجهة ما يمكن أن تصل إليه ذهنية هذا «اليمين الفاشي» من تصوّرات «شمشونية» تحت غطاء الأيديولوجيا المتطرّفة والعنصرية، وبدوافع مباشرة منها.
3- هي أن السباق النووي في العالم، وفي الشرق الأوسط قد دخل في العقود الأخيرة في مرحلة جديدة عنوانها الرئيس أن الاتجاه العام المؤكّد فيها استحالة أن تبقى دولة الاحتلال في موقع الاحتكار الخاص لملكية هذا السلاح، وصعوبة المنع الكلّي لامتلاكه من قبل دول أخرى بعد باكستان، بما في ذلك امتلاك مصر والعربية السعودية له، أو امتلاك المعرفة التكنولوجية التي هي بمثابة الطريق المباشر الذي يمكّن أصحابه من صناعة القنبلة الذرية، أو الرؤوس النووية.
في ضوء ذلك كلّه يطرح سؤال حول التحوّل من الردع إلى الاستخدام، كما يطرح فيما إذا كان ذلك قد بات ممكناً أم لا، وبالتالي يصبح تفكّك هذه «القوة» الإسرائيلية من عدمها مسألة من صميم حالة التفكّك الجارية.
لماذا تصبح مسألة تفكّك الخيار النووي الإسرائيلي مسألة مصيرية وحاسمة في تطوّر الصراعات في كامل الإقليم على هذه الدرجة من الأهمية؟
ولماذا يضاف هذا التفكّك إلى السلسلة التي حاولنا أن نعالجها على مدار عدة مقالات سبقت هذا المقال حول ماهيّة التفكّك الذي يبدو أن هناك ما يشبه الإجماع حول جوانبه المتعدّدة، وحول فحواه، وحول مظاهره الرئيسة؟
قبل كل شيء فإن هذه الأهمية تأتي من كونها نقطة «تفوّق» إسرائيلية من زاوية حصرية امتلاك الدولة العبرية لهذا السلاح، على الأقل من زاوية المعلن باستثناء باكستان.
كما أن هذه الأهمية في كون المنشآت النووية الإسرائيلية لا تخضع لأيّ شكل من أشكال الرقابة.
والمشكلة هنا لها شق يتعلق بعدم اعتراف إسرائيل الرسمي بوجود هذا السلاح، ما «يعفيها» مبدئياً من الرقابة والإشراف الدولي على هذه المنشآت، كما يتعلق الأمر بالحماية «الغربية» لهذا الغموض الإسرائيلي، والحماية من التفتيش عليها، ومن التوقيع على الاتفاقيات المنظّمة لوجود السلاح النووي، وتخزينه، والرقابة على انتشاره، أيضاً.
وكما هو معروف فقد ساعدت، وربما أنشأت فرنسا المفاعل النووي الإسرائيلي في «ديمونا» بدءاً من نهاية خمسينيات القرن الماضي، وتعاونت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا مع الدولة العبرية في مدّها بتقنيات معيّنة في تخصيب اليورانيوم المطلوب لصناعة القنبلة النووية، والرؤوس النووية بعد ذلك، ما أوصلها إلى مرحلة «الإنجاز» بالتعاون مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا آنذاك. أما طبيعة هذا الإنجاز فليست محدّدة بصورة دقيقة بعد، لكن المؤكد أن هذا الإنجاز قد وصل إلى امتلاك دولة الاحتلال لعشرات من الرؤوس النووية.
هناك أوساط «مختصّة» تعتبر أن التقديرات بامتلاكها لمئات من هذه الرؤوس هي أمر مبالغ فيه لجهة أن صيانة هذه الرؤوس هي مسألة مكلفة للغاية، وأن «الحاجة» الإسرائيلية هي مسألة فائضة عن الضرورة العملية لها، وأن السلاح النووي الإسرائيلي وحتى سنين قليلة مضت لم يكن في حالة سباق مباشر مع دول الإقليم، ومع الدول المحيطة بها على وجه الخصوص والتحديد.
كما أن هذه الأوساط نفسها ترى أن استخدام السلاح النووي هو أمر متعذّر في منطقة الإقليم المحيط مباشرة بدولة الاحتلال بسبب مخاطر التلوّث والإصابة المباشرة التي يمكن أن تنتج عن استخدامه.
وترى هذه الأوساط أن دولة الاحتلال وللأسباب الآنفة الذكر ربما أن إستراتيجيتها لاستخدام السلاح النووي في «بلدان الطوق» أو المحيط المباشر تقوم على استخدام قنابل نووية صغيرة أو متوسطة، حسب حجم المساحة المستهدفة، والتي تصل في قوتها التدميرية إلى تدمير مدينة متوسّطة، بحجم حلب أو حمص، على سبيل المثال، أو أقل من ذلك حسب متطلّبات العمليات، في حين ترى هذه الأوساط أن الرؤوس النووية الكبيرة، أو القنابل النووية الكبيرة، يكاد ينحصر استخدامها لأهداف بعيدة عن الجغرافيا «الإسرائيلية».
أكاد أجزم بأن كل هذه التقديرات أصبحت الآن خارج نطاق التوقّعات الجدّية لأن استخدام السلاح النووي لم يعد يرتبط بهذه الاعتبارات «الفنّية» فقط، لأن استخدام مثل هذا السلاح، بصرف النظر عن نطاق ومجال هذا الاستخدام، وبصرف النظر عن كل الاعتبارات العملانية قد أصبح التقدير بشأنها هو في مكان آخر من هذه الاعتبارات.
الذي أراه هنا، أن المسألة على علاقة مباشرة بصناعات الدفاع الجوّي، وصناعة الصواريخ الدقيقة، وحجم امتلاكها من قبل بعض بلدان الإقليم، وخصوصاً من قبل الدول التي ترى دولة الاحتلال فيها دولاً وبلداناً معادية، وتشكّل، أو يمكن أن تشكّل تهديداً محتملاً لها.
ويتّصل الأمر هنا، أن الحرب العدوانية الأخيرة قد أثبتت أن التفوّق الجوّي الحربي الإسرائيلي قد تم كسره جزئياً على الأقل، وثبت أن الأجواء الإسرائيلية قد تمت استباحتها من قبل الصواريخ الإيرانية الدقيقة، على الأقل، ما أدّى إلى نوعٍ من التوازن الذي لم تكن دولة الاحتلال لتتصوّر حدوثه ولا حتى في أسوأ كوابيسها.
لم يعد هناك تفوّق إسرائيلي يمنع وصول أسلحة دمار شامل غير محدّدة، وربما غير معروفة إلى دولة الاحتلال، وبالتالي لم يعد استخدام السلاح النووي متاحاً دون أن تعرّض الأخيرة نفسها لأخطار غير تقليدية قد لا تكون أقلّ خطورة من استخدامها للسلاح النووي، إذا كان الأمر يتعلق بالأسلحة النووية التكتيكية، أو محدودة الفعالية والانتشار.
هذا كلّه من جهة، أما من جهة أخرى فإن ما أدّت إليه هذه الحرب العدوانية من سيطرة للإدارة الأميركية على المقاليد الرئيسة للقرار الإسرائيلي في كل المجالات الإستراتيجية بات موضوعياً يقلّص من هوامش الاعتبارات «الشمشونية» لدى مهووسي الأيديولوجيا الصهيونية في شقّيها القومي والديني على حدّ سواء.
ولكل هذه الأسباب فإن أميركا باتت ترى في الخيارات المتهوّرة لـ»الشمشونيات الجديدة» في الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وفي «الائتلاف اليميني الفاشي» الذي يحميها ويبقيها «صامدة» حتى الآن خطراً على خطط أميركا، وعلى مصالحها العليا، وعلى إستراتيجيتها في التحكّم بالإقليم، وفي الهيمنة عليه، خصوصاً أن هذا الإقليم بالذات، وأكثر من أيّ إقليم آخر على مستوى العالم كله هو بمثابة القلعة الأميركية الأخيرة، والحصن الذي ما زالت الأخيرة تراه، وتتعامل معه كحصن منيع في إبقاء مكانتها ودورها في موقع التحكّم والسيطرة.
وإذا كان البعض يرى أن حالة الفوضى التي يمكن أن تنتهي إليها الأزمة الداخلية الإسرائيلية «فرصة» «الشمشونية السياسية الجديدة» في دولة الاحتلال، فإن الواقع الماثل أمامنا اليوم لا يزكّي مثل هذا الرأي.
لقد ضربت هذه الحرب البربرية عميقاً في أساسات الرؤى والإستراتيجيات الصهيونية، وأصابت البنى والهياكل والمفاصل الكبرى في إستراتيجيات المشروع الصهيوني، وبما طال دولة الكيان والمجتمع و»الأمن القومي»، وبما وضعه من حدّ لكل دوائر وحلقات «التفوّق» التي كانت عناوين رئيسة للدور والمكانة الإسرائيلية في هذا الإقليم، وبذلك نختتم مقالات الفكّ والتفكيك التي أدّت لها هذه الحرب العدوانية، وأظنّ أنه سيسجّل لـ»طوفان الأقصى» الفضل الأكبر في هذا كلّه.