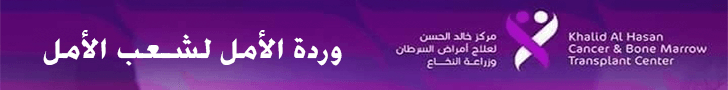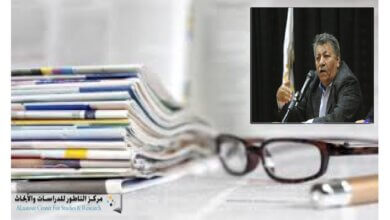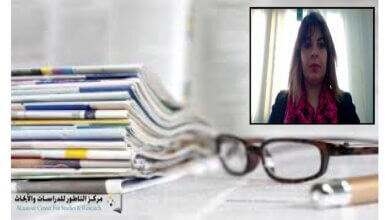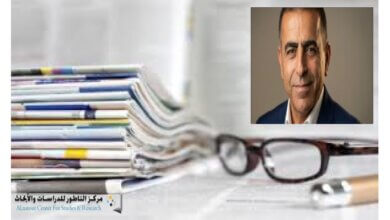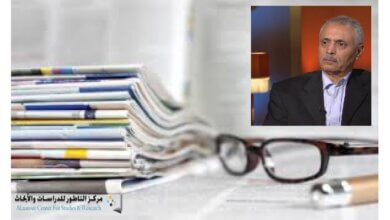عبد الغني سلامة: أسئلة ما بعد الحرب: سمات المقاومة الإسلامية (١من٢)

عبد الغني سلامة 3-11-2025: أسئلة ما بعد الحرب: سمات المقاومة الإسلامية (١من٢)
لنبدأ بالاسم؛ الاسم يختصر الدلالات، ويبرز المحتوى والهدف؛ فأسماء الأحزاب والحركات (خلافا لأسماء الناس) يجري انتقاؤها بعناية لتعكس هويتها وتوجهاتها وطبيعتها.. حركة المقاومة الإسلامية، الجهاد الإسلامي، «حزب الله» – المقاومة الإسلامية.. لا وجود لأي اسم أو مقطع يدل على البعد الوطني، أو ارتباط الحركة بالوطن، وإن وُجد فلا يعني سوى محل الإقامة.. هذا أولاً.
ثانيا: هذه الحركات ذات صبغة دينية، في التوجهات، والمنطلقات، والأهداف، والأيديولوجيا، وتعتمد أساليبها وفق فهمها للتراث الديني، وتتبنى العقيدة العسكرية الدينية، وترفع شعارات: «هذا جهاد، نصر أو استشهاد»، «الله غايتنا».. والجهاد يعني القتال ضد الكفار، وبالتالي تكون المسألة الدينية هي جوهر الصراع.. وهذا كله وبمجمله يختلف عن نهج وأساليب وغايات حركات التحرر الوطني.. وهنا لا أجري مقارنة لتحديد أيهما أفضل، وأيهما يمثل الحق، وأيهما على الباطل.. هما نهجان منفصلان متغايران تقريبا في كل شيء، ويؤديان إلى نتائج مختلفة.
ثالثاً: لا تقبل الحركات الإسلامية الشراكة مع أي جهة، حتى لو كانت إسلامية تنافسها على احتكار الدين، فهي ترى نفسها ممثلة للإسلام، تمتلك الحقيقة المطلقة والجواب النهائي.. وإذا اضطرت للتحالف مع جهة ما، فيكون تحالفا مصلحيا ظرفيا ومؤقتا، بحيث تكون تحت جناحها وفي ظلها ومجرد ديكور لأغراض دعائية، ستتخلى عنها بمجرد امتلاكها القوة والسيطرة.
رابعا: لا تخفي الحركات الإسلامية جوهرها الديني، بيد أنها بدأت في الآونة الأخيرة تطرح نفسها بوصفها حركات تحرر وطني، وفي هذا نوع من الخلط؛ حركات التحرر الوطني غايتها تحرير الأرض، ونيل الاستقلال السياسي، والتحرر من الاحتلال، ومناهضة الظلم ورد العدوان، وتحقيق الحرية، والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية.. قد تلتقي مع حركات الإسلام السياسي في مسألة مقاومة الاحتلال ورفع السلاح، ولكن بعد التحرر من الاحتلال، وأثناء النضال في سبيله لكل فريقٍ نهجه وغاياته المختلفة، وأحيانا المتناقضة خاصة في مواضيع طبيعة الحكم، وهوية المجتمع، والأولويات، والديمقراطية، وتداول السلطة، ومفهوم العدالة، والحريات الشخصية، ومكونات المجتمع (الأقليات والطوائف)، والتعددية السياسية والحزبية، وحرية التدين، ونظام الأحوال الشخصية، والمرأة، والنظام الاقتصادي.. فالحركات الدينية تريد إما استعادة الخلافة، أو إقامة دولة دينية ومجتمعات إسلامية، بحيث تفرض منظومتها الفقهية والأيديولوجية على الجميع.
ويشمل الاختلاف أيضا أساليب المقاومة وأدواتها، ونظرتها للمجتمع ومكانة الإنسان، وهذا سنناقشه بتفصيلات أكثر لاحقا.
في الشأن السياسي، ثبت أنه لا توجد فروقات كبيرة وجوهرية بين الفريقين؛ فقد أبدت الحركات الإسلامية التي وصلت سدة الحكم أو سيطرت على منطقة ما الكثير من البراغماتية والمرونة، ربما ما يتخطى الحركات الوطنية، فعندما تسلم الإخوان حكم مصر قاموا بتثبيت «كامب ديفيد»، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وتعهدوا باحترام جميع اتفاقات مصر الخارجية، وخاصة العلاقة مع أميركا، واتبعوا الآلية ذاتها مع البنك الدولي، في المغرب، تحالفوا مع القصر بشأن موضوع التطبيع، في تونس، تبنى حزب النهضة خطابا براغماتيا، في قطر، تحالف مكشوف، في سورية، أبدى الجولاني مرونة فائقة إزاء إسرائيل وأميركا وروسيا بخطاب سياسي براغماتي لا يختلف عن أي نظام عربي، في فلسطين، وافقت «حماس» على كل ما كانت تختلف بشأنه مع منظمة التحرير بما في ذلك المفاوضات، والتسوية السياسية والدولة الفلسطينية على حدود الـ67.
خامساً: طبيعة الحركة وهيكليتها؛ الحركات الإسلامية ليست ذات صبغة دينية وحسب، بل هي في جوهرها طائفية، أو هي تكتل متجانس من نفس الطائفة، حتى لو ادعت غير ذلك، أو قالت، إنها تنبذ الطائفية، فمثلا التشيع والولاء للولي الفقيه واضح لدى «حزب الله»، في احتفالاته وشعاراته وأيقوناته، وكذلك «حماس» (السنية) وإن بدرجة أقل حدة ووضوح، لكن من شبه المستحيل أن تجد قائدا أو كادرا متقدما أو حتى عنصرا في أي حركة من خارج طائفتها، أو من دين آخر. وبنفس المستوى فإن أي حركة إسلامية لن تضم في صفوفها ممن لا يعتنقون مبادئها وأيديولوجيتها وعقيدتها الدينية.. وهنا لا أتحدث عن الأنصار والمؤيدين من خارج الحركة، أو القريبين منها، الذين يتخذون مواقفهم المؤيدة والداعمة بناء على ما يرونه من ممارسة تلك الحركات للمقاومة في وجه الاحتلال، فالتأييد يكون هنا لفعل المقاومة، وليس لمبدأ الحركة وعقيدتها. ولا أتحدث عن التحالفات السياسية والحزبية، فمثلا تحالف «حزب الله» مع قوى مسيحية، وتحالفت «حماس» مع الجبهة الشعبية.. مثل هذه التحالفات قد تكون لأغراض سياسية، أو لخوض انتخابات، أو في إطار الصراعات الداخلية في البلد.. وهذا شأن آخر.
بينما نجد في الحركات الوطنية (فتح مثلا) أنها تضم قيادات وكوادر وعناصر ومنتسبين ومؤيدين من كافة الشرائح والطبقات والفئات الاجتماعية ومن مختلف الطوائف والأديان، والجنسيات، والتوجهات الفكرية والسياسية، يساريين ويمينيين ومتدينين واشتراكيين وعلمانيين.
والفكرة هنا ليست مفاضلة، بقدر ما هي تبيان لأوجه الاختلاف والتشابه.
سادساً: مفهوم الوطن والشعب والقومية.. معظم حركات الإسلام السياسي تنظر إلى «الوطن»، و»الشعب» من منظور ديني أوسع يتجاوز الحدود الجغرافية؛ «الوطن هو حيث يسود شرع الله»، الهوية الأساسية للفرد والجماعة هي الهوية الإسلامية، وهي فوق القومية والوطنية، ولا تعترف بالانتماءات الأخرى، الانتماء الأول هو للأمة الإسلامية لا للدولة القُطرية، والمسلم ينتمي إلى «دار الإسلام» وهي محتملة في أي مكان في العالم. السلفيون لا يعطون للوطن بعداً سياسياً، بل يعتبرونه مجرد مكان إقامة، أما الحركات الجهادية فترفض الحدود القُطرية تماما، وتراها «قيودا استعمارية»، وتدعو إلى وحدة الأمة تحت «نظام الخلافة»، الاتجاهات الحديثة داخل الإسلام السياسي بدأت تتطور بعد تجارب الحكم (الأردن، تونس، المغرب، تركيا)، حيث حاولت توطين نفسها بخطاب جديد يعترف بشرعية الدولة.
في تصريح لمرشد الإخوان السابق مهدي عاكف قال، «طز في مصر»، وهي ليست مجرد عبارة انفعالية بقدر ما هي تعبير عن الموقف العام للجماعة من مصر. وفي اجتماع مغلق لكوادر «حماس» قال القيادي محمود الزهار، «فلسطين بالنسبة لنا مجرد نكاشة أسنان»، «لا تظهر على الخارطة»، «مشروعنا أكبر بكثير من فلسطين»، «العلم الوطني مجرد خرقة بالية»..
سنناقش تاليا كيف صادرت مصطلح المقاومة واحتكرته، وأسلوبها في ممارسته، وطبيعة تحالفاتها السياسية.