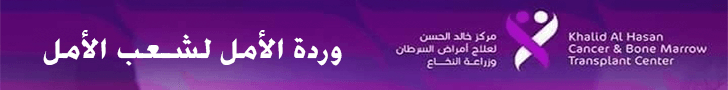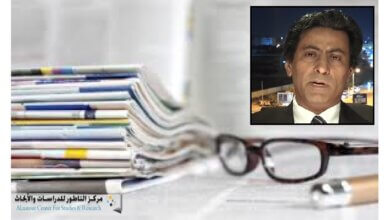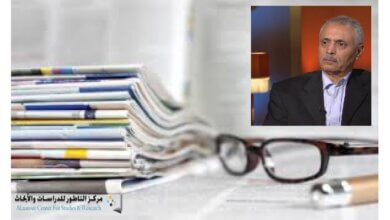د. محمد أبو رمان: إعادة اختراع غزّة… اجترار الأوهام الأميركية

د. محمد أبو رمان 18-11-2025: إعادة اختراع غزّة… اجترار الأوهام الأميركية
منذ اللحظة الأولى، كان من الواضح أن الخطة الأميركية لإدارة غزّة بعد الحرب الأخيرة ليست مجرّد مُقترَح تقني لإعادة الإعمار أو إدارة مناطق محدّدة. فهي، كما تكشف الوثائق التي تناولتها الصحافة الغربية، محاولة أميركية لإعادة إنتاج تصوّر سياسي وأمني للمستقبل، في مساحة تتقاطع فيها خطوط التوتر كلّها: هواجس إسرائيل الأمنية، والانهيار الإنساني العميق، والانقسام الفلسطيني الداخلي، والتنافس الإقليمي، وغياب أي قدرة أميركية على التحكّم المطلق بما يحدث على الأرض. هذا المزيج من المعطيات يجعل أي خطّة تبدو، حتى قبل أن تُنفَّذ، أشبه بمحاولة “شراء الوقت” أكثر ممّا هي مشروع حلٍّ حقيقي. وما كشفه تقرير صحيفة الغارديان، بعنوان “مخطّط الجيش الأميركي لتقسيم غزّة مع (منطقة خضراء) مؤمَّنة بقوات دولية وإسرائيلية” (14/11/2025)، من وثائق “المنطقة الخضراء” و”ASC”، لا يقدّم تفاصيل عملياتية فقط، بل يقدّم نافذة حقيقية على حجم الشكوك الأميركية في قدرة أي دولة، حتى الأقوى، على رسم مستقبل غزّة بيقين كامل.
تُظهر الوثائق بوضوح أن الإدارة الأميركية لا تعرف تحديداً ماذا سيكون شكل القطاع بعد سنوات قليلة. فهي تتحرّك بين تصورات متناقضة؛ من فكرة المجتمعات الآمنة البديلة (ASC)، التي كانت مخصّصة لمجموعات صغيرة من الفلسطينيين مساحاتٍ محصورة لتجربة نموذج حكم شبه مستقل، إلى التخلّي عنها بالكامل، والعودة إلى تصوّر المنطقة الخضراء التقليدي، كما ظهر في بغداد بعد 2003. ما يكشفه هذا التنقّل هو أن الخطّة ليست مبنية على معرفة دقيقة بالواقع الغزّي، بل على افتراضات مسبقة، وأحياناً على أوهام سياسية حاولت واشنطن تطبيقها سابقاً في العراق وأفغانستان، قبل أن تكتشف أن الواقع الاجتماعي والسياسي أقوى وأكثر تعقيداً من أي رسم هندسي أو خطّة أمنية.
منذ 2007، بعد سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على القطاع، برز في التفكير الغربي والإسرائيلي نموذجان افتراضيان: غزّة الطالبانية مقابل الضفة الليبرالية الديمقراطية. وقد بُنيت آنذاك توقّعات كبيرة على هذا التصوّر؛ أن يقارن الفلسطينيون بين نموذجَيْن سياسيَّيْن، ثمّ يختارون بوعي الجماعة “النموذج المعتدل”، وأن الزمن سيعمل لمصلحة السلطة الفلسطينية في الضفة. لكن الواقع أظهر أن هذه المقاربة كانت ساذجةً، فلم يُنتج الانقسام نموذجَيْن متوازيَيْن، بل حالة واحدة من الانقسام العميق، لم تُنهِ حكم “حماس”، ولم تؤدِّ إلى ولادة أي بديل سياسي ملموس. واليوم، تكرّر الإدارة الأميركية الفكرة نفسها ولكن بصياغة جديدة: “غزّتان” في جنوب القطاع كما عند تقسيم برلين سابقاً، واحدة خضراء آمنة تحت إشراف دولي، وأخرى حمراء مفتوحة على التوتّر والصراع، كأنَّ الخطّة تفرض، من خلال خطوط في الخريطة، واقعاً اجتماعياً لا يمتلك السكّان القدرة على تغييره.
يعكس هذا التوجّه أيضاً محاولة أميركية للمواءمة مع التصوّرات الإسرائيلية، بما في ذلك صياغات جاريد كوشنر السابقة، التي ركّزت على إنشاء “مراكز حكم آمنة” داخل القطاع، تُدار بوجوه محلية غير حزبية، وخاضعة لرقابة صارمة، وتُعزَل عن الفصائل المسلّحة. ولعلّ اللافت أن هذا التوجّه يكرّر تجربة الإدارة الأميركية في العراق وأفغانستان: خلق قوى محلّيةٍ، غير متّصلة بالسلطة، وغير مؤهلة سياسياً، يُفترض أن تنتج الاستقرار، بينما الواقع أظهر أن مثل هذه القوى عاجزة عن فرض النظام، وأنها غالباً ما تصبح أدوات صراعات محلّية، أو فشلاً مؤسّسياً.
من الواضح أن واشنطن تدرك أن إسرائيل غير قادرة على إنتاج نموذج مستدام لما بعد الحرب، وأن الحكومة الإسرائيلية نفسها تواجه قيوداً سياسية داخلية، لذلك تبدو الخطّة الأميركية أكثر تحايلاً سياسياً منها مشروعاً حقيقياً، فهي تهدف إلى إدارة “الفجوة” أكثر ممّا تهدف إلى بناء نظام قادر على الصمود. الولايات المتحدة تحاول بذلك منع الانفجار، وشراء الوقت، وإعطاء إسرائيل ما تعتبره ضماناتٍ أمنيةً، من دون أن تضطر إلى إعادة الإعمار أو مواجهة التكاليف السياسية والإنسانية المباشرة.
ثمّة تناقض جذري في الخطّة. فهي تعتمد على فرضية أن المجتمع الغزّي سيقبل صيغة أمنية بلا شرعية سياسية، وأن قوة محلية جديدة يمكنها الحفاظ على النظام ومنع الفوضى، من دون أن تمتلك سلطة حقيقية أو قاعدة اجتماعية. كما تفترض أن إسرائيل لن تتدخّل مباشرة لتعديل الواقع، وأن الفاعلين الإقليميين سيكتفون بالمراقبة. هذه الافتراضات كلّها تجعل من الخطّة، حتى قبل تنفيذها، مشروع إدارة أزمة أكثر منها مشروعاً للحلّ. في جوهرها، تقدم الوثائق مثالاً واضحاً على أزمة المعرفة لدى الإدارة الأميركية: غياب يقين بشأن المستقبل، واعتماد أدوات سبق فشلها في تجارب مشابهة، وفشل في قراءة واقع غزّة المُعقَّد. الولايات المتحدة تبدو وكأنّها تعيد تدوير “حلول مؤقّتة” من الماضي، لكنّها تدرك أن غزّة ليست بغداد ولا كابول، وأن السكّان والأطراف المحلّية لديهم القدرة على إعادة تشكيل الأحداث بطريقة غير متوقّعة.
في الخلاصة، غزّة اليوم تحت إدارة افتراضات أكثر منها تحت إدارة خطّة واضحة، خطّة لا تعرف أين ستقف بعد عام، ولا كيف ستتعامل مع القوى الفعلية على الأرض، ولا كيف ستوازن بين مصالح إسرائيل والأطراف الإقليمية والفلسطينيين أنفسهم. كل شيء في هذه الوثائق يوحي بأن المستقبل في غزّة يبقى مفتوحاً على الاحتمالات كلّها: إمّا أن تتجاوز الوقائع كل التصورات، كما حدث بعد 2007، أو أن يُنتج الواقع نموذجاً جديداً بالكامل، بعيداً عن “غزَّتيْن” أو “منطقة خضراء”، وربّما بعيداً عن الخرائط كلّها التي تصنعها غرف السياسة الدولية.