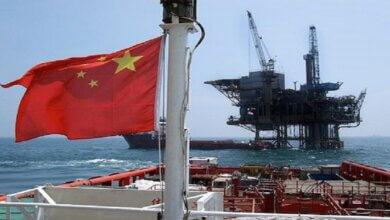د. توفيق أكليمندوس: الأزمة الفرنسية الشاملة

د. توفيق أكليمندوس 12-7-2023: الأزمة الفرنسية الشاملة ٣
(1)

من الصعب تقدير وتقييم مدي جسامة الأزمة الفرنسية الحالية وتوقع مسارها، لاختلاف تحليلات المراقبين ذوي الخبرة الواسعة، هناك اتفاق بل إجماع علي وجود رفض شعبي واسع ومتواصل لقانون اصلاح المعاشات الرافع لسن الخروج إليه، وهو القانون الذي فجرها، ورفض واسع لأسلوب تمريره، إذ هناك مادة في الدستور (المادة ٤٩/٣) تتيح للحكومة أن تقول لمجلس الأمة، إما قبول هذا القانون دون مناقشة وإما اسقاط للحكومة، وطبعا من المتوقع إن تم اسقاط الحكومة أن يقوم الرئيس بحل المجلس وبتنظيم انتخابات تشريعية جديدة وهناك في المعارضة من يخشي العودة إلي الناخبين، فلم يصوت لإسقاط الحكومة رغم اعتراضه علي القانون، الذي مر دون مناقشة كافية ودون تصويت عليه، وهناك أيضا إجماع – قد يكون ظالما- علي أن إدارة الرئيس ماكرون للأزمة اتسمت برعونة باتت معتادة فجاءت أغلب تصريحاته القليلة استفزازية لتزيد من حدة الأزمة، الخلاف في التحليلات يدور حول تحليل الاحتجاجات وأعمال العنف ومسار الأزمة، هناك يري أن المظاهرات حاشدة و”عابرة الطبقات والأجيال” أي جامعة لناس مشاربها واتجاهاتها وأعمارها مختلفة، وهناك من يري أن المليون أو المليون ونصف الذي يتظاهر مكون من نفس الناس وأن الأغلبية العظمي لا تتظاهر، هناك من يري أن الحشد ضعف مع مرور الوقت ومن يري أنه من المبكر القفز إلي استنتاجات حول استمرارية الأزمة أو انتهائها،
هناك من يري أن أعمال العنف المتزايدة تدل علي ازدياد حدة الرفض، وتنامي تطرف المتظاهرين، وهناك من يري أن هذا العنف لا يدل علي أي شيء فعدد المنخرطين في أعمال التخريب والاعتداء علي الشرطة محدود نسبيا لا يزيد عن عشرة ألاف علي أسوأ الفروض، ينتمون كلهم إلي “البلاك بلوك” وإلي تنظيمات أقصي أقصي اليسار وربما أقصي أقصي اليمين، ولا يوجد أي دليل علي تغيير في سلوك الأغلبية الساحقة للمتظاهرين، وهناك من يري أن أعمال العنف تصب في مصلحة الرئيس لأنها تخيف الغالبية الغالبة من المعترضين ومن الشعب وتظهره كممثل الاستقرار والسلام الاجتماعي الحامي للممتلكات والملكية الخاصة، بل الضامن لسلامة المتظاهرين السلميين، وهناك من يحذر من هذا التحليل والتنبؤ، لأن كل استطلاعات الرأي تشير إلي ارتفاع كبير في نسبة من يتفهم العنف ضد الدولة أو يؤيده، أصبح هذا الرأي رأي أغلبية السكان وأغلبية ساحقة من الشباب، ويتهم البعض الإعلام بمنافقة هذا الاتجاه وتغذيته لارتفاع نسبة اليساريين المتطرفين بين العاملين في مجاله، ويشير بعض الخبراء إلي أن الرئيس – علي عادته في مسك العصا من النصف وفي تصوره أن هذا المسلك قمة الذكاء- له تصريحات ومواقف سابقة تدين عنف الشرطة في حين أن الشرطة ضحية مع عدد محدود من الاستثناءات، ويذكر البعض أن الحزب الحاكم مني بهزيمة ساحقة في الانتخابات التي نظمت في دائرة الأسبوع الماضي، وتقول أغلب استطلاعات الرأي أن خيار حل المجلس ليس متاحا للرئيس أو لأحزاب الحكم، فهي تقول أن حزبي التجمع الوطني (حزب مارين لوبن/أقصي اليمين) وفرنسا العصية (حزب ميلانشون/أقصي اليسار) سيحصلون معا علي ٥٢٪ من الأصوات (٢٦٪ لكليهما) ليسبقا التحالف الحاكم (حزب الرئيس وأحزاب مؤيدة له) الذي لا يحصل إلا علي ٢٢٪ من الأصوات، ويعني هذا أن الرئيس مضطر حاليا وفي المستقبل المنظور إلي التعامل مع مجلس أمة لا يملك فيه أنصاره إلا أغلبية نسبية ما لم ينجح في الاتفاق مع حزب معارض، ولا يوجد حاليا ما يشير إلي إمكانية هذا، فالرئيس لا يتمتع بالمرونة الكافية، ولا مصلحة لأي حزب في تقوية رئيس مكروه من الأغلبية الشعبية. لا نقول أن هذا مستحيل إن قدم ماكرون علي غير عادته ما يسمح لحزب معارض أن يزعم أن المكاسب التي حصل عليها تبرر دعم الرئيس.
إصلا المعاشات
وتقتضي الموضوعية أن نقر أن إصلاح المعاشات كان ضروريا نظرا لعجز المنظومة وتطورات التركيبة السكانية مع ارتفاع نسبة المسنين والتحسن الكبير في أحوالهم الصحية وقلة عدد المواليد، وتأخر الإصلاح كثيرا، وإدارة الكوفيد أدت إلي ارتفاع الديون وبلغت حدا مقلقا، وتقتضي ألموضوعية أن نقول أن الأرجح أن الحوار كان سيؤدي إلي تعطيل كبير دون جدوي لأن فكرة رفع سن المعاش مرفوضة رفضا تاما من الجمهور الفرنسي لسبب معلن – الدولة تسرق منا سنتين من عمرنا- ولأسباب أعمق سنتعرض لها لاحقا، أما اللجوء إلي أسلوب التمرير شبه القسري الذي تنظمه أحكام المادة ٤٩/٣ فأمر خلافي يضعف قليلا شرعية القانون الذي تم تمريره بهذا الشكل ولكنني أعتقد أن المجازفة باتباع المسار العادي كانت مخاطرة الرئيس في غني عنها، وكانت ستضعف موقفه التفاوضي مع حزب الجمهوريين فدون تصويت نوابه لن تكون هناك أغلبية توافق علي القانون، وحاليا يعجز الحزب الجمهوري عن فرض انضباط حزبي علي أعضائه وعدد كبير منهم لا مصلحة له في تأييد الرئيس. وأخيرا وليس آخرا أي تراجع جزئي لم يكن ليؤدي إلي تهدئة خصومه بل إلي فقده لتأييد خمس أو ربع الرأي العام الذي يؤيده
من السهل نسبة الأزمة الفرنسية إلي رعونة أحد الأطراف أو تطرف غيره، أو إلي ضعف الثقافة الاقتصادية لبعض فئات المجتمع الفرنسي، أو إلي سوء أداء النخب، أوإلي تدهور الظروف المعيشية للطبقات الشعبية- وقطعا لعبت كل هذه العوامل وغيرها دورا هاما، شأنها شأن تراكم الضغائن والمشاعر السلبية، ولكننا نميل إلي اعتبار الأزمة فصلا جديدا من فصول أزمة شاملة وممتدة وجذورها بالغة العمق، أزمة هي في آن واحد أزمة نظام وأزمة سياسية وأزمة مجتمع وأزمة اقتصاد وأزمة مالية وأزمة ثقافية، أزمة تطرح بقوة سؤال الأفول ويتطلب حلها والعودة إلي انطلاق شروط لا تتوافر حاليا وعندما يسعي أحد أو بعض الفاعلين إلي إيجاد أحدها يعرقلهم غيرهم.
أسباب الأزمة
مظاهر وأسباب الأزمة لا تعد ولا تحصي. تأملوا مثلا شعار الجمهورية: حرية ومساواة وأخوة، لا توجد لا مساواة ولا أخوة، ثقة الرأي العام في نظامه السياسي وفي نخبه وفي الإعلام في تراجع مستمر منذ سنة ١٩٧٤، أداء الرؤساء لا يحظى برضاء الرأي العام ويمكن اعتباره سيئا في أغلب الأحوال، انهار العامود الفقري الضامن لتماسك وتجانس المجتمع، مستوي التعليم فيما يخص اللغة الفرنسية والرياضيات مزري مقارنة بمستواه في بداية القرن العشرين، منظومة الرعاية الصحية في أزمة، تراجعت مساهمة الصناعة في الناتج القومي، الميزان التجاري يعرف عجزا ويعكس تراجعا، انهارت أحزاب الحكم التقليدية (الاشتراكي والجمهوري) وتحصل القوي الشعبوية والمتطرفة علي أكثر من ٦٠٪ من أصوات الناخبين، الأمن الداخلي نراجع ومعدلات الجريمة ترتفع، ديون فرنسا بلغت حد الخطر، الوسائل التقليدية للصعود الاجتماعي في حالة عطب علي أحسن الفروض، الهرم السكاني ينقلب تدريجيا بسبب ضعف معدلات الإنجاب، الحرب الروسية علي أوكرانيا فضحت مستوي الجيوش الأوروبية وتفرض شأنها شأن التهديدات الجديدة في الساحل والصحراء وفي المحيطين الهندي والهادي زيادات ضخمة في الانفاق العسكري، السياسة الخارجية الفرنسية تجد صعوبات في التأقلم ومسار النظام الدولي ولا يوجد إجماع عليها، العضوية في الاتحاد الأوروبي حماية في جوانب عديدة وقيود تشل في جوانب أخري، مثلا الدولة لا تتحكم في سياساتها النقدية، التحول إلي اقتصاد بيئي وتوفير الطاقة تحديات كبيرة، تتعدد الكفاءات الفرنسية والمواهب الرفيعة للطبقات الوسطي ولكن الكثير منها يهاجر والموجود يعجز عن ترجمة قدراته إلي ما يسمح بنهضة كبري، وباستثناء تراجع البطالة وأداء أحسن من المتوقع أثناء أزمة الكوفيد لا توجد مؤشرات إيجابية، رغم وجود إمكانيات بشرية هائلة ونخبة من كبار الموظفين وأخري من المثقفين تثيران الإعجاب شأنهما شأن قطاعات كبيرة من الطبقات الوسطي.
يؤرخ كل محلل بداية الأزمة متأثرا بميوله السياسية ونوعية الملفات التي تهمه، ويمكن القول أن الكل علي حق إلي حد ما وأن التراجع مر بمراحل، وأن التطورات الاجتماعية وأخطاء السياسيين لعبت دورا كبيرا في هذا المسار، اليمين المحافظ سيقول أن التراجع بدأ مع انتفاضة ٦٨ أو قبلها بقليل، انتفاضة ٦٨ هي انقلاب علي الأنماط السلطوية التي توجد في كل العلاقات الاجتماعية – في البيت والجامعة والمدرسة ومحل العمل وأدوار العبادة والشارع – ودعوة إلي توسيع دائرة الحريات دون أي اعتبار لمتطلبات التماسك الاجتماعي والأمن، وقبل الانتفاضة بقليل بدأ تراجع المنظومتين الكاثوليكية والماركسية (كنائس/مقرات الحزب- مدارس- منظمات شبابية- أندية- مطبوعات) التي كانت تضمن نقل الثقافة من جيل إلي آخر وتقوم بالتهذيب، ومنذ هذا التاريخ تتراجع منظومة التعليم من ناحية ويعمل كل السياسيين علي توسيع دائرة الحقوق وهو أمر نراه محمود في حد ذاته ولكنه أثر علي التماسك الاجتماعي وعلي الإحساس بواجبات تجاه الدولة.
وهناك من يري أن الأزمة بدأت ما بين ٧٣/٧٤ مع “الصدمة البترولية” التي أنهت حقبة تنموية دامت أكثر من ربع قرن، ووفاة آخر رئيس حظي بشرعية لا تناقش فالرئيس جيسكار ديستان فاز بأغلبية شديدة الضآلة، والرئيس ميتران كان مرفوضا من قطاعات واسعة، الخ، وحاليا الرئيس ماكرون انتخب مرتين لا لاقتناع الفرنسيين به بل لرفضهم لمرشحة أقصي اليمين المتطرف مارين لوبن، وعلي عكس الرئيس شيراك الذي انتخب للمرة الثانية بعد انتصاره علي مرشح اليمين المتطرف جان ماري لوبن والد مارين، لم ينتبه الرئيس ماكرون إلي أن انتخابه ليس تفويضا ولا تأييدا لبرنامجه بل انتخابا لأخف الأضرار رغم وضوح الأمر بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة حيث لم يحصل علي أغلبية مطلقة.
وسمعت في مجالس نقدا شديدا للرئيسين ميتران وشيراك -حكما فرنسا ٢٦ سنة- لأنهما بثا خطابا يفهم منه ضمنا أنه من الممكن تقليل ساعات العمل وتخفيض سن المعاش مع رفع الدخول لأن الإنتاجية المرتفعة للفرنسيين ستعوض تناقص عدد ساعات العمل، بينما الحقيقة في ظل العولمة أن مع دخول الصين حلبة المنافسة لم يكن هذا ممكنا، حاول الرئيس ساركوزي تغيير هذا المفهوم ليقول – نعمل أكثر لنكسب آخر- وحقق بعض النجاحات، ولكن هناك نسبة من الفرنسيين تري أن العمل عقاب لا يستحقونه ولكنه ضروري، وتبنت بعض القوي السياسية – أقصي اليسار- خطابا يدافع عن ” الحق في الكسل”.
وهناك من يري أن فرنسا لم تحسن التعامل مع تبعات العولمة وانهيار الاتحاد السوفييتي والوحدة الألمانية، فسعت إلي الحد من حركة المارد الألماني بالإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية لأوروبا وفرض علي ألمانيا عملة واحدة، ونجح الألمان في فرض شروطهم – انضباط مالي وعملة مرتفعة القيمة- التي تلائم ظروف الاقتصاد الأوروبي وتؤذي الاقتصاد الفرنسي الذي فقد أداة هامة وهي السياسة النقدية، وزاد من الطين بلة التخفيض الكارثي الجديد لساعات العمل الذي أقرته حكومة جوسيان أثناء الولاية الأولي للرئيس شيراك. كل هذا أدي إلي عجز الميزان التجاري وإلي فقدان فرنسا لجزء كبير من قاعدتها الصناعية، ومع ثورة الاتصالات وظهور القنوات الفضائية والانتقال إلي اقتصاد المعلومات وتراجع الصناعة زادت صعوبة إدماج المهاجرين… في الولاية الثانية له لم يفعل الرئيس شيراك إلا أقل القليل لإنه أدرك كما أسلفنا أنه لا يملك تفويضا، وأثناء رئاسته الممتدة حاول مرتين القيام بإصلاحات هامة واضطر إلي التراجع في المرتين
وهناك من يري أن المشكلة في فشل الرؤساء الثلاثة الذين خلفوا الرئيس شيراك في التعامل مع الأزمات الهيكلية منها والطارئة، أزمة الاقتصاد العالمي سنة ٢٠٠٩ وأزمة انهيار الاقتصاد اليوناني وغيرها، ولعب كل منهم دورا هاما – غير مقصود فيما يخص ساركوزي وهولاند- في انهيار أحزاب الحكم في فرنسا وارتفاع أسهم الأحزاب المتطرفة في الشارع الفرنسي، و ضمن أخطاء أخري خفض الرئيس ساركوزي ميزانية وأعداد رجال الشرطة والجيش مما فاقم من حدة الأزمة الأمنية، والرئيس هولاند كان شديد البطء في عملية الإصلاح لأنه كان يدرك حدة أزمة الشرعية والأزمة الاجتماعية، وعجز علي فرض الانضباط الحزبي علي كوادر حزبه الذين سمموا جو رئاسته وعرقلوا كل خطواته، والرئيس ماكرون انتخب انتخابا لا يمكن اعتباره تفويضا، وسعي إلي اسراع كبير في وتيرة الإصلاحات التي تأخرت، وأسلوبه ومنهجه السلطويان وتصريحاته المستفزة للفقراء وتجاهله لضيق قاعدة مؤيديه أدوا إلي انفجار الموقف سنة ٢٠١٨.
(2)
من المؤكد أن المشهد السياسي الفرنسي الحالي مأزوم – رئيس مكروه وفقا لكافة استطلاعات الرأي ولا يملك أغلبية مطلقة في مجلس الأمة وارتفاع مذهل لنصيب القوي السياسية المتطرفة و/أو المجنونة من الأصوات والمقاعد- وتعامل الفاعلين مع هذا المشهد جزء وركن من الأزمة يساهم في إيجادها وتغذيتها وتفاقمها، ولكن جذور الأزمة قديمة وتنوعت وتغيرت مع مرور الوقت ومع عدم كفاءة الفاعلين المتعاقبين في التعامل معها. وأتصور أن فهمها يقتضي عودة إلي الوراء اعتمدت فيه علي عدة مراجع أهمها لمارسيل جوشيه وفيليب رينو وجان كلود ميلنر وبيير مانان ولوك روبان وجيروم فوركيه. وطبعا اجتهدت في الفرز في كلامهم وفي تلخيصه وأضفت ما أراه. والأخطاء في الوصف أخطائي.
انطلق الجنرال ديجول والمشرع الدستوري الذي حرر دستور الجمهورية الخامسة من ضرورة إزالة نظام الجمهورية الرابعة الكارثي، نظام برلماني وقانون انتخابي يفضل التمثيل النسبي، مع تغير شبه دائم لخريطة التحالفات. ودستور الجمهورية الخامسة قوي الدولة المركزية والسلطة التنفيذية ومكنها من ترويض البرلمان ومن ضبط عمل السلطة القضائية وايقاع أداء الاقتصاد وأقر نظاما ينظم انتخابات تشريعية فردية علي جولتين، وقوي شوكة الرئيس بإقرار انتخابه شعبيا (علي جولتين أيضا ما لم يحصل علي أكثر من خمسين في المائة من الأصوات في الجولة الأولي) وهذا ضمن له شرعية طاغية ساحقة لشرعية غيره.
يلاحظ أن المشرع لم يقر نظاما “بريطانيا” قائم علي انتخابات فردية من جولة واحدة يكون فيها المقعد من نصيب المتصدر مهما كانت نسبة الأصوات التي حصل عليها، ولم يفعلها لسبب بسيط… أيامها كان أقوي حزب هو الحزب الشيوعي… واليوم أقوي حزب التجمع الوطني لمارين لوبن.
وهذا النظام الانتخابي فضل تداول السلطة علي ثقافة الحلول الوسطي وهي ثقافة ضعيفة المنبت والشعبية في فرنسا. وفرض علي كل تيارات اليمين ويمين الوسط أن توحد جهودها وتنسق فيما بينها تحت راية الرئيس أو أقوي حزب فيها، وفرض علي اليسار نفس الأمر، وهذا كان يضر بفرصه نظرا لخوف أغلب الناخبين من الشيوعية وتفوق اليسار الماركسي علي الأحزاب الاشتراكية. أي أن الدستور الجديد وقانون الانتخابات أوجدا معا نظاما سياسيا ثنائي القطبية متعدد الأحزاب مع غلبة في السنوات الأولي للديغوليين والشيوعيين، وإلي سنة ٨١ كانت كل كتلة تطرح مشروعا سياسيا واقتصاديا واضح المعالم فاليسار بأغلب فصائله كان يزعم إمكانية بناء مجتمع اشتراكي
وعبقرية دستور الجمهورية الخامسة تكمن في كونه نجح في صهر وإرضاء ما لا يقل عن رافدين هامين من روافد الثقافة السياسية الفرنسية، ثقافة جمهوريات برلمانية وحوار وجدل دائمين حول كل صغيرة وكبيرة، وثقافة الحنين إلي الملك صاحب النفوذ المطلق القادر علي تفعيل الدولة. لا أقول أن الفرنسيين يريدون نظاما ملكيا، سواء كانت الملكية مطلقة أم دستورية، أقول أن هناك حنين إلي صورة “الملك” صاحب السلطة المطلقة، ملك يكون رمزا للأمة والدولة، محاطا بهالة وقدسية، يملك من السلطات ما يمكنه من تفعيل وتجسيد قوة وعظمة فرنسا، ويشرف علي تطوير أداء الدولة وتوسيع نطاقه، يحافظ علي الاستقرار دون عرقلة التقدم، يكون سلطويا دون المساس بالحريات، يضمن العدالة مع تمكين السلطة التنفيذية، يكون كلويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر، كنابليون أو شارل ديجول أو -بدرجة أقل- الرئيس ميتران. طبعا لم يحل الدستور مشكلة ندرة الأشخاص القادرة علي تجسيد فرنسا وعلي صيانة وقار وقدسية وهالة المنصب الرئاسي. وهذه هي إحدى أسباب الكم المرعب للحركات الاحتجاجية في فرنسا.
وغني عن البيان أن لليمين تحفظات علي “الثقافة” البرلمانية والعلاقات الأفقية ولليسار تحفظات علي مفهوم القائد والعلاقات الرأسية، مع وجود استثناءات، من أمثال الرئيس ميتران زعيم اليسار التاريخي، ولكنه نشأ في أوساط يمينية وثقافيا ينتمي إلي اليمين، ويعاني اليسار في الانتخابات الرئاسية – التي تختار زعيما واسع السلطات- ويمكن القول دون تجني أن العناصر المتطرفة في الحزب الاشتراكي هي التي أفسدت ولاية الرئيس هولاند وتسببت في عجزه عن ترشيح نفسه رغم حصاده المعقول جدا.
أثبت الوقت عمق وأهمية مزايا دستور ٥٨ وقدراته علي التأقلم والتغيرات السياسية والاجتماعية، وعلي تحييد بعض الظواهر السلبية، وطبعا ولد ظواهر سلبية أخري، هي الوجه الآخر له. وطبعا أدخلت عليه تعديلات بعضها حسن وبعضها جاء بنتائج سلبية غير متوقعة
المشهد تطور تدريجيا في السبعينات وبوتيرة أسرع في الثمانينات، في صفوف اليسار تراجع نفوذ وسطوة الحزب الشيوعي فلم تعد الكتلة اليسارية تخيف الناخب، وصول اليسار إلي الحكم سنة ٨١ ومع فشل سياسته الاقتصادية المتبعة بين ٨١ و٨٣ وهي سياسة جمعت بين التأميم وسياسة “دعم الطلب” اضطر الرئيس ميتران إلي تبني سياسة اقتصادية قابلة لآليات السوق، مخففة من قبضة الدولة علي الاقتصاد ومن رقابتها علي الأسعار، ومن ناحية أخري نجح اليسار في تخفيف قبضة الدولة علي الإعلام وهيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية والدولة المركزية علي المحليات، وبصفة عامة فشل برنامجه الاقتصادي الأصلي دفعه إلي تبني أجندا مطلقة للحريات داعمة للفردية، وموسعة المجال للناشطية، وإلي تبني مشروعي تعميق الوحدة الأوروبية وإقامة عملة موحدة، وإلي الاحتفاظ بأغلب أركان السياسة الخارجية للجنرال ديجول – مع تحويرها لتلائم مستجدات الواقع وبعض أفكار اليسار.
وبدا أن إجماعا وسطيا ظهر في الثمانينيات والتسعينيات، فالحزب الديغولي (تغير اسمه عدة مرات) والحزب الاشتراكي وأحزاب الوسط الصغيرة اشتركوا في تبني سياسات قابلة آليات السوق ودولة الرفاة ومعمقة للوحدة الأوروبية، وقابلة لمظاهر التحرر الفردي علي مستوي السلوك الشخصي (مع وجود تحفظات قوية من قبل بعض مكونات اليمين)، وقال بعض كبار المفكرين – ربما تسرعوا- أن عصر الاستقطاب بين اليمين واليسار وهو استقطاب حكم الحياة الفرنسية منذ ثورة ١٧٨٩ انتهي.
ولكن هذا الاجماع تسبب في مشكلات عديدة، أولها تراجع في نسبة المشاركة في الانتخابات، وثانيها تردد الحزبين الديغولي والاشتراكي، وبحثهما الحثيث عن ملفات تميزهما، وكيفية إرضاء الناخبين المتمسكين بأجندة ثقافية محافظة بالنسبة لليمين وبسياسة اقتصادية رافضة لآليات السوق بالنسبة لليسار، وتسببت محاولة الحزب الاشتراكي تصوير تحوله إلي اقتصاد السوق علي أنه مؤقت ومجرد وقفة راحة علي طريق التحول إلي اقتصاد اشتراكي لا تعني التخلي عن الفكر الثوري في تراجع ثقة الناخبين في كلام الساسة شأنها شأن تقلبات زعيم اليمين شيراك المغير باستمرار لمواقفه، ودعم هذا التراجع في ثقة الجمهور ومصداقية النخبة قيام السلطات القضائية بفضح فساد بعض النخب، والطريف أن القضاء فقد هو أيضا قدرا من مصداقيته لأنه بدا مسيسا، مفضلا ملاحقة أقطاب اليمين، ولا نقول أن هذا الانطباع صحيح، نقول أنه موجود. وفي نفس الاتجاه تراجعت مصداقية الإعلام الذي تحول إلي جماعة مصالح تستغل وضعها المميز لترويج لروايات ولدعم مواقف لا تلقي استحسان قطاعات واسعة، وأزمة الثقة هذه في أغلب المنخرطين في العمل العام من أهم مظاهر الأزمة في فرنسا حاليا
ويلاحظ أن محاولات الحزب الاشتراكي إبراز تمسكه بالمثل العليا الاشتراكية هي وراء إصداره سنة ٢٠٠٠ لقانون يقلل من عدد ساعات العمل وهو قانون أثر تأثيرا سلبيا بل بالغ السلبية علي الاقتصاد الفرنسي وعلي قدرته علي المنافسة في مرحلة صعود الصين وألمانيا الموحدة
وثالثها وجود رفض شعبي كبير لأحد أركان هذا الاجماع الوسطي، رفض كان موجودا حاضرا منذ سنة ١٩٩٢ وظل يتعمق وبكسب قواعد جديدة، وهذا الركن مشروع الوحدة الأوروبية، لهذا الرفض أسباب نورد بعضها: ميل المسؤولين السياسيين إلي تبرير قرارات لا تتمتع بشعبية بالزعم بأنهم أطاعوا أوامر المفوضية، ومنها اكتشاف تبعات التنازل عن بعض مظاهر السيادة مثل صك العملة، ومنها اتساع دائرة العضوية الذي عقد عملية اتخاد القرار ونقل مركز ثقل الاتحاد الأوروبي من باريس إلي برلين، ومنها إدراك تراجع فرنسا وصعود ألمانيا وقيام المفوضية بالتخديم علي المصالح الألمانية، وإلي جانب هذا بدت المفوضية وكأنها هيئة غير منتخبة تتبني خطابا ما بعد حداثي يؤمن بالتعددية الثقافية وهو مفهوم لا يلقي ارتياحا في فرنسا الفخورة بثقافتها، هيئة تتساهل مع الهجرة وتعجز عن توفير الأمن، وربط الكثيرون بين ارتفاع معدلات الجريمة في المدن الكبرى وحرية التنقل من دولة إلي أخري.
ومن الطريف أن هناك من انتقد بيروقراطية بروكسل لأنها مفرطة في الليبرالية، وهناك من وبخها لأنها ليست ليبرالية بما فيه الكفاية. وكان الموقف من الوحدة ملف تسبب في انقسامات داخلية في الحزبين الديغولي والاشتراكي ازدادت حدة مع مرور الوقت،
ويلاحظ أن هذا الإجماع الوسطي الذي بدا قويا في النصف الثاني من الثمانينات وفي التسعينات قبل أن يصاب بهشاشة… هذا الإجماع الوسطي لم يؤد إلي تمكين أحزاب الوسط قبل وصول الرئيس ماكرون إلي الرئاسة، رغم نتيجة فرانسوا بايرو الممتازة في انتخابات ٢٠٠٧، لأسباب يطول شرحها بعضها يعود إلي فشل الفكر الليبرالي في توسيع قاعدته التي انحصرت في أوساط الأعيان وبعض فئات الطبقة الوسطي، وإلي عدم شعبية رموزه، وإلي أسباب أخري سنذكرها لاحقا.
ولعب فشل الحكومات المتعاقبة التي سبقت وصول ماكرون إلي الرئاسة في حل مشكلات البطالة والهجرة والأمن والتوترات الطبقية والإثنية/الطائفية دورا كبيرا في زيادة مضطردة في نصيب القوي المتطرفة الرافضة تماما لأركان الإجماع الوسطي من الأصوات، شأنه شأن عجز النخب عن إقناع الطبقات الفقيرة والمتوسطة بأنها مدركة لتآكل وضع محدودي الدخل الاجتماعي وقدراتهم الشرائية وعن تبني رواية مقنعة لهم
نتفق والعلامة فيليب رينو علي أن فشل أحزاب الحكم التقليدية وعمق أزمة فرنسا لم يكونا كافيين لشرح نجاح “إيمانويل ماكرون” في الوصول إلي منصب الرئاسة، العوامل الحاسمة كانت الانقسامات الداخلية الشديدة التي تعاني منها أحزاب الحكم (الديغوليين والاشتراكيين) حول ملفات تمس الهوية من ناحية والمشروع الأوروبي من ناحية أخري، وتبني هذه الأحزاب آلية لاختيار مرشحيها عمقت هذه الانقسامات وأدت إلي تعيين مرشح يمثل (بعض) المتطرفين من أعضاء الحزب، وأدت حلقات تصفية الحسابات بين أقطاب اليمين الجمهوري إلي فضح الفساد المالي لمرشح حزبهم، وأخيرا وليس آخرا نجح يمين الوسط واليسار الوسط في توحيد صفوفهم وراء المرشح ماكرون لأن أقطاب هذه التيارات فهموا أن عدم توفيق الحزبين الكبيرين في اختيار مرشحيهما ترك مجالا واسعا وفرصة سانحة لجذب الناخبين المعتدلين.
يبدو توحيد صفوف الوسط عملية سهلة إن تناسي السياسيون طموحاتهم الشخصية، فالمشترك بين يمين الوسط ويسار الوسط كثير، الإيمان باقتصاد السوق وبدولة الرفاة وبالمشروع الأوروبي، بيد إن هذا الكلام ليس دقيقا، يري الدكتور رينو إن الخلافات بين مكونات الوسط عميقة وعقدت ممارسة الحكم، فقواعد الوسط هي من ناحية مكونات الطبقات الوسطي المستفيدة من العولمة وقاطنة المدن الكبرى، ومن ناحية أخري أعيان المحافظات وشبكاتهم، ويمين الوسط أكثر محافظة من يسار الوسط في قضايا الحقوق الشخصية والحفاظ علي الهوية، وهو أيضا يفضل الاستقرار أي يركز علي ضمان امتيازات فئوية وعقود عمل طويلة الأمد وأغلب أبنائه يستثمرون في الملكية العقارية (أراضي/ شقق/ مباني) في حين أن يسار الوسط (وهو اتجاه الرئيس ماكرون) يؤمن ويحبذ ثقافة الاختراع والبحث العلمي والاستثمار في التصنيع وفي التكنولوجيا والمعلومات، ويحارب كافة صور الريع بما فيها الامتيازات الفئوية وأصحاب المعاشات ولا يحبذ عقود العمل طويلة الأجل أو غير محددة المدة، وعندما وصل إلي الحكم ميزت سياسته الضريبية بين أصحاب المشروعات وأصحاب الريع أيا كان لصالح الأولين وبوضوح لا لبس فيه،
وفيما يتعلق بالنظام السياسي يدرك الرئيس ماكرون من ناحية أن برنامجه الطموح الساعي إلي إعادة هيكلة الاقتصاد الفرنسي وتغيير قواعد اللعب فيه لا يحظى علي تأييد الأغلبية (لا يعنينا حاليا تقييم موضوعي لمحتواه) وفهم من ناحية أخري أن إصلاح الوضع المالي لفرنسا يتطلب لجم كيانات عديدة وبالتالي هو من أنصار تقوية السلطة المركزية علي حساب المحليات (ألغي ضريبة كانت مصدرا هاما لدخل هذه المحليات) والكيانات الوسيطة مثل النقابات، وتقوية السلطة التنفيذية علي حساب التشريعية، وفي أحوال كثيرة فضل صيغ تشريعية تسمح بعدم عرض الأمر علي البرلمان،
ووفي المقابل نجد أن إدراك يمين الوسط لضعف الوسط في فرنسا يدفعه إلي تحبيذ انتخابات بالقائمة النسبية لتعجز أحزاب الحكم التقليدية عن الحصول علي أغلبية برلمانية ولتضطر إلي التحالف معه، ويعرف أن برنامج يسار الوسط يقتضي تغيير قسري لعادات وثقافات فئات كثيرة في فرنسا ويقتضي تعديل العقد الاجتماعي ولذلك فهو أقل حماسا له. وما يؤكد هذا الكلام هو أعمال كل من الدكتور لوك روبان والدكتور جيروم فوركية… التي تظهر أن القاعدة المؤيدة لمشروع الرئيس ماكرون أضيق من القاعدة التي تنتخبه في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية ، وأن أغلب ناخبيه يرون فيه أخف الأضرار، وجدير بالذكر أن حتي القاعدة الضيقة التي تؤيد برنامجه الاقتصادي تضم الكثيرين الذين لا يحبون شخص الرئيس.
إن نظرنا إلي الأمور من زاوية أخري، يمكن القول أن الحزب الاشتراكي أضعف نفسه بنفسه مع إصرار أجنحة فيه متمسكة بأشكال مختلفة ثورية أو دولتية للحلم الاشتراكي علي تسميم وعرقلة ولاية الرئيس هولاند، ورفض الحزب الدفاع عن حصاد هذه الولاية رغم معقوليته، كل هذا أجبر معتدلي الحزب علي تركه، أغلبهم أيد الرئيس ماكرون، وبعضهم يبحثون عن كيفية استرداد زمام الأمور في الحزب أو إنشاء حزب جديد وما زالوا يحاولون، وفي انتخابات ٢٠١٧ ووجد الحزب نفسه مسحوقا في كماشة بين ترشيح ماكرون المخاطب للمعتدلين وترشيح ميلانشون المخاطب للمتطرفين. وانضم الخضر إلي فكي الكماشة في انتخابات ٢٠٢٢، واختيار الحزب لمرشحة سيئة جدا أكمل المشكلة وانهار الحزب تماما.
الحزب الديغولي صمد فترة أطول، صحيح أنه – سنة ٢٠١٧- فشل لأول مرة منذ ١٩٧٤ في الوصول إلي الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية ولكن مرشحه حصل علي أكثر من ٢٠٪ من الأصوات رغم الفضائح المالية، ولذلك كان إضعاف هذا الحزب علي رأس أولويات الرئيس ماكرون عندما وصل إلي الحكم، فاختار عدد من أقطابه وضمهم إلي حكومته، منهم رئيسا الوزارة إدوار فيليب وجان كاستكس، ووزير المالية برونو لومير، ووزير الداخلية دارمنان، وتبني بعض السياسات التي تخاطب ود ناخبيه… وأخري تستفزهم، ولعبت انتفاضة السترات الصفراء دورا هاما في حشد عدد كبير من ناخبي اليمين الديغولي وراء الرئيس بوصفه السد الأهم وربما الأخير ضد الفوضى. ونالت إدارته لجائحة الكوفيد رضا قطاعات كثيرة، ولكنها تسببت في تفاقم وضع مالية فرنسا
ولكن حزب الرئيس فشل في ترسيخ وجوده في المحليات وظل الكثير منها معقلا للاشتراكيين والديغوليين، وفشل في اقناع أغلب الفرنسيين أنه يفهمهم. وفي استرداد ثقتهم في العمل العام، وإدارة الرئيس للملفات السيادية – الدفاع والأمن والسياسة الخارجية والعدل- لم تقنع الكثيرين
(3)
تميل وسائل الإعلام الرئيسية إلي اعتبار أزمة الضواحي نتيجة ودليل علي عنصرية الدولة الفرنسية وممارساتها، ولكن هذه المقاربة تمنع فهم أبعاد مشكلة شديدة التعقيد، وهي اتهام يساهم في تأجيج العنصرية التي يندد بها، ويأتي بنتائج عكسية، ولا يعين علي بلورة حلول باتت ضرورية، هذا المقال الأول في سلسلة تستعرض الأبعاد المختلفة للأزمة والقراءات المتباينة لها وللحلول المطروحة.
ملاحظات حول الأحداث وأزمة المهاجرين (١)
العنصرية بين الواقع والاتهامات
لجأ عدد من الفاعلين والمراقبين إلي تفسير لأحداث فرنسا مفاده أننا شاهدنا انتفاضة ضد عنصرية الدولة بصفة عامة وجهاز الشرطة بصفة خاصة، وهو تفسير لا يصلح كمقدمة للتحليل ومن باب أولي كفرضية يجوز اختبارها، وهو تفسير يمنع التفكير ويشرعن أفعال إجرامية ويختزل ظواهر مختلفة وأفعال متباينة تحت بند واحد هو “العنصرية” ويمنعنا من رؤية عميقة ومتكاملة لأبعاد الأزمة وللحلول إن وجدت، لا نزعم أننا كوننا هذه الرؤية فالأزمة بالغة التعقيد وعميقة الجذور ومتعددة الأبعاد، وستشاهد كواليس ومسرح السياسة الفرنسية تنافسا بين التوجهات الفكرية لفرض وجهة نظرها، وبين أصحاب المهن والتخصصات المختلفة، كل منهم يري أن أصحاب كاره يملكون الحل أو علي الأقل أن بداية الحل في أيديهم.
هناك طبعا عنصرية وتوجهات وممارسات عنصرية في فرنسا، وهي ليست حكرا علي السكان “البيض”، أبناء المهاجرين العرب والأفارقة والأسيويين لهم أيضا تصورات وممارسات عنصرية، والجامعات تشاهد باستمرار توترات واشتباكات بين الطلبة من ذوي الأصول المتنوعة. علي سبيل المثال يعاني أبناء المهاجرين عندما يبحثون عن سكن أو عمل وفي أماكن العمل، وفي التعامل مع أفراد يعملون في جهاز الدولة،. ولكن القول أن الدولة تتبني سياسات عنصرية منهجية تجاه أبناء المهاجرين محض افتراء تبثه بعض الفصائل السياسية تتصور أنها تستفيد من إشعال الأوضاع وتردده بعض المواقع الإعلامية. من الجائز طبعا أن يقول البعض أن عددا من أركان العقد الاجتماعي والسياسي الفرنسي يتجاهل الخصوصية الثقافية لأبناء المهاجرين ولكن إدارة مجتمع تتعايش فيه عدة ثقافات لكل منها أحكامها فيما يتعلق بأمور حيوية كالزواج والإرث وأصول العلاقات الرجال والنساء وبين الوالدين وأبنائهما والعلاقة بين الدين والسياسة والعلاقة بين الفرد والجماعة وأسلوب ممارسة الفرائض الدينية وأسلوب الكلام عن المسلمات الدينية… ولكل ثقافة منها ذاكرة جريحة وارتباطات مع العالم الخارجي لا تستطيع الدولة ضبطها ولا حتي مراقبتها… نقول أن إدارة مثل هذا المجتمع المتعدد المتنوع أمر بالغ الصعوبة ولكل الصيغ التي عرفها التاريخ مساوئ ومثالب. الصيغة الفرنسية تحاول إيجاد لغة وتصورات مشتركة بين كل مكونات الأمة ويبدو لنا هذا شرط ضروري لتحقيق إمكانية المساواة وتكافؤ الفرص، وهذه الصيغة ليست فاشلة كما يدعي أعداؤها، وهناك فعلا امتزاج تظهره الاحصائيات الخاصة بعدد الزيجات بين أبناء وبنات الأجناس المختلفة، ويظهره أيضا الوجود الكثيف لذوي الأصول العربية في وزارات هامة، ولكنه يبقي أن عدد الوزراء والنواب وكبار رجال مجتمع الأعمال من أصول إثنية أجنبية ما زال ضعيفا، ويبقي أيضا أن تطورات كثيرة تسببت في تفاقم مشكلة التفاوت في الفرص الاجتماعية وفي فشل الدولة والمجتمع في تفعيل أحد أركان العقد الاجتماعي وهو المساواة. وأري أن هناك فارقا بين العمل السياسي والاحتجاجي المطالب بتفعيل العقد والعمل السياسي والاحتجاجي الساعي إلي هدمه وتغييره – من المؤكد أن هناك أسباب وحجج تدعم وجهات نظر الموقفين ولكنه يبدو لي أن الرأي العام الفرنسي يفضل الخيار الأول الذي يتفق وعاداتهم ومركزية الدولة ومكانتها
العنصرية وعلاقة الشرطة بأبناء الضواحي
من يتحدث عن عنصرية الشرطة يذكر دائما عدد أبناء المهاجرين الذين قتلوا بعد ما رفضوا تنفيذ أوامر الشرطة بالتوقف وهربوا بسرعة فائقة، وقد يبدو التعامل مع هذا الرفض خشنا خشونة غير مبررة، ولكن نظرة سريعة إلي عدد الإعتداءات علي رجال الشرطة وعنفها المتزايد وإلي تاريخ الإرهاب والإجرام في السنوات الماضية ورصد الظاهرة المطلق عليها rodéo urbain يشرحان الظاهرة وطبعا لا يبرران كل حوادث القتل. في مدينة نيس في ١٤ يوليه ٢٠١٦ قتل إرهابي يقود شاحنة ٨٦ من المارة قبل أن تتم السيطرة علي الموقف، وحاليا تسود ظاهرة الrodéo urbain وهي إما قيادة سيارة بسرعة مجنونة خطيرة مع تعمد تخويف المارة وإرهابهم بالتظاهر بمحاولة دهسهم أو منافسة بين شباب كل منهم يقود سيارة ويسابق الآخر، في وسط المدينة، وسنعود إلي ظاهرة عدم الامتثال للأوامر لاحقا. وهناك مشكلات أخري وهي سرعة نقل رجال الشرطة من قسم لآخر فلا يخدمون في نفس المكان لمدد تسمح بمعرفة السكان وجغرافيا الحي وخصائه، هذا الوضع يجعل الشرطي خائفا وخشنا،. وفي المقابل هناك تنديد مبرر ببعض ممارسات الشرطة، من حقها طلب أوراق من تشتبه فيهم من المارة، ويكثر رجالها من التحقق من هوية من يبدو عربيا، ويميل رجالها إلي مخاطبة الشباب والعرب بصيغة المفرد وهذا أسلوب غير لائق إن لم يوجد سابق معرفة، وهناك كثير من التصرفات بعضها مبرر وبعضها لا يمكن الدفاع عنه يراها الشباب لا سيما الشباب العربي مهينة
تبعات الاتهام
التنديد بداعي أو بلا داعي بالعنصرية واتهام الدولة والشرطة أدا إلي ما يلي… تعاملت الشرطة مع الأحداث الأخيرة بحرص لتفادي إصابة المخربين لتفادي تهمة العنصرية إن مات أو أصيب أحدهم، في حين أنها تعاملت بحزم قد يصل إلي حد القسوة مع المخربين والمتظاهرين في أحداث السترات الصفراء سنة ١٨/١٩، إذ كان غالبيتهم مما يطلق عليهم بالسكان الأصليين، من الممكن بالطبع نسبة هذا الفارق إلي أسباب أخري – البعد السياسي لحركات السترات الصفراء- ولكن الرأي العام ينسب الفارق إلي الخوف من ذوي الأصول العربية ومن الاتهامات بالعنصرية، ونعطي مثالا آخرا، لتفادي الإصابات وتهم العنصرية هناك تعليمات بعدم ملاحقة الشبان العرب الذين يقودون دراجات بخارية، نظرا لارتفاع احتمالات الحوادث القاتلة، فيستغل هؤلاء الوضع لإهانة رجال الشرطة والفر بعيدا فلا يمكن القبض عليهم، ويغذي هذا الوضع غضب الأغلبية وكراهيتها لذوي الأصول الأجنبية والاحساس العام بعجز الدولة وتراجع هيبتها وإحساس الأغلبية بأن هناك تمييز ضدها، أي أن الاتهام الدائم بالعنصرية يساهم في إيجاد الظاهرة التي يقوم بإدانتها، مرة أخري من الطبيعي مكافحة العنصرية وظواهرها المختلفة، ولكن اللجوء الدائم إلي التفسير بالعنصرية أمر يأتي بنتائج عكسية ويزيد من الاحتقان بين مكونات الأمة، شأنه شأن دخول دول أخري علي خط الأزمة مستغلة الفرصة لتوجيه اتهامات إلي الدولة الفرنسية. ومن المؤكد أن السلطة الحالية فضلت محاولة إرضاء اليسار الراديكالي وسارعت في إدانة الشرطي (الذي ارتكب خطأ جسيما وفقا لإجماع زملائه مع اختلاف في تقدير وتقييم الظروف المحيطة ووجود ظروف مخففة من عدمه) في خطوة أغضبت الشرطة والأغلبية ولم تنجح في تهدئة الضواحي بل ساهمت في إشعال الموقف.
باختصار هناك مشكلة أو مشكلات ضواحي منها مشكلة العنصرية والممارسات العنصرية، ولكن التركيز علي الأخيرة بصفة عامة وتحويلها إلي نقطة ارتكاز السياسات والخطاب الإعلامي يبدو لنا أمرا يأتي بنتائج عكسية، فهو يوسع من الهوة بين مكونات الأمة ويحول الأغلبية وثقافتها إلي متهم بل إلي مذنب دائم، وهذه الشيطنة والتلقين السخيف والمستمر والسعي إلي منع بعض أمهات الكتب الغربية ساهموا في صعود اليمين المتطرف كرد فعل وإلي تراجع أحزاب اليسار في حين أن التعامل مع العولمة يتطلب يسارا قويا قادرا علي طرح بدائل مقبولة.
أبعاد أزمة الضواحي
بعد التنبيه السريع إلي اختلافات كبيرة بين أوضاع الضواحي المختلفة، نشير إلي بعض هذه المشكلات وليست كلها، هناك طبعا مشكلة في التخطيط العمراني لهذه الضواحي، وفي مستوي الشقق المتواضع للغاية، فالشوارع الكبيرة الكئيبة لا تسهل تنمية حب المكان والقدرة علي التشبيك والتواصل علي عكس الشوارع الضيقة، ومن ناحية أخري تنازلت الهيئات والسلطات المشرفة علي إسكان المهاجرين عن الفكرة الأصلية القائلة بوجوب فرض الاختلاط والتعايش بين الإثنيات المختلفة (بما فيها ما يسمي بالسكان الأصليين)، واستسهلت تسكين أبناء الإثنبة معا في شوارع أو أحياء تكون لهم، فأصبح هناك مثلا حي للمغاربة، وآخر للفيتناميين، وثالث للسود، الخ، كل منهم “غيتو” منغلق علي نفسه غير مرحب بالغير بما فيهم الدولة نفسها وهيئاتها، وأشار عدة عمد إلي هذه المشكلة، ولا نعرف طبعا إن كان خيار الاختلاط كان من شأنه زيادة المشكلات والاحتكاكات أو تقليلها، علي الأقل علي المدي القصير، ولكن العمد الذين يساهمون في النقاش العام يقولون أنهم يفضلون الخيار الذي تم التخلي عنه، ولا نستبعد احتمال أن يكون هذا الموقف تنصلا من المسؤولية.
ومن ناحية أخري هناك مشكلتي انهيار البنية التقليدية للعائلات وتدهور أداء المنظومة التعليمية، أي فشل الأساليب التقليدية لتربية الأطفال والشباب ونقل المعرفة. وفقا لطبيب نفساني معروف تحدث إلي الإعلام هناك في الأسر الفقيرة -ليست كلها عربية أو إفريقية – التي يوجد بها عدد من الأبناء ولا يوجد بها إلا أحد الوالدين – الأم في أغلب الأحوال – يضطر هذا الوالد إلي الجمع بين عدة وظائف أو مهام لزيادة دخله المتواضع ويتم هذا علي حساب تعليم الطفل والتواجد معه في الأيام الألف الأولي من عمره، ويدخل الطفل الحضانة أو المدرسة وهو لا يعرف ما يزيد عن مائتي كلمة – من أي لغة- في حين أن الطفل الذي لاقي عناية عادية من والد أو والدين يعرف حوالي عشر ألاف كلمة، ويعني هذا أن الطفل إياه لا يفهم ما يقال له وعاجز عن التعبير عن نفسه ولذلك يكون أكثر ميلا إلي استخدام لغة القوة والضرب والشجار وهذا يدفعه إلي الانضمام إلي شلل تمارس العنف وربما إلي عصابات. وهي مجموعات توفر له “عائلة بديلة” فيها علاقات سلطة تحدد المسموح والممنوع وبالتالي توفر إطارا قيميا. والمشكلة هي أنه تصعب أو تستحيل علاج/معالجة الأضرار التي تلحق بالتكوين النفسي واللغوي للطفل في أول أيام عمره، إضافة إلي كون أغلب الحلول التي تخطر علي البال تتطلب موارد كبيرة وعدد هام من الاخصائيين الاجتماعيين ومن الأطباء في دولة تعاني من ضائقة مالية وتراكم الديون، والحل الذي ورد علي لسان المسؤولين – معاقبة أولياء الأمور وحرمانهم من الإعانات حل غير أخلاقي وغير عملي وربما غير قانوني،
علي صعيد آخر، كانت المنظومة التعليمية العظيمة التي أسستها الجمهورية الثالثة بين ١٨٨٠ و ١٩٣٩ قادرة علي توفير فرص صعود اجتماعي عديدة ومتنوعة وعلي نقل قيم وثقافة وطنية جامعة رغم الصراع بين التيارات الفكرية العديدة التي تشكل الساحات السياسية والثقافية والاجتماعية في فرنسا، وتراجع أداء هذه المنظومة وقدرتها علي الاضطلاع بمهامها منذ النصف الثاني من الستينات من القرن الماضي وظل يتدهور إلي يومنا هذا، وهذا التدهور يصيب كل المجتمع في مقتل ويكون أبناء العائلات ذات الرأسمال الثقافي المحدود – ومن بينهم أبناء الضواحي – أول الضحايا.
ودراسة تعقيدات هذه الأزمة وعمقها و”مباريات إلقاء اللوم” الخاصة بها تستوجب ورقة مستقلة ستلي هذه الورقة.
المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook