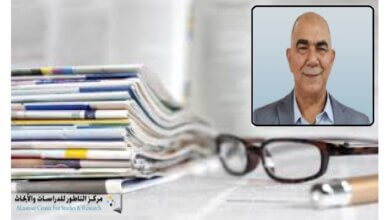توفيق أبو شومر: قصة التجويع والترحيل في غزة!

توفيق أبو شومر 17-9-2025: قصة التجويع والترحيل في غزة!
قال وهو يبكي: حاولتُ أن أُبعد عن ذاكرتي صورة بيتي الجميل المكون من أربعة طوابق، البيت الذي بنيته في خمس عشرة سنة هو اليوم كومة من الحجارة عندما انهار البرج المجاور عليه بسبب قنبلة من الطائرات الإسرائيلية، غير أنني تذكرت المطعم الفاخر الذي أشرفت على بنائه وسط غزة، هو مطعم يقدم أشهى المأكولات، أرجعتُ هذه الذكرى إلى حاسة الجوع التي أشعر بها في منتصف الليل، أنا لم أستطع النوم، أرجعت السبب إلى الخوف من القصف والنزوح، ومن المرض بسبب الجوع.
كنا نستقي الأخبار ليس من هاتفي القديم من نوع نوكيا، بل من أصوات وحوارات الجيران ممن يعرفون الأخبار بسرعة قبل أن تُذاع في محطات الإذاعة.
كل الأخبار يمكن احتمالها إلا خبر الترحيل من المكان، فقد رحلنا من غزة في بداية هذه الكارثة إلى رفح، هناك اجتمعنا مع عائلتنا الممتدة، خفَّف اجتماعنا واشتراكنا من مأساة تدمير بيوتنا وممتلكاتنا ومحلاتنا في وسط غزة، استأجرنا بيتاً واسعاً في رفح خفف عنا قليلاً ألم التهجير والتجويع، لأن الدمار طال معظم بيوت أقاربنا في غزة، ظننا أننا نجونا من الإبادة، كنا نسمع تعبيراً نحتته قوات الاحتلال (المناطق الآمنة) في مواصي خان يونس ورفح، غير أننا بعد شهر ونصف اضطرنا للرحيل إلى مواصي خان يونس بعد أن اكتشفنا أنه ليس هناك مناطق آمنة عند المحتلين، لم يمض سوى وقت قصير حتى جرى احتلال مدينة رفح وتدميرها وقتل عدد كبير من ساكنيها، استأجرنا منزلاً قديماً في خان يونس بمبلغ كبير، ظننا أنه سيكون خاتمة تهجيرنا الأخير، ولكننا بعد خمسة وأربعين يوما، اضطررنا للرحيل من خان يونس إلى المنطقة الوسطى، إلى مخيم النصيرات، وهناك استأجرنا بصعوبة بيتاً متواضعاً في المخيم كان قريباً من محطة توليد الكهرباء في مدينة الزهراء، كنا لا ننام بسبب أصوات القصف المدفعي وتفجير المنازل بقنابل الطائرات، كنا لا نستطيع الإغفاء ساعة واحدة، لأن أصوات الدبابات والجرافات وهي تطحن البيوت تسلب النوم، وتعيد لنا مسلسل الترحيل من جديد!
صباحات مخيم النصيرات مشحونة بالألم، لأننا كنا مضطرين لشراء الطعام غالي الثمن، قليلون هم من يستطيعون شراء حبتين من الطماطم والبصل والثوم أو الحصول على كيس من الخبز لأن سعرها يتجاوز المائة دولار.
لم يبق من النقود التي أحملها سوى مبلغ ضئيل لا يكفي ليومين أو أقل، حتى أن أجرة البيت تحتاج إلى أن أبحث عن دكان يصطف على بابه كثيرون ليتمكنوا من صرف بعض النقود المدخرة لهم في البنك باستقطاع بنكي بنسبة خمسين في المائة تقريباً، أي أن من يدفع مائة دولار يستلم خمسين دولاراً فقط من العملة المستخدمة وهي الشيكل، وعلى كل من يقبل هذه النسبة أن يستلم النقود المهترئة من صاحب المحل، هذه النقود غير قابلة للشراء، وهي أيضا لا يقبلها صاحب محل الصرافة نفسه لو أعدتها إليه من جديد، معظم الباعة يرفضون استلامها لأنها مهترئة.
لم يعد نور الصباح في تهجيرنا محبوباً كما كان في بداية تهجيرنا في رفح، كنت أخاف على أبنائي وبناتي، فهم قد تغيروا وأصبحوا عاملين يحملون أقراص العجين بعد أن تعده زوجتي، يبحثون عن فرن طيني يخبزون فيه كرات العجين بالنقود، أو باستقطاع خمسة أرغفة من عشرين رغيفاً، بحيث يبقى فقط خمسة عشر رغيفاً من العشرين، يبيع صاحب الفرن ما يتوفر لديه من خبز ليتمكن من شراء الحطب اللازم للخبز.
لم يعرف أحد مقدار الألم الذي أشعر به وأنا أسير في الطريق بملابس غير نظيفة، لأن الحصول على الماء اللازم للغسيل يحتاج إلى أوعية بلاستيكية فارغة، وهي نادرة، وعندما تصل سيارة مياه مجانية ينطلق خلفها مئات الشباب والأطفال هم يجرون حاملين أوعيتهم الفارغة ليتمكنوا من الاصطفاف أو اغتصاب دور أحدهم بالقوة، شاهدتُ معركة بالسكاكين أمام سيارة نقل المياه، ما جعلني أطلب من أبنيَّ أن يشتريا المياه ممن يبيعونها، حتى لا يحدث لهما مكروه.
كنتُ أعرف أن رائحة ملابسي لا تُطاق، حاولت أن أرش بعض ما تبقى من عبوة صغيرة من العطر الشعبي على صدري، لأخفي رائحة ثيابي وجسدي المغطى بطبقة من العرق.
أبعدتُ صورة الحمامات ودورات المياه في بيتي المدمر، وبئر المياه الخاص، لم أظفر بحمام منذ أسبوعين، كنتُ استحم بعبوةٍ لا تتجاوز عشرة لترات، كنتُ أصب الماء على الأماكن الحساسة في جسدي بحذر شديد، توفيرا لحاجة بناتي اللاتي التصق بهن ثوبُ الصلاة منذ أيام طويلة، ولم يتمكنَّ من الظفر بحمامٍ يغسل أجسادهن!
أدهشتني فرحة أبنائي البالغة باتفاق وقف إطلاق النار في شهر كانون الثاني 2025 ، لم أكن فرحا مثلهم، لأنني سأعود لأتذكر كل حجر من حجارة البيت، ففي كل زاوية من البيت ذكرى جميلة خبأتها في أوراقي وأعماقي، فسرتُ فرحتهم برغبتهم الخروج من الواقع المرير الذي نحياه، لأنهم لا يُجيدون توقع الآتي من الأيام، فهم لحظيون.
قررتُ بعد عودتنا لغزة أن نسكن كلنا في مطعمنا الكبير غير المدمر، لم تدم الفرحة طويلا، بخاصة ونحن نرى عدد السيارات المصطفة في شارع صلاح الدين تنتظر التفتيش، فقد أمضينا يومين كاملين ننتظر دورنا على الرغم من قصر المسافة بين النصيرات وحاجز نتساريم.
لأول مرة بعثتْ ابتساماتُ أبنائي في نفسي أملاً جديداً، لعله يتغلب على تشاؤمي المستقبلي في أعماقي، حاولت أن أشاركهم الابتسامات، كنت أحاول أن أشجعهم على أن يُطلوا على نافذة الأمل المفتوحة على مستقبلهم، لأن جميع من كانوا ينتظرون دورهم كانوا مشحونين بالأمل، مشتاقين للعودة إلى ما تبقى من بيوتهم، ظللت أحاول أن أُبعد ما يعتريني من إحباط ويأس.
حين عدنا إلى غزة استطعنا أن نسكن في مطعمنا ستة أيام فقط، أحسسنا خلالها بأننا سنتمكن من إعادة الحياة لحجارة بيتنا المدمر، لم نكن نتوقع أن نُهجَّر مرة أخرى لأن هذا التهجير سيكون أكثر قسوة من تهجيرنا الأول، فقد أنذرنا المحتلون وطالبونا بمغادرة المكان، لم نتمكن خلال خمس عشرة دقيقة من انقاذ بعض مقتنياتنا، ها نحن نعيش في العراء من جديد لا يحجبنا عن السماء وعيون الجيران سوى مزق من قماش متعدد الألوان، نحن نعيش وسط أكوامٍ من البشر في ساحة واسعة في شمال غزة.
لم أكن أعلم مصدر الرائحة السيئة التي أشتمها عند النوم إلا بعد أن اكتشفتُ أن مكان وسادتي ومفرشي الأرضي يقع بالضبط قريباً من دورة مياه جارنا، فأنا لا أستطيع أن أغفو ساعة واحدة، على الرغم من رائحة الدخان النفاذة السامة من تفجير العمارات المجاورة.
ابناي الجائعان يستلقيان إلى جواري، أحدهما خريجٌ جامعي والثاني في المرحلة الإعدادية، هناك بقايا ستارة قديمة تفصل زوجتي وبناتي الثلاث عن مكان نومي، وهناك حفرة بها بقايا جردل بلاستيكي ممزق نقضي حاجتنا فيها، مع العلم أن الحصول على مياه الغسيل ومياه الشرب يحتاج إلى نصف يوم من العراك مع العدد الكبير من طالبي هذه المياه!
سأحدثك عن وجبة الطعام التي تناولناها هذا اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا، تناولنا بقايا من الخبز الذي خبزته زوجتي في مقلاة سوداء منذ ثلاثة أيام، بعد أن أشعلت بعض قطع النايلون وبعض قطع الخشب المشترى بثمن غال، اعتدت أن أمسح بقايا الخبز بيدي حتى لا تظهر عليه بقع وندوب الفطريات، فلم تعد هذه القطع المملوءة بالفطريات مستقبحة عند أفراد عائلتي كما كانت في الماضي قبل عصر التجويع، كنتُ أوهم أبنائي بأنني أحصل على نصيبي من الطعام مثلهم بالضبط، كنت أمضغ قضمة الخبز وأستمر في تحريكها في فمي مدة طويلة، حتى لا يحس أولادي بأنني أنام وأنا جوعان، على الرغم من أنني كنت أشتهي وضع قطعة من الجبن أو قرصا من الفلافل في وسط الرغيف.
اعتدت أن أسمع حوار الجيران وشتائمهم وعراكهم الدائم بوضوح، كان العراك يتوقف عندما نسمع انفجاراً قريباً، كان المتحدثون يستطلعون مكان الانفجار وهم داخل الخيمة، يشتركون في جدال طويل ينتهي بالسباب والشتائم، كنتُ قبل التهجير حريصاً على أن تكون بناتي الثلاث بعيدات عن سماع الشتائم القبيحة، أما في خيمتنا البالية لم أعد قادرا على حجب تلك المعارك اليومية!
عندما رأيت قصاصات الأوراق تتطاير من الطائرة، ظننتها ستكون بعيدة عن مكان نزوحي، غير أن تجمعا مكونا من أكثر من عشرة رجال كانوا يقرؤون الإنذار، ويعلنون أننا مشمولون بالترحيل.
تذكرتُ قول المتنبي: كفى بك داء أن ترى الموتَ شافيا…وحسبُ المنايا أن يكنَّ أمانيا!
ملاحظة: (هذه القصة الواقعية حصلت على تفاصيلها شفوياً من أحد معارفي المهجرين في شهر آب 2025)