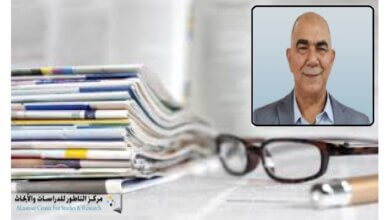بشار مرشد: ملاحظات… في تجربة البناء وتداعيات الانقسام

بشار مرشد 10-2-2026: ملاحظات… في تجربة البناء وتداعيات الانقسام
مقدمة:
لقد كنتُ متردداً في الكتابة حول هذا الموضوع، مفضلاً التغاضي عن عبثية المشهد، إلى أن استوقفني منشور لأحد الاشخاص يعلّق فيه بسخرية وبشماتة مقنعة على محاولات الاحتلال تفعيل “أحلامه” لتملك الأراضي في مناطق (أ)، محذراً بسخرية بأننا سنستيقظ لنجد مستوطناً يمتلك عقاراً في قلب مدننا.
وكان ردي من باب الانفعال القانوني: إنه من المضحك المبكي أن البعض يلعن السلطة ليل نهار، ثم يصاب بالذعر حين يرى الاحتلال يخطط لتهديم سجلاتها! قانونياً، لن يحلم المستوطن بشبر في مناطق (أ) إلا إذا سقط “الطابو الفلسطيني” الذي يعتبر التسريب خيانة عظمى وفق المادة 114 من قانون العقوبات. ويبدو أن حديثي العهد والأغرار يجهلون أنه قبل عام 1994، كان “ضابط الأراضي” الإسرائيلي هو الآمر الناهي، واليوم يستميت اليمين المتطرف والبعض لإلغاء أثر “أوسلو القانوني” ليعيد تلك الامتيازات من أجل السمسرة والانتفاع.
و هنا تبدأ الحكاية؛ في واحدة من أكثر التحوّلات إثارة للسخرية في التاريخ السياسي، تلك اللحظة التي يتحوّل فيها الهادم الراديكالي إلى وريثٍ باكٍ على الأنقاض. حالة كثيفة من التنافر المعرفي؛ تُهاجَم فيها المؤسسة في مهدها بدعوى أنها خيانة ويستمر المسلسل بلا وعي ، ثم حين يقع المحذور ويتصدّع البناء، يلتفت الهادم ليحمّل المسؤولية للبنّاء الأصلي، متسائلاً بصلافة: لماذا لم تمنعنا من هدم بيتنا؟
أولاً: المطرقة تحت ستار الطهارة:
تبدأ الرحلة بمزايدة أخلاقية فجّة؛ حيث يتفرّغ الراديكالي لشيطنة كل حجر وضعه البنّاء الأصلي، فيُشغّل المطرقة (إعلامياً وسياسياً وميدانياً) لتجريد المؤسسة من شرعيتها. والمفارقة أن هذا الراديكالي يعيش انفصاماً وظيفياً صارخاً؛ يلعن الكيان نهاراً، ويحتمي بظله ليلاً، يتقاضى رواتبه ويتظلّل بسقفه، في محاولة طفولية للجمع بين طهرانية الثائر ورفاهية المواطن. والمفارقة هي في أن السلطة تتشكل من وزارات متعددة وهيئات سيادية وثلاثة سلطات وإدارة حياة يومية واحتياجات متعددة من صحة وتعليم وبنية تحتية، وليست مقتصرة على الأمن فقط ليتم شيطنتها وتصوير هدمها كفعل تحرري.
ثانياً: مأساة البنّاء… الإعياء تحت وابل الشتائم:
يقف البنّاء الأصلي الذي يمثل نضال مكون رئيسي من الشعب في مشهد تراجيدي. جسدٌ أعياه العمل في ظروف مستحيلة تحت الاحتلال، بلا سيادة وبمواد ناقصة الصلابة. فلم يكن البيت قائماً أصلاً، بل كان محاولة شاقة للانتقال من العدم إلى حدٍّ أدنى من التنظيم السياسي. فإذا به لا يواجه العدو فقط، بل يواجه معاول القريب. إن بنى قيل مفرّط، وإن حمى قيل حارس للاحتلال. يقف اليوم عارياً من أدواته، محاصراً بإعياء النهج وخذلان الرفاق.
ثالثاً: ثغرة التحصين… مسؤولية البنّاء :
لكن المشهد لا يكتمل دون مواجهة البنّاء بمرآة مسؤوليته. فالبيوت لا تنهار فقط لأن المطارق قوية، بل لأن الجدران افتقدت أحياناً للإسمنت الأخلاقي. خطيئة البنّاء الكبرى كانت في تأجيل الإصلاح، والانشغال بجماليات السقف على حساب متانة القواعد: الناس، والعدالة، والمساءلة. إن ترهّل المؤسسات والصمت عن التصدّعات الداخلية جعل مطارق الراديكاليين تبدو في نظر البعض وكأنها أدوات إنقاذ. غير أن تفسير نشأة الراديكالية لا يعني تبرير نتائجها الكارثية.
رابعاً: البيت مِلكية جماعية لساكنيه :
المأزق الحقيقي يكمن في توهم البعض أن البيت مِلكية خاصة؛ وتعامل مع المنجز وكأنه إقطاعية يرممها كيفما شاء بمعزل عن المالك الحقيقي وهو الشعب، والراديكالي رآه حصناً للخصم يستحق الهدم. والحقيقة المغيبة أن هذا البناء هو “عقار سيادي مشاع” ورأسمال وطني دفع الشعب ثمنه من دمه وعمره. والتقصير في صيانة البيت لا يعطي الحق للراديكالي في إحراقه، لأن الحريق لن يلتهم الكراسي، بل سيلتهم الخارطة والهوية والحقوق القانونية للمواطن الذي لن يجد غداً مؤسسة تثبت حقه في أرضه أمام تغول المستوطن.
خامساً: العدو… المتربّص بحماقة الداخل:
في هذا الفراغ، يظهر العدو الذي لا يحتاج إلى عبقرية، بل إلى صبر. حين يرى أهل البيت يهدمون أعمدتهم بأيديهم، يتقدّم خطوة ليُتمّ الهدم ويتحرّر من التزاماته، متذرّعاً بانهيار الطرف الآخر وفقدانه لأدوات السيطرة. الراديكالي هنا لا يجرح خصمه، بل يخدمه؛ يتحوّل إلى محلل شرعي لجرائم العدو، يفتح الثغرة باسمه، ويترك للعدو شرف الضربة القاضية.
سادساً: دروس من مقبرة الشعارات الدولية:
التاريخ السياسي يعجّ بهذا النمط؛ من البلاشفة الذين أسقطوا جمهورية فبراير ثم وقعوا معاهدات تفريط سموها واقعية ثورية، إلى مانديلا الذي اتُهم ببيع القضية ثم تسابق شاتموه لوراثة هياكله. ليست المشكلة في التغيير الجذري، بل في الهدم الذي لا يعرف ماذا يفعل بعد السقوط.
سابعاً: وراثة الأنقاض وتقديس التلامذة:
الخاتمة هي الأكثر سخرية؛ حين ينهار البناء يخرج التلامذة لاحتلال الركام. أولئك الذين تربّوا على كره المؤسسة، يقفون اليوم فوق حطامها ليقنعوا الناس أن نصف الجدار المتبقي هو معقل التخندق. يحوّلون شتائمهم للبنّاء إلى قصائد مديح لصمودهم وسط الخراب، ويسمّون الثقوب في الجدران نوافذ الحرية.
ختاماً:
قمة الفجور السياسي أن تطلب من خصمك أن يظل قوياً بما يكفي ليحمل عنك أعباء الواقع، بينما تظل أنت نقياً بما يكفي لتلعنه في الخطب. فإذا سقط تحت ثقل مطارقك، لبست ثيابه الممزقة واتهمته بأنه لم يكن جديرًا بارتدائها.
التاريخ لا يرحم من هدم السقف فوق رأسه ليُثبت أنه ثائر، ولا الواقع يغفر لمن ورث الأنقاض بعد التباكي ثم ادّعى أنه هو من بنى القلعة. المخرج ليس في استبدال بنّاء بهادم، بل في استعادة ملكية “البيت” لصاحبه الحقيقي؛ الشعب، الذي يحمي منجزاته.