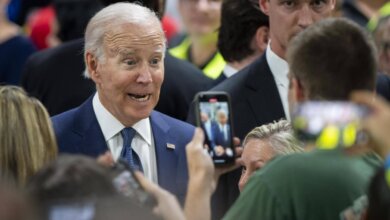فورين أفيرز- سارة يركس – نموذج تونس: دروس من ديمقراطية عربية جديدة

فورين أفيرز- سارة يركس*– تشرين الثاني (نوفمبر)/ كانون الأول (ديسمبر) 2019
قصة الكيفية التي بدأت بها الثورة التونسية معروفة جيداً. في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2010، قام بائع فواكه عمره 26 عاماً ويدعى محمد البوعزيزي من بلدة سيدي بوزيد بإشعال النار في نفسه خارج مبنى حكومي محلي. وأثار إحراقُه نفسه -في فعل احتجاج على سوء المعاملة المتكررة من الشرطة والمسؤولين المحليين- احتجاجات سرعان ما انتشرت في جميع أنحاء البلد. وفي غضون أسابيع قليلة، استقال الرئيس زين العابدين بن علي وهرب من البلاد بعد 23 عاماً قضاها في السلطة، مما أتاح لتونس فرصة غير مسبوقة للانفتاح الديمقراطي. وسرعان ما اكتسحت موجة هائلة من الانتفاضات جيران البلد، لتطال حتى بلاد الشام والخليج العربي.
أما القصة غير المعروفة بالمقدار نفسه، فهي ما حدث في تونس بعد ذلك. على الرغم من أن البلد أصبح المركز في انتفاضات الربيع العربي، سرعان ما طغت على انتقاله الأحداث الجارية في الدول العربية الأكثر سكاناً وذات الحكام الأكثر قسوة، والتي تحتفظ بروابط أعمق مع الولايات المتحدة. ولكن، بعد انقضاء ما يقرب من عقد على بدء الانتفاضة، ما تزال تونس تشكل قصة النجاح الوحيدة التي خرجت من الانتفاضات الكثيرة. ففي مختلف أنحاء العالم العربي، غرقت البلدان التي بدت وكأنها قد تسير على خطاها في دوامة الحرب الأهلية، كما حدث في ليبيا وسورية واليمن. وثمة بلدان أخرى عادت إلى القمع والاستبداد، مثل البحرين. وعلى النقيض من ذلك، قامت تونس بصياغة دستور تقدمي، وعقدت انتخابات حرة ونزيهة على المستويات الرئاسية والبرلمانية والمحلية. وفي تموز (يوليو)، عندما توفي الرئيس باجي قائد السبسي عن عمر ناهز 92 عاماً، كان الانتقال إلى حكومة مؤقتة سلساً لا يكاد يُلحظ. وثمة العديد من المشكلات التي ما تزال باقية والتي تعرقل مسيرة البلد، خاصة السجل الطويل من سوء الإدارة الاقتصادية والافتقار المقلق إلى الثقة في المؤسسات العامة. لكن مثال تونس يظل، على الرغم من كل الأعمال غير المكتملة التي ما تزال تواجه البلد، مصدراً للأمل في جميع أنحاء المنطقة.
بتحقيق هذا العمل الفذ، ساعدت تونس على تبديد الأسطورة القائلة إن المجتمعات العربية أو الإسلام غير متوافقة مع الديمقراطية. لكن قصة تونس تقدم أيضاً دروساً تتجاوز حدود العالم العربي: أن التحولات من الاستبداد تتطلب قادة شجعاناً مستعدين لوضع بلدانهم فوق الطموحات السياسية؛ وأن مثل هذه التحولات تكون بطبيعتها فوضوية وميالة إلى التوقف. وبالنسبة للمجتمع الدولي، يعني هذا أنه ينبغي تزويد الدول التي تمر بمرحلة انتقالية بالدعم الدبلوماسي -وقبل كل شيء، الدعم المالي الذي تحتاجه حتى تستطيع أن تتحمل الآلام المتزايدة للديمقراطية وأن تخرج بأقل قدر ممكن من الندوب.
الهزات الارتدادية للثورة
ورثت تونس ما بعد الثورة دولة في حالة يائسة. كان نظام بن علي فاسداً بشكل كبير. فقد سلب خزائن الدولة العامة وخبأ الأموال في حسابات مصرفية تخص زوجة بن علي، ليلى الطرابلسي، وعائلتها. كما فضلت الحكومة بعض المناطق الساحلية، وتجاهلت المناطق الجنوبية والداخلية من البلاد، حيث ستظهر الثورة في وقت لاحق. ولم تكن المنافسة السياسية موجودة، وتم حظر المعارضين المحتملين لحزب بن علي الحاكم، التجمع الدستوري الديمقراطي، إما مباشرة أو بإجبارهم على العمل تحت قيود بالغة الشدة بحيث يظلون مهمشين على الدوام. وتعرض أولئك الذين انتقدوا النظام للسجن والتعذيب.
لم يكن الافتراق عن هذا السجل الكئيب سهلاً. وفي السنوات الأولى بعد الإطاحة ببن علي، عانى البلد من نكسات خطيرة. كانت النقاشات حول دور الدين في الحياة العامة مثيرة للجدل والانقسام بشكل خاص. وكان نظام بن علي يفخر بنهجه العلماني والتقدمي تجاه حقوق المرأة في بلد يشكل فيه المسلمون السنة 99 في المائة من السكان. وعندما ظهرت حركة سياسية إسلامية شعبية، “حركة النهضة”، في الثمانينيات، قام بن علي بحظرها على الفور وبسجن عشرات الآلاف من أعضائها أو نفيهم. ولكن، عندما صوت التونسيون على جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد لما بعد الثورة في خريف العام 2011 -في أول انتخابات ديمقراطية يشهدها البلد- حصل حزب النهضة على أكبر عدد يمكن أن يجمعه حزب من أصوات الناخبين، مما أدى إلى نشوب معركة شرسة حول وجهة الانتقال. ومن بين أكثر القضايا إثارة للجدل كانت مكانة المرأة في الحياة المدنية والسياسية. وبالنسبة لحركة النهضة، كانت النساء “مكمِّلات” للرجال -لكن هذا المصطلح أغضب غير الإسلاميين، الذين كانوا يخشون أن تؤدي كتابته في الدستور إلى فتح باب خلفي للتمييز بين الجنسين. وقد ساد المنتقدون في نهاية المطاف. لكن عملية صياغة الدستور كشفت عن انقسامات مؤلمة داخل المجتمع التونسي.
سمح فوز حزب النهضة في انتخابات العام 2011 بتشكيل تحالف حكم ثلاثي مع حزبين علمانيين أصغر، وهو ما فرض ما يشبه النظام على فوضى ما بعد الثورة. ولكن تحت السطح، ظل الوضع غير مستقر، جزئياً، لأن العديد من العلمانيين كانوا يخشون من أجندة النهضة الإسلامية بقدر ما كانوا يخشون عودة إلى الاستبداد. وفي العام 2013، أدى الإحباط من الحكومة بقيادة النهضة إلى إثارة أزمة وطنية. في شباط (فبراير) من ذلك العام، قتل متطرفون إسلاميون زعيم المعارضة اليساري البارز، شكري بلعيد. وأثار الاغتيال فورة احتجاجات جماهيرية؛ حيث اتهم الكثيرون الحكومة بالتساهل في مكافحة التطرف العنيف. ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الإضراب العام الأول في البلد منذ العام 1978، والذي أدى إلى توقف الحياة في البلد لأيام عدة. وعندما اغتيل زعيم يساري آخر، محمد براهمي، بعد بضعة أشهر، تلت ذلك المزيد من المظاهرات واسعة النطاق. وأصبح المتظاهرون ينادون الآن بحل الجمعية التأسيسية.
كان من الممكن أن يؤدي اضطراب العام 2013 إلى إخراج كامل عملية الانتقال الديمقراطي عن سكتها. أما أنها لم تفعل، فقد عاد ذلك إلى حد كبير إلى عمل أربع منظمات مجتمع مدني قوية -الاتحاد العام التونسي للشغل؛ ونقابة المحامين في البلاد؛ وأكبر جمعية لأصحاب العمل فيها؛ ومجموعة لحقوق الإنسان- والتي اجتمعت معاً لإجراء محادثات في صيف العام 2013. ومثلت لجنة “رباعي الحوار الوطني”، كما عرفت المجموعة، دوائر انتخابية ذات اهتمامات متباينة إلى حد كبير، لكن أعضاءها سرعان ما اتفقوا على طريق للمضي قدماً؛ حيث دعوا إلى وضع قانون انتخابي جديد، وانتخاب رئيس وزراء ومجلس وزراء جديدين، واعتماد الدستور الذي تأخرت المصادقة عليه طويلاً. ثم توسطت اللجنة في إقامة حوار وطني بين الأحزاب السياسية الرئيسية. وأقنعت تلك المحادثات حزب النهضة بالتنحي وجلبت إلى السلطة حكومة جديدة من التكنوقراط. كما ساعدت اللجنة الرباعية أيضاً الجمعية التأسيسية على حل النقاط الشائكة في الدستور الجديد، وفي كانون الثاني (يناير) 2014، أقر النواب النص الجديد للدستور بالإجماع تقريباً.
لم تكن تلك المرة الأخيرة التي سمح فيها بناء ذلك الائتلاف لتونس ما بعد الثورة بتخطي لحظة من عدم اليقين. في أواخر العام 2014، عقدت البلاد أول انتخابات برلمانية ورئاسية حرة على الإطلاق. وكانت المنافسة نزيهة، لكن نسبة المشاركة -48 في المائة من الناخبين المؤهلين في الانتخابات التشريعية، و45 في المائة في الانتخابات الرئاسية- كانت منخفضة في ذلك الحدث الضخم، مما أوحى بأن تونس لم تكن الديمقراطية النابضة بالحياة التي كان الكثيرون يأملون بها. وبدا أن النتائج تهيئ تونس لمزيد من الصراع. كان السبسي؛ المرشح الرئاسي الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، عضواً علمانياً مكرساً لوقت طويل في نظام ما قبل الثورة، والذي خاض الانتخابات على برنامج مناهض لحركة النهضة بشكل واضح. وكان حزبه، “نداء تونس”، ائتلافاً فضفاضاً من الأحزاب غير الإسلامية والناشطين المتحدين في معارضتهم للجماعة الإسلامية، وبعض الآخرين.
وهكذا، أخذ السبسي الإسلاميين والعلمانيين معاً بالمفاجأة عندما قام، بعد وقت قصير من الانتخابات، بتشكيل تحالف مع حزب النهضة. وسرعان ما ظهر أن السبسي كان يجتمع لعقد محادثات سرية مع زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، في تطور لافت وغير عادي، بالنظر إلى أن السبسي كان وزيراً للخارجية في النظام السابق الذي سجن الغنوشي وعذبه. وبعَث تقاربهما المعلن رسالة قوية إلى الجمهور: لقد أصبحت أيام المنافسات السياسية المريرة شيئاً من الماضي. ويمكن لتونس ديمقراطية أن تستوعب قادة جميع الأطياف -إسلاميين وعلمانيين، ومحافظين وليبراليين.
مع ذلك، ظل التطرف العنيف يعكّر تقدم البلاد. أدت الهجمات الإرهابية التي وقعت في أوائل العام 2015، أولاً في متحف باردو الوطني بوسط تونس، ثم في منتجع شاطئي في سوسة، إلى مقتل 60 شخصاً، معظمهم من السياح الأوروبيين. ووجهت تلك الهجمات ضربة كبيرة إلى صناعة السياحة التونسية التي تسهم بنحو ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلد. كما أنها سلطت الضوء على حدة مشكلة تونس مع الأصولية الإسلامية. وجعلت فوضى السنوات الانتقالية المبكرة من الصعب على الحكومة التونسية التصدي لتجنيد المتطرفين، وخاصة في المناطق الداخلية المهمشة تقليدياً في البلاد. ومع ازدهار الديمقراطية من دون إحداث تغيير حقيقي في حياة التونسيين -حيث ظل الاقتصاد في حالة ركود وظل معدل البطالة مرتفعاً- شعر الكثيرون بأنه ليس لديهم ما يخسرونه إذا انضموا إلى صفوف الجماعات المتطرفة. وبحلول العام 2015، كانت تونس تحمل سمعة مزدوجة بكونها الديمقراطية الوحيدة في العالم العربي، وأكبر مصدِّر للمقاتلين الأجانب إلى العراق وسورية للعمل مع “داعش”.
وحتى تصبح الأمور السيئة أكثر سوءاً، تقاسمت تونس حدوداً نفّاذة مع ليبيا المجاورة؛ حيث سمحت حرب أهلية فوضوية لتنظيم “داعش” بأن يزدهر. ومن دون الكثير من المتاعب، كان بوسع المواطنين التونسيين عبور الحدود إلى ليبيا، والتدرب في معسكرات “داعش” هناك، ثم العودة إلى تونس لتنفيذ هجمات في الوطن -كما فعل مرتكبو هجمات باردو وسوسة. وحتى يومنا هذا، ما يزال المتطرفون يختبئون أيضاً في الجهة الأخرى من البلد، في المنطقة الحدودية الجبلية بين تونس والجزائر؛ حيث يقومون دورياً بشن هجمات صغيرة ضد قوات الأمن التونسية. وبفضل المساعدة الغربية، حسنت الدولة التونسية قدراتها في مجال مكافحة الإرهاب. لكن تونس، باعتبارها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، تحمل علامة مصلّب الهدف مرسومة على ظهرها. في الصيف الماضي، دعا كل من تنظيمي القاعدة و”داعش” مقاتليهما إلى إعادة تركيز انتباههم على البلد.
ساعدت المساعدات الخارجية تونس في عدد من المجالات، بما في ذلك مكافحة الإرهاب، ولكن يجب التأكيد أن الدافع الرئيسي للتغيير جاء من الداخل. قبل العام 2011، كانت علاقات الولايات المتحدة مع تونس غير موجودة تقريباً. ثم جاء الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى السلطة باحثاً عن بداية جديدة مع العالم الإسلامي، وأوضح أنها ليست لديه، على عكس سلفه، نيّة لفرض الديمقراطية على العالم العربي. ولكن، عندما اجتاحت الحركات الديمقراطية التي تقودها القواعد الشعبية المنطقة، كانت إدارة أوباما مصممة على حمايتها، في البداية على الأقل. فألقت بثقفها وراء الاحتجاجات، سواء على المستوى الخطابي أو المالي. وقامت وزيرة الخارجية الأميركية في ذلك الحين، هيلاري كلينتون، بزيارة إلى تونس بعد أقل من شهرين من رحيل بن علي للتأكيد على دعم الولايات المتحدة لعملية الانتقال. وقفزت المساعدات الأميركية لتونس من 15 مليون دولار في العام 2009 إلى 26 مليون دولار في العام 2011. وقدمت البرامج متعددة الأطراف مئات ملايين عدة من الدولارات أيضاً، مما رفع إجمالي المساعدات الأميركية إلى أكثر من 1.4 مليار دولار منذ العام 2011. (حاولت إدارة ترامب إجراء تخفيضات هائلة في كل واحدة من ميزانياتها المقترحة، بما يتماشى مع جهودها لخفض المساعدات الخارجية على مستوى العالم، لكن دعم الكونغرس الثابت أبقى المساعدات لتونس ثابتة). كما زاد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من دعمهم للبلد في الأعوام التي تلت الثورة، حيث قدموا 2.65 مليار دولار في الفترة من العام 2011 إلى العام 2017.
على الرغم من هذه المساعدة، ما تزال تونس تواجه العديد من العقبات الرئيسية. تبلغ نسبة البطالة بين الشباب حوالي 30 في المائة، والتضخم في ارتفاع. ومنذ الثورة، تضاعف معدل الانتحار تقريباً، وغادر البلد ما يقرب من 100.000 من العاملين ذوي التعليم العالي والمهارة. وقد تفوقت تونس مؤخراً على إريتريا لتكون الدولة صاحبة أكبر عدد من المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا عن طريق البحر. ولإبطاء هذا الاتجاه وتحسين التوقعات الاقتصادية للتونسيين، سوف تحتاج الحكومة إلى اتخاذ بعض التدابير غير الشعبية، مثل خفض الأجور في القطاع العام. وسيتطلب ذلك مواجهة النقابات العمالية القوية -وعلى وجه الخصوص، الاتحاد العام التونسي للشغل- التي شلت البلد في بعض الأحيان بالإضرابات الهائلة. لكن التقاعس سيؤدي فقط إلى تثبيط المقرضين الدوليين وتفاقم هجرة الأدمغة والهجرة الجماعية وتجنيد المتطرفين.
ويشكل إصلاح المؤسسات الحكومية المتكلسة أولوية أخرى. ما يزال الجهاز القضائي من دون إصلاح إلى حد كبير. وما يزال العديد من القضاة محتفظين بمناصبهم من عهد بن علي، ولا ينسجم الميثاق القانوني البيزنطي الحالي دائماً مع الدستور. ولعل الأكثر أهمية، هو أن البلد ما يزال يفتقر حالياً إلى وجود محكمة دستورية، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أن عدم تمكن المشرعين من الاتفاق على من يعينون كقضاة. وقد كافح أول برلمان منتخب ديمقراطياً، والذي ظل عاملاً من العام 2014 إلى تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بقوة من أجل إقرار التشريعات وعانى من نسب التغيب الشديدة، مع عدم تواجد حوالي نصف أعضائه في أي يوم معين.
لكن أهم عنصر على الأجندة هو استعادة ثقة الجمهور التونسي. في مطلع العام 2019، كان 34 في المائة فقط من التونسيين يثقون بالرئيس، و32 في المائة فقط يثقون في برلمانهم، وفقاً لاستطلاع أجراه المعهد الجمهوري الدولي. وعندما يتعلق الأمر بالتعبير عن مخاوفهم، يفضل الكثيرون منهم، وخاصة الشباب، الشوارع على صندوق الاقتراع. ويتم تنظيم حوالي 9.000 احتجاج كل عام، والتي ينطلق معظمها في نفس المناطق المهمشة تقليدياً حيث بدأت الثورة أول الأمر. وليس لهذه المشكلة حل سهل، لكن من شان نقل صلاحيات أكبر إلى المستوى المحلي أن يساعد. وكانت أول انتخابات محلية يشهدها البلد على الإطلاق، والتي أجريت في أيار (مايو) 2018، خطوة في الاتجاه الصحيح. ولم يقتصر الأمر على إدخال واحد من أكثر متطلبات المساواة بين الجنسين تقدماً في أي قانون انتخابي على مستوى العالم، حيث تم تخصيص 47 في المائة من مقاعد المجالس المحلية للنساء؛ لقد فتحت هذه الانتخابات الأبواب أيضاً أمام المرشحين الشباب؛ حيث ذهبت 37 بالمائة من المقاعد إلى فائزين تقل أعمارهم عن 35 عاماً.
بناء السفينة بينما تُبحر
يسارع التونسيون إلى الإشارة إلى أن بلدهم لا يوفر نموذجاً يمكن قصه ولصقه على السياقات الوطنية الأخرى. لكن تجربتهم تظل تنطوي على دروس مهمة حول كيفية دعم الديمقراطية. بالنسبة للغرباء، فإن الدرس الرئيسي هي إبقاء المرء نفسه على مسافة في البداية. لم تنجح تونس بفضل وجود أجندة مؤيدة للديمقراطية تقودها بلدان أخرى، وإنما بفضل غياب مثل هذا الجهد. فقد بدأت المرحلة الانتقالية بدعوة شعبية إلى التغيير، والتي تدخل المانحون الأجانب والشركاء الدوليون لدعمها في وقت لاحق. وجعل ذلك من الصعب على الحكومة نزع المصداقية عن الاحتجاجات بوصفها بأنها مشروع استعماري جديد مدفوع من الأجانب. ويجب على الولايات المتحدة وأوروبا، حيثما أمكن ذلك، السماح بحدوث تغيير محلي من دون تدخل سابق للأوان. وعندما ترسي التحولات الديمقراطية جذوراً، يجب أن تكون الحكومات الخارجية سريعة لتقديم الدعم المالي والتدريب. وفي الأماكن التي يبدو من غير المحتمل أن يظهر فيها التغيير من تلقاء نفسه، ينبغي على الجهات المانحة الأجنبية الاستفادة من المساعدات المشروطة وتوفير قدر أكبر من الأموال للبلدان التي تلبي بعض المؤشرات السياسية والاقتصادية. وتشكل “مؤسسة تحدي الألفية” ومبدأ الاتحاد الأوروبي، “المزيد مقابل المزيد”، وكلتاهما تكافئان البلدان على الإصلاح السياسي والاقتصادي، مثالين جيدين على هذا النهج.
من جانبها، يمكن للديمقراطيات الفتيّة أن تتعلم من النسخة التونسية من سياسة الإجماع. كان من الممكن أن يكون انتقال تونس قد فشل في العام 2013 لو لم يقم زعيمان، السبسي والغنوشي، بتقديم الديمقراطية والتعددية على طموحاتهما السياسية الخاصة. وغالبًا ما يقع قادة الديمقراطيات المتبرعمة تحت إغواء الانغماس في أنماط السلوك الاستبدادية وتعزيز أجنداتهم الخاصة عن طريق اكتناز القوة. وفي المراحل المبكرة من التحول الديمقراطي، يحتاج القادة إلى تقاسم الحيز السياسي وإعطاء الأولوية للتعددية على الاستبعاد، بحيث يكون هناك مجال كاف للمنافسة السياسية السليمة بمجرد استقرار الوضع.
وبالمثل، ينبغي للديمقراطيات في طور البناء أن تراعي القصة التحذيرية للجمعية التأسيسية في تونس. خلال السنوات الثلاث الأولى، عملت الحكومة الجديدة في تونس من دون دستور لتوجيه أعمالها. واليوم، بعد حوالي ست سنوات من المصادقة على الدستور، لم يتم تنفيذ الكثير منه. ما يزال يتعين تشكيل العديد من الهيئات التي كلف بها، مثل المحكمة الدستورية. ويبدو أن تونس تبني سفينة الديمقراطية وهي تبحر، الأمر الذي أدى إلى إحباط الجمهور وارتباكه. وسوف تُخدم البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية جيداً إذا هي وضعت قواعد اللعبة بوضوح منذ البداية، مع جدول زمني فعال وواقعي لتشكيل المؤسسات اللازمة لإنجاح الديمقراطية.
ومع ذلك، ثمة حدود لما يمكن للمرء أن يتعلمه من تونس. وعلى وجه الخصوص، لا تقدم تجربتها إجابة مرضية حول كيفية وضع تسلسل للإصلاحات السياسية والاقتصادية. فقد اختار القادة في تونس التركيز أولاً على التجديد السياسي، وصياغة دستور جديد، وإجراء انتخابات، وإنشاء المؤسسات السياسية. وأدى قيامهم بذلك إلى ترك الاقتصاد راكداً -والبلد بعقد اجتماعي محطم. وبالنسبة للعديد من التونسيين، لم يفِ النظام الجديد بالكرامة التي طالبوا بها في العام 2010، ونتيجة لذلك، لا يثق الجمهور في المؤسسات الديمقراطية الجديدة. لكن محاولة إصلاح الاقتصاد قبل مواجهة تحدي الإصلاح السياسي قد تكون لها نتائج عكسية. لم يكن ثمة ما يضمن أن القادة الانتقاليين سيظلون ملتزمين، بمجرد تحسن الاقتصاد، بالإصلاح الديمقراطي. وفي نهاية المطاف، تكون التحديات الاقتصادية حتمية خلال التحولات الديمقراطية، والحل الوحيد القابل للتطبيق هو أن يوفر الخارجيون شبكة أمان أقوى من خلال ضمانات القروض ودعم الميزانية والاستثمار الأجنبي المباشر على أمل الحفاظ على الدعم الشعبي للديمقراطية.
تظل تونس منارة الأمل للحركات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لكن الانتقال الديمقراطية الناجح لهذا البلد في أعين العديد من المستبدين في المنطقة ليس أكثر من مجرد قصة تحذيرية -لأن هناك حظوظاً أسوأ يمكن أن يواجهوها. ربما لا يبدو لهم التقاعد الإجباري لبن علي في المملكة العربية السعودية شيئاً يمكن أن يُحسد عليه -لكن من المؤكد أنه سيبدو أفضل من مصير بعض الذين رفضوا الرضوخ، سواء كان ذلك الموت على أيدي المتمردين (الليبي معمر القذافي)؛ أو رؤية الزعيم بلده وهو يسقط في دوامة سنوات من الحرب الأهلية والدمار والكوارث الاقتصادية (السوري بشار الأسد)؛ أو كليهما معاً (اليمني علي عبد الله صالح). وسوف تلوح هذه المصائر المتباينة بقوة في أذهان الحكام إذا واجهوا احتجاجات جماهيرية اليوم. وبالنسبة للعديد من الناشطين في المنطقة، توفر تونس ملاذاً آمناً يمكن الوصول إليه أسهل بكثير من أوروبا أو الولايات المتحدة -ومثالاً يحتذى للديمقراطية العربية.
*زميلة في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط، تركز أبحاثها على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في تونس بالإضافة إلى العلاقات بين المجتمع والدولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كانت زميلة زائرة في معهد بروكينغز وزميلة الشؤون الدولية بمجلس العلاقات الخارجية، كما درّست في برنامج الدراسات الأمنية بجامعة جورج تاون وفي كلية إليوت للشؤون الدولية بجامعة جورج واشنطن.
*نشر هذا المقال تحت عنوان :
The Tunisia Model: Lessons From a New Arab Democracy