د. علي الجرباوي يكتب في خضمّ ثلاثية القطبية الدولية
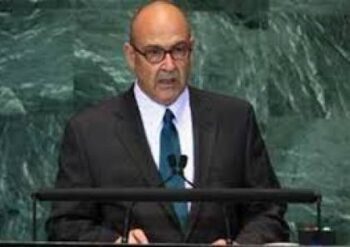
د. علي الجرباوي ١٢-٧-٢٠٢١م
أميركـا الـعائــدة
مع أن العُرف يمنح كل إدارة أميركية جديدة مدة عامٍ لنشر الوثيقة التي تُحدد رؤيتها الإستراتيجية للأمن القومي للبلاد، إلا أن إدارة الرئيس بايدن سارعت لنشر «وثيقة مؤقتة» تحدد بموجبها الخطوط العريضة لهذه الرؤية، وذلك بعد مجرد مرور خمسة وأربعين يوماً على تسلّمها السلطة (3/3/2021)، على أن يتم نشر الوثيقة الكاملة والمنقحة لاحقاً. يعود أمر استعجال النشر إلى سببين. أولهما، أن الإدارة الجديدة كانت معنيّة بإحداث قطيعةٍ سريعة مع التوجهات الإستراتيجية لإدارة ترامب، والتي كان أُعلن عنها في نهاية العام 2017. فتوجهات الرئيس بايدن تختلف في مجال السياسة الخارجية ومعالجة الشؤون الدولية جذرياً عمّا كانت عليه توجهات الرئيس ترامب، والتي تلومها الإدارة الجديدة على ما حاق بوضعية أميركا العالمية من أضرارٍ جسيمة. لذلك، كان ضرورياً أن تُعلن هذه الإدارة سريعاً عن تخلّصها من «إرث ترامب»، وانزياحها الكامل نحو رؤيةٍ ومسارٍ جديدَين، يعملان على تهدئة الداخل الأميركي وطمأنة العالم بـ «عودة أميركا» إلى استعادة مكانتها ودورها الريادي التقليدي على الصعيد الدولي.
أما السبب الثاني فهو استشعار الإدارة الجديدة ليس فقط بتردي أوضاع البلاد داخلياً، ومكانتها خارجياً، فحسب، وإنما بتصاعد عدد وحِدّة التحديات التي تواجهها، والتي أضحت تهدد استمرار حفاظ أميركا على موقعها القيادي والريادي في العالم. فعدا القضايا الشائكة التي فجّرها ترامب داخلياً، وأدّت إلى تصاعد التشققات والاستقطاب داخل المجتمع الأميركي، فإن الوثيقة تأتي على ذكر آثار جائحة وباء «كورونا»، وتغيّر المناخ العالمي، وصعود الاتجاهات القومية في العالم، والتنافس في المجال التكنولوجي، كتحدياتٍ أساسية تواجه البلاد حالياً وفي المستقبل. ولكن التحدي الأهم الذي يواجه أميركا، بالنسبة لإدارة بايدن، يأتي من قوى عالمية تعديلية، هي الصين وروسيا، وأخرى إقليمية، كإيران وكوريا الشمالية. فهذه الدول ذات النظام السياسي السلطوي، وفقاً للرؤية الأميركية، تحاول تقويض مكانة الولايات المتحدة في العالم، وتستهدف هدم استقرار وانفتاح النظام الدولي الحالي، وتسعى لإحلال نفسها على قمة هرم نظام دولي جديد تابع لها، يطيح بالديمقراطية وبريادة الديمقراطيات الغربية للعالم.
واضح من «وثيقة الأمن القومي الأميركي المؤقتة» أن مصدر القلق الأساسي والرئيسي للولايات المتحدة يأتي من الصين. فالصين، بالنسبة لإدارة بايدن هي القوة الوحيدة التي تمتلك من القدرات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية ما يؤهلها أن تكون المنافس لأميركا، وأن تشكّل التحدي الجدّي الدائم لاستمرارية استقرار واستمرار النظام الدولي الحالي، ما يفرض على الولايات المتحدة ضرورة مواجهتها بكل عزيمة وتصميم. فاستمرار تفوّق أميركا، واستمرار احتفاظها بقيادة النظام الدولي، يتوقف على قدرتها على ضبط الصعود الصيني، ومنع الهيمنة الصينية على العالم. أما القوة العالمية الثانية، روسيا، فمع أنها لا تمتلك من القدرات ما يؤهلها لتكون منافسة لأميركا، إلا أن ما تملكه من قوة عسكرية وسيبرانية، يؤهلها لأن تكون «مصدر إزعاج» لاستقرار النظام الدولي الحالي، ويتطلب من أميركا العمل على احتوائها والحدّ من هذا «الإزعاج».
تشير ثنايا الوثيقة إلى أن سياسات الإدارة السابقة، التي رفعت شعار التفرد الأميركي، وضربت أسس العمل الجماعي الدولي، وقامت بتفكيك التحالفات التقليدية للولايات المتحدة التي تعتمد عليها متانة النظام الدولي، وتغييب أميركا عن لعب دورها القيادي على المسرح العالمي، هي بمجملها التي سمحت بتفشي حالة من الفوضى في العالم. وهذا ما أتاح المجال لقوى معادية أن تستغل التراجع الأميركي لشنّ حملة تقويض للقيم والمصالح الأميركية، ولطرح نفسها كقيادة بديلة للعالم. ولكن الوثيقة تشير أيضاً إلى أن هذا التراجع ليس أمراً نهائياً وقطعياً لا رجعة فيه، بل هو أمر طارئ ومؤقت يمكن استدراكه ومعالجته وتلافيه، وتعافي الولايات المتحدة منه، بحيث تعود للقيام بدورها الريادي السابق في قيادة العالم. ومن هذا المنطلق تحدد الوثيقة معالم خارطة الطريق التي ستتبعها الإدارة الجديدة لتحقيق ذلك.
تُشدد الوثيقة على تلخيص جميع الإجراءات، المباشرة وغير المباشرة، التي يتوجب على أميركا اتخاذها لمحاصرة الصين والحدّ من نفوذها. ولكن لكي يطال هذه الإجراءات النجاح، فإن على أميركا أن تستعيد موثوقية العالم بها، وخصوصاً من حلفائها التقليديين. ومن منطلقٍ فكريٍّ ليبراليّ، ترتكز رؤية إدارة بايدن على مبدأ يتلخّص بأن «قوة أميركا في الخارج تنبع من قوتها في الداخل». ولذلك تُفسح الوثيقة مساحة وافية تُركّز فيها على ضرورة معالجة مواطن الخلل الداخلي في البلاد، ورأب صدع التشققات بين فئات المجتمع المختلفة، مع التركيز على تدعيم توسيع الطبقة الوسطى، وإعادة الاعتبار والثقة لأهمية وفاعلية وضرورة الديمقراطية لتعود لتكون المرتكَز القيمي والأساس العملي المكوّن لقناعات الأميركيين، إذ كيف يمكن إقناع الآخرين في الخارج بجدوى الديمقراطية إن لم يكن الداخل الأميركي مقتنعاً بها ودالاً على ذلك؟ ومع إعادة تفعيل الديمقراطية في الحياة السياسية الأميركية، تُركّز الوثيقة على أهمية تنشيط اقتصاد البلاد ورفع قدرتها الإنتاجية، وضخّ الموارد اللازمة للتأكد من الفوز بالمنافسة العالمية المفتوحة في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي، والتركيز على ضمان الأمن السيبراني للبلاد. باختصار، على أميركا أن تعود بلداً نشطاً ومنتجاً ومنفتحاً ومتسامحاً، لتسترد عند الآخرين قيمة «الحلم الأميركي»، وتُشكّل لهم من جديد الأنموذج المُبتغى.
لما سبق، تعتبر الوثيقة أن تجديد مواطن قوة أميركا، وعرض مزاياها التي تجعل منها بلداً مُفعماً بالحيوية والنشاط ودينامية السعي الإيجابي لتحسين نوعية الحياة البشرية، وخصوصاً في مساعدة العالم على تخطي ما لحق بع من أضرار جرّاء جائحة وباء «كورونا»، أمر أساسي وضروري لإعادة الاعتبار لمكانة أميركا في العالم. ومن ترميم الوضع الداخلي الأميركي، تنطلق رؤية إدارة بايدن لـ «إستراتيجية الأمن القومي المؤقتة» إلى الخارج، لإعادة بناء التحالفات والشراكات الأميركية الضرورية للعودة إلى قيادة المنظومة الديمقراطية الجماعية للنظام الدولي. وفي هذا السياق، تُعرب الإدارة عن نواياها بتعزيز التعاون مع بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي ومنظومة دول حلف شمال الأطلسي، ومع أستراليا ونيوزيلندا واليابان وكوريا الجنوبية، ومع جارتَيها كندا والمكسيك. فالعلاقات مع جميع هذه الدول كانت تضررت خلال فترة إدارة ترامب، ما يتوجب اتخاذ الخطوات الكفيلة بإعادة بناء الثقة مع هؤلاء الحلفاء لمواجهة الخطر الصيني المتصاعد. ولكي يكتمل مسعى مواجهة الصين وحصار صعودها، تُعرب إدارة بايدن عن توجهها لتعزيز التعاون مع جارات الصين، كالهند وفيتنام وسنغافورة. يُضاف إلى ذلك إعلان هذه الإدارة عن اهتمامها بإقامة شراكات جديدة في أفريقيا التي تشهد تغلغلاً للنفوذ والمصالح الصينية، وتوجهها لتهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، تأكيداً على قرارها بنقل محور اهتمامها إلى منطقة المحيط الهادي – الهندي، لتكون أقدر على التركيز على مواجهة الصين من جوارها.
تَعِد الوثيقة باستمرار تحديث القدرة العسكرية لتبقى البلاد محافظة على تفوقها في هذا المجال، مع إرسال رسالة واضحة بأن إدارة بايدن لن تتوانى عن استخدام القوة للدفاع عن المصالح الأميركية إذا اقتضت الضرورة ذلك. ولكن توضّح الوثيقة أيضاً أن أصبع هذه الإدارة ليس على الزناد، بل هي تُعلن بأنها ستُنهي، ولن تخوض، الحروب المفتوحة، وستعتمد عوضاً عن ذلك الوسائل الدبلوماسية، التي ستوظفها ليس في علاقاتها الثنائية فحسب، وإنما أيضاً في عودتها النشطة للمؤسسات الدولية، وانخراطها المكثّف في الشؤون الدولية، وفي تعزيزها للتعاون الدولي. ولإعطاء الانخراط الفاعل مجدداً في السياسة الدولية معنى وقيمة إيجابية، ولتعود قيادة أميركا للعالم تحظى بالمقبولية والمصداقية، فإن احترام المُثل العليا لحقوق الإنسان، والدفع بقيم الديمقراطية في أرجاء العالم، ستكون مكوّناً أساسياً للسياسة الخارجية الأميركية. وبالطبع، فإن إعادة الاعتبار لهذه المُثل والقيم سيُشكّل مدخلاً ملائماً لتوجيه النقد الدائم للصين وروسيا.
مع أن وثيقة «إستراتيجية الأمن القومي المؤقتة» التي أعلنتها إدارة بايدن مبكراً اعتبرت أن الصين تُشكّل التهديد الإستراتيجي الأكبر للولايات المتحدة والعالم الحر والنظام الدولي الحالي، إلا أنها تركت الباب موارباً لإمكانية التعاون معها حين يتلاءم ذلك مع المصالح الأميركية. أما بالنسبة لروسيا فكانت الأولوية الأميركية تتمثّل بضبط قدراتها العسكرية، وخاصة النووية. لذلك أشارت الوثيقة بإيجابية لسرعة الإدارة بتجديد معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية مع الكرملين.
ما يمكن استخلاصه من رؤية إدارة بايدن الإستراتيجية لمرتكزات الأمن القومي الأميركي أن العالم يمرّ في خضم صراع ثلاثي القطبية، وأن الصين تُشكّل الخطر الإستراتيجي الأكبر على البلاد، يليها بالأهمية روسيا التي ترتكز بالأساس على قدرتها العسكرية، وخاصة النووية، في هذه المواجهة ثلاثية الأضلاع. ومع التحديات الجسام التي تواجه أميركا، إلا أن هذه الوثيقة تُقدّم رؤية تفاؤلية بالقدرة الأميركية على تخطيها بنجاح، وبالتالي استعادة مكانة ودور القيادة الأميركية للعالم.
وفي نهاية الأمر، فإن المهم في الأمر لا يكمُن في الإعراب عن النوايا، وإنما في القدرة الفعلية على تحويلها إلى واقع.
روسيا المنزعجة
قد يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتظر حتى يسبر غور نوايا الرئيس الأميركي جو بايدن خلال اجتماعهما في جنيف منتصف حزيران الماضي، قبل أن يقوم في الثالث من تموز بالمصادقة على «نسخة منقحة من استراتيجية الأمن القومي لروسيا»، ويُصدّرها بموجب مرسوم رئاسي.
أما متضمنات هذه النسخة من توجهات عامة بشأن حماية الأمن القومي للبلاد، فتبني على ما جاء في الوثيقة الاستراتيجية الأُم بهذا الشأن، والتي كانت صدرت عن الكرملين في آخر يوم من العام 2015، آخذةً بالاعتبار ما جرى في العالم من أحداثٍ وتطوراتٍ خلال فترة الأعوام الخمسة ونصف العام التالية.
وتتضمن هذه «النسخة المنقحة» الرؤية الروسية المستجدة لوضع العالم حالياً، والصراع الدائر بين أقطاب النظام الدولي، ودور روسيا فيه، وخصوصاً ما يتعلّق بكيفية درء المخاطر عنها، والمحافظة على مصالحها الحيوية.
ترسم «النسخة المنقحة» صورة سوداوية قاتمة لواقع روسيا حالياً، وذلك جرّاء ما يعتبره الكرملين استهدافاً منهجياً مقصوداً ومبرمجاً من قبل الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، الذين يعرّضونها لمخاطر أمنية وتحديات اقتصادية ضاغطة تستهدف إضعاف قدرات البلاد، وتفكيك تحالفاتها، وتقويض مكانتها الدولية.
وتتهم الوثيقة الجديدة «جهات خارجية»، والمقصود هنا الولايات المتحدة وحليفاتها الغربية، بالقيام بحملة لإضعاف تكوين الدولة الروسية من الداخل، وتدمير وحدتها الوطنية، وتفتيت المجتمع الروسي من خلال دعم حركات معارضة هامشية، وتأجيج الصراعات العرقية والدينية.
يُضاف إلى ذلك، قيام هذه الجهات بمحاولات لتدمير الذاكرة التاريخية للشعب الروسي، وتشويه تاريخ البلاد، وتقزيم إسهاماتها في مجرى التاريخ العالمي، وضرب أسس البنية الثقافية الروسية، والسعي للتسلل إلى وعي الشباب وتغريب ثقافتهم. وبالتالي، تُعرب «النسخة المنقحة» عن قناعة رسمية بأن روسيا تتعرض لعملية تشويه وتفكيك منظمة، تستهدف إضعاف الدولة والسيطرة عليها من الداخل. يضاف إلى هذه الحملة على روسيا من داخلها، تشير الرؤية الروسية الرسمية إلى استهداف آخر للبلاد من خارجها.
فمنظومة الدول الغربية ما فتئت القيام بمحاولات مستمرة لتفكيك كومنولث الدول المستقلة، مستهدفةً تخريب علاقة روسيا مع حلفائها التقليديين.
كما يقوم حلف الناتو بحملة منهجية للزحف بقواعده باتجاه الحدود الروسية، ويمدد عضويته لدولٍ كانت في السابق جزءاً من الاتحاد السوفياتي، ويقوم باستعراض عضلات قوته في البحر الأسود، ما يضع البلاد تحت تهديد عسكري مباشر، ويُعرّض الأمن القومي الروسي للخطر، وخاصة في مجال استهداف أمنها السيبراني.
ناهيك عمّا تتعرض له البلاد من عقوبات اقتصادية تستهدف إضعاف بنيتها وقدرتها الإنتاجية. باختصار، تعتبر روسيا الرسمية أن البلاد مستهدفة من قِبل المنظومة الغربية، التي تسعى جاهدة لاحتواء روسيا وتقزيم مكانتها الدولية ودورها العالمي، وذلك حفاظاً على السيطرة الغربية على النظام الدولي الحالي، وعلى الهيمنة الغربية على العالم. هذه هي «المظلمة» التي تعرضها النسخة المنقحة من «استراتيجية الأمن القومي لروسيا».
من بوابة الحفاظ على الشعب الروسي ومصالحه القومية العليا، وعلى قيمه الروحية والثقافية، وحماية الدولة الروسية، تطرح «النسخة المنقحة» رؤية متكاملة لكيفية مواجهة هذا الاستهداف الأميركي – الغربي.
وتنطلق هذه الرؤية من قناعة روسية رسمية بعدم توقع حدوث انفراجة في العلاقات بين الطرفين في المدى المنظور.
بل على العكس تماماً، إذ يذهب التقدير الروسي باتجاه أن تصعيد التوتر مع روسيا سيبقى هدفاً استراتيجياً للمنظومة الغربية.
وعلى هذا الأساس، تتمحور استراتيجية الأمن القومي المُعدّلة حول اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات المتشابكة لتحديد الأولويات والمصالح التي يجب تضمينها في تشكيل منظومة ردعٍ تقي البلاد مما تتعرض له من استهداف خارجي. ما يعنيه ذلك أن هذه الاستراتيجية هي دفاعية بالأساس، تستند إلى تفعيل الاعتماد على الذات، وتستهدف الحفاظ على مكتسبات البلاد وتكثيفها، لتتمكن روسيا من فكّ العزلة الموجهة ضدها، والبقاء طرفاً فاعلاً في ساحة المنافسة الدولية.
تولي الوثيقة اهتماماً واضحاً لمعالجة الأوضاع الداخلية في البلاد، ما يعني اعترافاً ضمنياً بوجود ثغرة مهمة يمكن استخدامها لنفاذ الجهات الخارجية، وتوظيفها لاختراق البلاد.
لذلك يقع على رأس الأولويات الاستراتيجية الروسية مهمة تمتين الجبهة الداخلية، والتصدي الفعال لمحاولات الاختراق الغربية، وذلك من خلال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان، وتنمية الروح الإنسانية والجماعية داخل المجتمع الروسي، وخاصة بين الشباب، والحفاظ على القيم وتعزيز تماسك الأسس التقليدية للثقافة الروسية، وتكثيف الاهتمام بالمحافظة على اللغة الروسية وتوسيع انتشارها.
ولكن ترجمة هذه النزعة الحمائية إلى واقع ستكون مهمة أصعب بكثير من مجرد إيرادها كهدفٍ استراتيجي، وخصوصاً مع تداعيات الانفتاح العولمي وتأثيراته على الدول والمجتمعات.
سيكون أسهل على روسيا تحقيق الهدف الاستراتيجي الثاني، وخصوصاً أنه يقع في المجال الذي تبرع في التفوق فيه، وهو تعزيز إمكانياتها العسكرية التقليدية، وبناء قدرة ردعٍ استراتيجي تعتمد بالأساس على تطوير قدرتها النووية.
هذا أمر تعتبره روسيا أولوية ضرورية لمواجهة ما يحيق بها من مخاطر من قِبل حلف الناتو، كما يعطيها قدرة للمناورة على الصعيد العالمي من خلال عمليات تزويد الأسلحة للدول الأخرى. ويتقاطع مع هذا المجال وجود هدف استراتيجي آخر، يتمثل باعتبار الأمن السيبراني للبلاد أولوية قصوى، لما تتعرض له موارد معلوماتها لهجمات قرصنة غربية المنشأ.
وقد يكون الاهتمام بتحصين هذه الموارد خطوة استباقية لما تتوقعه روسيا من تفاقم «الحرب» السيبرانية مع الدول الغربية، وخاصة مع أميركا، خاصة أن الأخيرة تتهمها بالقيام بهجمات سيبرانية على مصادر المعلومات الأميركية، وتنذرها بالرد المماثل.
وتولي الوثيقة أهمية كبرى لهدف تحصين القطاع الروسي من شبكة المعلومات العنكبوتية العالمية (الانترنت)، وحمايته من إمكانية وقوع أنشطته تحت سيطرة أجنبية، تقوم باستغلاله لبثّ دعاية غربية مضللة ومشوهة للحقائق عن روسيا، وللدرجة التي تُعلن فيها الوثيقة عن إمكانية التوجه نحو تطوير نظام معلوماتية وطني منفصل عن الشبكة العالمية، ليحمي استقلال البلاد ويصون سيادتها.
أما في مجال تحسين القدرة الاقتصادية لروسيا، الذي يشكّل هدفاً استراتيجياً رابعاً، فالمهمة تبدو صعبة كون الواقع الاقتصادي الحالي للبلاد يواجه العديد من التحديات الجسام.
تشير الوثيقة إلى توجه استراتيجي نحو ضرورة التخلّص من الاعتمادية على النفط مصدراً أساسياً للاقتصاد، والتوجه نحو تنويع وتنشيط مصادر أخرى تنعش وتقوّي اقتصاد البلاد، وتزيد من مزاياه التنافسية عالمياً.
ومن أجل تحقيق ذلك، تشير الوثيقة إلى أهمية زيادة الاستثمارات في قطاعات جديدة، وخاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وضرورة استقطاب علماء من داخل وخارج البلاد للعمل على توسيع رقعة وكفاءة القطاع التكنولوجي، وخاصة ما يتعلق بتطوير جوانب الذكاء الاصطناعي.
إلى جانب هذه الأهداف الطموحة التي تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي سنوي في المستقبل أعلى من معدل مثيلاتها في العالم، تعلن الوثيقة عن توجه روسيا لتقليص اعتمادية تجارتها الخارجية على عملة الدولار، والتوجه نحو استبدالها تدريجياً بعملة اليورو الأوروبية وباليوان الصيني.
هدف هذا التوجه هو إضعاف الدولار، وتقليص الهيمنة الأميركية على التجارة الدولية.
وأخيراً، تؤكد «النسخة المنقحة» الموقف الروسي المعلن سابقاً تجاه النظام الدولي الحالي، أحادي القطبية، والذي تهيمن من خلاله أميركا عليه وعلى مسرح الشؤون الدولية.
تعارض روسيا استمرار هذا النظام، وهي تطالب وتسعى لتحويله إلى نظام متعدد الأقطاب، لأن ذلك يضمن لها دوراً حيوياً مشاركاً ابتدأت بفقدانه بعد تفكك الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفياتي.
لذلك تطالب روسيا بتعزيز دور المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها هيئة الأمم المتحدة، لما تمنحه لها العضوية الدائمة في مجلس الأمن من مكانة متساوية مع مكانة الولايات المتحدة، ومن إمكانيات لعب دور مهم على الساحة الدولية.
وفي هذا السياق، تعلن روسيا عبر الوثيقة الجديدة عن توجهها الثابت لتعزيز روابط التعاون الدولي، والتي تجمعها بعلاقات وثيقة مع عديد من دول العالم، وتعد بمساعدة هذه الدول على حماية سيادتها واستقلالها في مواجهة التدخلات الغربية.
كما تعرب في الوثيقة عن نواياها بتمتين علاقاتها التعاونية مع الصين والهند كقطبين رئيسين صاعدين على الصعيد العالمي، ما يفتح المجال أمام تكوين تعددية قطبية تنهي احتكارية أميركا وهيمنتها على النظام الدولي.
آمال عريضة بمستقبل واعد تحملها «النسخة المنقحة من استراتيجية الأمن القومي لروسيا»، مقابل واقع سوداوي متشائم لما ترسمه نفس هذه الوثيقة لواقع روسيا المستهدفة من المنظومة الغربية حالياً.
والسؤال الذي يبقى مفتوحاً وبرسم الإجابة هو: هل تملك روسيا من القدرة والإمكانية ما هو ضروري ولازم لتحقيق هذه الرؤية، أم أن مقدرتها على المنافسة كقوة دولية عظمى تضاءلت وأصبحت مجرد محصورة فقط في قدرتها على إزعاج الآخرين؟
الصين الواثقة
بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، ألقى الرئيس شي جين بينغ في 30/6/2021 خطاب تحدٍّ أبرز فيه ما حققته بلاده بقيادة الحزب من إنجازات داخلية هائلة، نقلت الصين من دولة فقيرة ومنتهَكة الحقوق، إلى أن تصبح دولة قوية وقادرة، وفي طريقها للوصول إلى قمة هرم النظام الدولي. وأكدّ شي على ديمومة وتصاعد أعمال النهضة التي حققتها بلاده، معتبراً أن الصين انطلقت في «مسيرة تاريخية لا رجعة فيها». وبنبرة الواثق والحازم الذي يعكس مشاعر الفخر الوطني للصينيين على ما حققوه من تقدمٍ مشهودٍ لبلادهم خلال فترة زمنية قصيرة، أطلق الرئيس الصيني تحذيراً حادّاً جاء بصيغة عامة مفتوحة، ولكن يُستشف منه أن المقصود به هو الولايات المتحدة، ينبّه فيه أن زمن التنمّر على الصين قد انتهى للأبد. ومن خلال استذكاره ما عانته بلاده من استعمار غربي وحروب أفيونٍ واحتلال ياباني، خلال فترة ما أصبح يُعرف بـ «قرن الإذلال» (1839-1949)، استخلص شي أن «الزمن الذي كان يمكن فيه أن يُداس الشعب الصيني وأن يعاني وأن يُضطهد… قد ولّى إلى غير رجعة». وبصيغة تقريرية، وجّه الرئيس الصيني تهديداً صريحاً ومباشراً لمستهدِفي الشعب الصيني بأنه «لن يُسمح لأي قوة أجنبية بالتسلط عليه أو قمعه أو إخضاعه»، ليس هذا فحسب، وإنما ذهب في تصعيده إلى توعّد «كل من يجرؤ على القيام بذلك ستُسحق رأسه وتُخضّب بالدماء على سور الفولاذ العظيم الذي صنعه ما يربو على 1.4 مليون صيني».
مع أن هذا الوعيد الواضح يبدو صارخاً، إلا أنه لا يخرج عن سياق شعور الصين المتزايد بالثقة بنفسها وبقدراتها، وهو شعور ابتدأ بالظهور للعلن مع تسلّم الرئيس شي لمقاليد الحكم عام 2013، وترسّخ في التقرير الذي قدّمه للمؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في 18/10/2017، والذي اعتُمد وثيقة إستراتيجية تُحدد أولويات الأمن القومي الصيني منذ ذلك الحين. في ذلك التقرير، أعلن شي أنه، بخلاف الوضعية سابقاً، لم يعد ضرورياً للصين الاستمرار بمداراة طموحها والتستر على مسيرة صعودها، إذ إن لديها الحق والقدرة عن الإعلان عن نواياها في «تحقيق حلم الصين المتمثل بالنهضة العظيمة للأمة الصينية بكل قوة وشجاعة، وعصر اقتراب بلادنا من صدارة المسرح الدولي يوماً بعد يوم، وتقديم إسهامات أكبر للبشرية».
لم يعد سرّاً، إذاً، أن الصين دخلت معمعان المنافسة على صدارة النظام الدولي، متحدية بذلك المنظومة الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. المهم في الأمر أنها وهي تُعلن عن ذلك صراحةً فإنها، بخلاف روسيا، تمتلك من المقدرات والإمكانيات ما يؤهلها ليس فقط لخوض هذه المنافسة، وإنما يمكّنها من احتمالية قوية للفوز فيها. فالصين تمتلك مخزوناً حضارياً ممتداً لآلاف السنين، مع إيمان عميق وقناعة راسخة عند الصينيين بمحورية مكانتهم في العالم، وقوة ثقافتهم، وإيجابية منظومتهم القيمية، المستمدة من متانة أيديولوجيتهم المركّبة من تزاوج عناصر محفِزّةٍ من الكونفوشية والطاوية والماركسية – اللينينية والماوية. يقف هذا الإرث الغنيّ دافعاً للصينيين للإيمان بأنهم حملة رسالة مفادها أن عليهم تقع مسؤولية محاولة تحسين العالم، من خلال قيادة مشروع سلمي تشاركي وتعددي، تتلاقى فيه الثقافات، وتتلاقح في إطاره الحضارات، ليحقق السلام والأمان والرخاء للجميع.
إضافة إلى ذلك، تمتلك الصين مقدرات مادية ضخمة ووافرة، فلديها أكبر مخزونٍ بشري في العالم، بما يمنحه ذلك لها من إمكانيات طاقة بشرية منتجة وخلاقة. وهي رابع دولة في العالم من حيث المساحة، ما يوفّر لها الكثير من المصادر الطبيعية. أما موقعها فهو إستراتيجي فيما يتعلق بخطوط التجارة الدولية، وخاصة البحرية. وفوق كل ذلك، حوّلت الصين نفسها خلال فترة أقل من نصف قرن إلى ثاني أكبر اقتصادٍ في العالم، وهي ستوازي أميركا في المرتبة الأولى، وقد تتخطاها، مع نهاية هذا العقد. ومع أن حجم الاقتصاد مسألة في غاية الأهمية، إلا أن ما يفوق ذلك بالاعتبار هو ما يتعلق بنوعية الاقتصاد، والاقتصاد الصيني أصبح جزءاً مندمجاً في الاقتصاد العالمي، ولا يتجزأ عنه. بل على العكس، توجد درجة عالية من الاعتمادية بين اقتصاد الصين واقتصاد العالم، بما فيه الاقتصاد الأميركي. باختصار، لم يعد بالإمكان دوران عجلة الاقتصاد العالمي دون المشاركة الصينية فيه.
أتاحت العوائد العالية للصين من اقتصادها المزدهر فتح المجال أمامها لتسريع عملية بناء قواتها المسلحة، والتي تُعلن الصين أنها ستكون في أعلى المراتب العالمية، كفاءة وتجهيزاً، بحلول منتصف القرن الحالي. هذا يعني، وكما ورد في تقرير الرئيس شي، أن البلاد تتجه بثقة لتحقيق مصيرها بأن تكون دولة عظمى بحلول منتصف القرن الحالي، وأن لا قوة في الدنيا تستطيع منع الصين من تحقيق مصيرها.
تقوم رؤية الصين لدورها العالمي على القناعة بعدة مبادئ أساسية. أولها، مبدأ التعددية الذي بموجبه تؤمن بكين بعدم وجود سبيل واحد لتحقيق التنمية والرخاء في العالم، بل بوجود عدة سبل. ما يعنيه ذلك أن الصين تتحدى الرؤية الغربية التي سعت دائماً لفرض نموذج التحديث الغربي كسبيل إجباري وحيد على بقية العالم، ما يعني إبقاء الدول غير الغربية تلهث في عملية لحاق مستمر لغربٍ متفوقٍ عليها بشكل دائم. على عكس ذلك، تطرح الصين نموذجها الذي أوصلها إلى ما هي عليه الآن من تقدّم، والقائم على «الاشتراكية ذات الخصائص الصينية»، الذي يمزج بين عناصر من تحرير الاقتصاد واشتراكية النظام السياسي، كخيارٍ متاح لمن يرغب في العالم أن يتبناه، دون فرضٍ أو إكراه. يستهدف هذا الطرح، الذي يُقدّم بديلاً للنموذج الغربي للتحديث فكفكة الهيمنة الغربية، بقيادة أميركا، على العالم، وتقويض احتكار الحضارة الغربية لمعايير التقدم والحداثة العالمية.
أما ثاني المبادئ فهو الجماعية، إذ تشدد الرواية الصينية على أهمية تحقيق «الفوز المشترك» للجميع، وليس تحقيق فوزها على الجميع. لذلك يشدد الخطاب الصيني على التزام بكين بالسعي الدائم لتحقيق الانسجام والتناغم والتعاون بين دول العالم، في سبيل تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار المشترك للجميع. من هذا المنطلق تدعو الصين لنظام دولي جديد يكون قائماً على العلاقة الأفقية التي تتساوى بموجبها جميع الدول، كبيرها وصغيرها، ليحلّ مكان النظام الدولي الحالي القائم على عمودية وهرمية العلاقة، يقبع على رأسه أميركا وحليفاتها الغربية، التي تتحكم بغيرها من الدول التي تقلّ عنها في المنزلة التراتبية، وصولاً لقاع الهرم. ولذلك، تُشدد الرؤية الصينية على أهمية التعاون الدولي في إطار المؤسسات الدولية، كالأمم المتحدة التي تولي مكانتها ودورها أهمية خاصة، إلى جانب تطوير الروابط الإقليمية، وتعزيز العلاقات الثنائية التي تربط الصين بمعظم دول العالم. وفي هذا الشأن، تستخدم الصين إمكانياتها، خاصة الاقتصادية، لتمتين علاقاتها الارتباطية، وخصوصاً مع الدول النامية.
وثالث المبادئ هو الاعتمادية، فالصين تؤمن بأن العالم أصبح منفتحاً وشديد ارتباط أطرافه ودوله بعضها ببعض، ولدرجة عدم إمكانية أو فائدة تقسيمه وعزل مكوناته عن بعضها. وعلى هذا الأساس، تقف الصين معارِضة ضد النزعات الانعزالية، وتدعم بالمقابل التوجهات الارتباطية المعزِّزة للانفتاح المعولم الذي يزيل الحواجز والقيود عن حرية حركة الأفراد والموارد والبضائع. وفي هذا الصدد تكون الصين أكثر ليبرالية من مناهضاتها الغربية التي قامت أصلاً على أسس الفكر الليبرالي.
ورابع المبادئ هو السلمية، فالصين تعلن جهاراً وتكراراً أنها لا تحمل إرثاً استعمارياً، كالدول الغربية، بل هي عانت من وطأة التعرض للاستعمار والاحتلال، وبالتالي ليس لديها أي نوايا عدائية لأحد. وتصرّ على أنها لن توظّف قوتها العسكرية لتهديد الغير، كون أنها ليست ذات نزعة توسعيّة، وليس لديها أي رغبة في الاستحواذ على أراضي الغير بالقوة، ولا تؤمن بالتحالفات العسكرية. فقوتها العسكرية ذات عقيدة دفاعية، والقوات الصينية المسلحة لن تتوانى عن الدفاع عن البلاد، ولكنها لن تقوم بحروبٍ توسعية. وانسجاماً مع ذلك، تدعو الرؤية الصينية إلى ضرورة إشاعة أواصر التفاهم والاعتدال في العالم، وفضّ النزاعات سلمياً، بالاعتماد على الدبلوماسية الهادئة وذات النَفَس الطويل.
هذه المبادئ تُعطي صورة وتترك انطباعاً إيجابياً لدى الكثيرين في العالم عن الصين. وإذا ما رُبط ذلك مع محاولاتها للتغلغل الاقتصادي في العالم، والذي جمعته في إطارٍ موّحد ضمن ما أصبح يُعرف بـ «مبادرة الحزام والطريق»، التي تسعى من خلاله حالياً لربط حوالى سبعين دولة بالصين، فإن هناك الكثير مما يُثير حفيظة الولايات المتحدة التي لا بدّ وأنها تستشعر بوجلٍ إمكانية خلخلة مكانتها العالمية. ولذلك، تولي واشنطن الكثير من الاهتمام، وتقوم بالكثير من الأفعال، لحصار الصين والحدّ من الوتيرة المتسارعة لصعودها وتقدمها، وبالتحديد في المجالَين التقاني والذكاء الاصطناعي.
رغم هذا الاستهداف الأميركي المكثف، تبدو الصين واثقة بنفسها، ومتحدّية بمسارها، غير آبهةٍ لما تتعرض له من حملاتٍ غربية. المهم في الأمر أن الصين، التي حتى الآن متماسكة، تعاني من مواطن ضعفٍ داخلية، حتى وإن لم تعترف بذلك علناً، وخصوصاً في مجالات ضمان الحريات والعدالة الاجتماعية والتنمية المتكافئة. وسيكون نجاح مسعاها في تبوء المكانة العالمية التي تبتغيها مرهوناً بقدرتها، ليس فقط في استمرار نجاحها في مواجهة الاستهداف الخارجي الموجّه ضدّها، وإنما في قدرتها على معالجة مواطن ضعفها الداخلي أيضاً.
الشــرق الأوسـط : انحـسـار المكــانـة
يبدو جليّاً أن نظرة كل واحدة من القوى العالمية المنخرطة حالياً في صراع ثلاثية القطبية الدولية؛ أميركا وروسيا والصين، لا تضع منطقة الشرق الأوسط على رأس قائمة أولويات سياستها الخارجية، ولا تعتبرها المنطقة التي يعتمد عليها تحقيق تفوقها على القوتين الأخريين، وفوزها في هذا الصراع. بل على العكس من ذلك، فجميع الدلائل تُشير إلى تنامي التوجه لدى هذه القوى لتجنّب الانخراط المكثف في شؤون المنطقة، أولاً لأن الصراع عليها لم يعد ذا بُعدٍ أيديولوجي كما كان الحال إبّان حقبة ثنائية القطبية، وثانياً لأنها منطقة تغرق حالياً في حالة فوضى عارمة لا تريد القوى العالمية الغرق في مستنقعٍ يستهلكها في إدارته، ولا تعرف كيفية الخروج منه.
هذا لا يعني أن المنطقة فقدت كل أهميتها للعالم، وفي الصراع الدائر حول إعادة تشكيل النظام الدولي. فالشرق الأوسط لا يزال يشكّل حتى الآن، وعلى المدى القريب، المصدر الأول لتوفير الطاقة للعالم، والمعبر الرئيس للتجارة الدولية، وسوقاً استهلاكية كبيراً ومقتدِراً مادياً، وخصوصاً في الخليج. لذلك لا تزال هذه المنطقة تحظى باهتمام وتنافس كل طرف من ثلاثية القطبية الدولية، ولكن ضمن منطلقات أصبحت في جوهرها براغماتية – نفعية، تنظر للمنطقة ليس كـ «ذخرٍ استراتيجي» يُستمات على الاحتفاظ بها، وإنما كحلبةٍ خلفيةٍ يُدار الصراع فيها كجزءٍ من مكوّنات الصراع الكوني. بصيغة أخرى، لم يعُد الصراع بين ثلاثية القطبية الدولية يتمحور على المنطقة، وإنما أصبح مجرد جزءٍ من صراعها العالمي الأوسع.
لم تعد الرغبة الأميركية في تقليص دورها في المنطقة سرّا خفياً، بل غاية معلنة، ابتدأت في عهد إدارة أوباما الثانية، وتصاعدت لاحقاً على ضوء الصعود الصيني، وازدياد الناتج والمخزون النفطي لأميركا. وإدارة بايدن تعتبر الآن أن أولى أولوياتها تتمحور على مواجهة واحتواء الصين، والتي تعتبرها المنافس الجدّي الوحيد لها. لذلك هي قررّت نقل مركز اهتمامها وثقل عملياتها إلى الشرق؛ إلى منطقة المحيط الهادي تحديداً، لكي تعمل من قربٍ على مراقبة ومحاصرة الصين. ويأتي المسرح الأوروبي ثانياً في الأولويات الأميركية، تدعيماً للتحالف الغربي التقليدي من جهة، ومواجهة روسيا من جهة أخرى. أما الأولوية الثالثة فتحظى بها منطقة الأميركيتين، تدعيماً للمصالح الأميركية التقليدية فيما يُعتبر ساحتها الخلفية.
بعد ذلك، يأتي الاهتمام بالشرق الأوسط، الذي تحتلّ فيه العلاقة العضوية مع إسرائيل الأهمية الأساسية. ومن بوابّة هذه العلاقة، تُحدد أميركا علاقاتها مع بقية الأطراف في المنطقة، فتصبح مسألة احتواء إيران ومنعها من تطوير قدرتها النووية أولوية قصوى، والحفاظ على علاقة متينة مع مصر من ثوابت الأجندة. أما اعتمادية دول الخليج على أميركا، وخصوصا في حماية أمنها، فهي أمرٌ مفروغٌ منه ولا يحتاج لبذل أي عناءٍ أميركي. بل على العكس، إذ أبدت إدارة بايدن تذمرها من تصرفات بعض هذه الدول، وخصوصاً ما يتعلق بسجلها المتعلق بالحريات وحقوق الإنسان، وحذرّت من أنها ستكف عن منحها حرية التصرف بدون مساءلة في هذا المجال. وأعلنت الإدارة أنها ستقلّص من تواجدها العسكري في المنطقة، وتعيد تموضع قواتها للتدخل السريع في الحرب المستمرة ضد الإرهاب، وستنهي حروبها المفتوحة، وستعمل على حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، ولذلك سحبت دعمها لاستمرارية حرب اليمن، وأعادت الاعتبار لدورها وسيطاً لإيجاد تسوية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
كل ما سبق لا يعني خروجاً أميركياً كاملاً من الشرق الأوسط، بل تقنين لدور أميركا التدخلي في المنطقة التي ترغب معظم دولها استمرار هذا التدخل. فالعديد من هذه الدول ذُعر من التوجه الانسحابي الأميركي، وأبدى الاستعداد التام لتمويل استمرار هذا الوجود.
لا تمتلك روسيا رؤية استراتيجية لدورها في الشرق الأوسط، وإنما تنطلق من سياسة براغماتية هدفها مراكمة المنافع، في وقتٍ تحاول فيه استعادة دورٍ رياديّ على الصعيد الدولي. لذلك تحاول النفاذ من كل الشقوق المتاحة، وتعمل على مختلف الصعد مع المتاح من دول المنطقة. أما أهدافها من تدعيم وجودها ونفوذها في المنطقة فيتلخص بضمان وجود آمن ودائم في المياه الدافئة للبحر المتوسط، ومواجهة حلف الناتو المتمدد شرقاً من جنوب أوروبا، وتأمين حصتها من النفط والغاز الطبيعي في السوق الأوروبية، والعمل على ضمان أسعار مناسبة للنفط حفاظاً على استمرار تدفق ملائم للعملة الصعبة للبلاد، واستجلاب استثمارات خليجية للسوق الروسي، وتوسيع رقعة وكمية صادراتها المتواضعة إلى المنطقة، والمحافظة الوقائية على أمن البلاد من تسرُب الإرهاب الدولي إليها من الدول التي تعاني منه في المنطقة.
وجدت روسيا في الأزمة السورية لها منفذا للعودة للمنطقة، وأقامت قواعد عسكريةً ثابتة لها في اللاذقية وطرطوس. ويُعدّ ذلك أهم إنجاز لها، كونه منحها الوجود الدائم في البحر المتوسط؛ في مركز حركة النقل والتجارة الدولية. وبدأت موسكو في تمتين هذا الوجود من خلال التدخل المباشر في الصراع على ليبيا، وإقامة ارتباطات عسكرية لها في مصر والجزائر، وعرض صفقات سلاح متطورٍ على عديد من الدول، بما فيها الخليجية، وتركيا التي تجمعها بها –كما وإيران- علاقة حذرة. كما وجدت روسيا في الدول الخليجية منفذاً مناسباً لإنعاش اقتصادها المتهاوي، وبالأساس عن طريق تأمين مساهمة صناديق سيادية لبعضٍ منها في استثمارات روسية. أما بالنسبة للقضايا الشائكة الرئيسية التي تعاني منها المنطقة، مثل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، فقد أخذت منها روسيا مواقف توفيقية، بحيث أبقت لنفسها إمكانية النفاذ من خلالها إلى المنتديات الإقليمية والدولية، التي تساعدها على تنشيط دورها الدولي، ولكن دون أن تثير بهذه المواقف غضب الأطراف المتباينة أو المتصارعة. وعلى سبيل المثال، تمّ مؤخراً الكشف عن اتفاق تعاون عسكري لروسيا مع أثيوبيا، في الوقت التي تمرّ فيه علاقات الأخيرة مع مصر، التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، بحالة توتر شديد.
تحاول روسيا من اتّباع هذه السياسة البراغماتية في الشرق الأوسط النفاذ من جديد إلى ساحة السياسة الدولية، واستعادة المهدور من دورها العالمي. وبالأساس، هي تحاول مناوشة الولايات المتحدة وتحدي سياساتها، من خلال محاولة إيجاد دور مؤثر لها في العالم انطلاقاً من خاصرته الرخوة؛ من الشرق الأوسط.
كأميركا وروسيا، لا تعتبر الصين منطقة الشرق الأوسط غاية بحدّ ذاتها، وإنما وسيلة لتحقيق ثلاث غايات أساسية لتدعيم دورها على الساحة الدولية. فهي شديدة الاهتمام بتأمين إمدادات الطاقة، من نفطٍ وغازٍ طبيعي، التي هي في أمسّ الحاجة لها لاستمرار دوران عجلة اقتصادها المتنامي. وبما أنها لا تمتلك مخزوناً ذاتيا كافياً من مكونات الطاقة، فإنها تعتمد على استيراد احتياجاتها من الخارج. وتشكّل الدول الخليجية المصدر الرئيس لتوريد النفط والغاز للصين، وبما يقرب من نصف احتياجاتها النفطية. كما وأنها تهتم، ثانياً، بأمن الملاحة البحرية، ما يعني أن المضائق الرئيسية الموجودة في الشرق الأوسط، والموانئ المنتشرة على بحر العرب والأحمر والأبيض، تحظى لدى الصين بأهمية فائقة. فبُنية ونجاح اقتصادها، حتى الآن على الأقل، يعتمد على نقل بضائعها إلى مختلف أرجاء المعمورة. وجزء رئيسي من عملية التنقل هذه يمرّ عبر الشرق الأوسط. ولذلك فإن ضمان استمرار فتح هذه المضائق، ووجود موانئ موثوقة، هو أمرٌ حيويّ لاستمرار تقدّم الصين وصعودها. كما تهتم بكين، ثالثاً، بتنمية علاقاتها وروابطها التجارية مع دول المنطقة، وخصوصاً مع دول الخليج الثرية. فاقتصادُ وافر يحتاج دائماً إلى أسواقٍ ثريّة مستهلِكة.
هذه الغايات الثلاث جمعتها الصين ضمن إطار رؤيتها وأهدافها واستثماراتها المتضمنة في «مبادرة الحزام والطريق»، والتي تُوجه جميع حساباتها وخطواتها المتخذَة في المنطقة، خاصة في مجال تطوير علاقاتها الثنائية مع كل دولة من دول المنطقة. ولكن يجدر لفت الانتباه لأمرين؛ الأول، أن بكين ترغب في تحاشي الانخراط في الخلافات المحتدمة في المنطقة، وتحاول جهدها أن تبقى خارج إطار الانغماس في شؤون صراعاتها الداخلية. وهي في ذلك تنتهج سياسة براغماتية تحاول من خلالها إرضاء جميع الفرقاء، وذلك بالتركيز على العمل ضمن المنتديات والأطر الإقليمية. لا ريب، إذاً، أن تتّبع الصين سياسة مؤيدة للقضية الفلسطينية، في ذات الوقت الذي توطّد فيه علاقاتها بإسرائيل، وخاصة في المجال التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي. والثاني، يُلاحظ أن مسارات الخطوط التجارية البرّية الستة المقترحة ضمن «مبادرة الحزام والطريق» لا تخترق الشرق الأوسط إلا بطريق واحد يمرّ عبر إيران وتركيا، ويتخطى المجال العربي. وهذا ما يجعل من إيران شريكا أساسيا في الرؤية الصينية لترتيب أوضاع المنطقة في المستقبل. كما ويجدر الانتباه أن بكين تشترك في مسعى إيجاد خط رابط بين البحرين الأحمر والأبيض يتخطى قناة السويس.
تحاول كل قوة من قوى ثلاثية القطبية الدولية ضبط إيقاع تحركاتها وتدخلاتها بما يعود عليها بالنفع من منطقة الشرق الأوسط في خضّم صراعها على العالم. ما يُثير الأسى أنه باستثناء الدول غير العربية في المنطقة، وهي إيران وتركيا وإسرائيل، فإن البواقي؛ الدول العربية، لا يزيد دورها على تلقي استخدامات هذه القوى العالمية لها.





