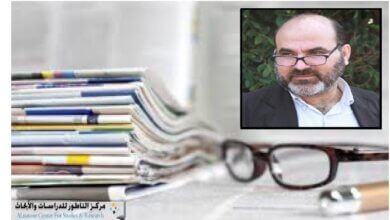د. إبراهيم نعيرات: الخشونة الأميركية: التفاف استراتيجي على الصعود الصيني
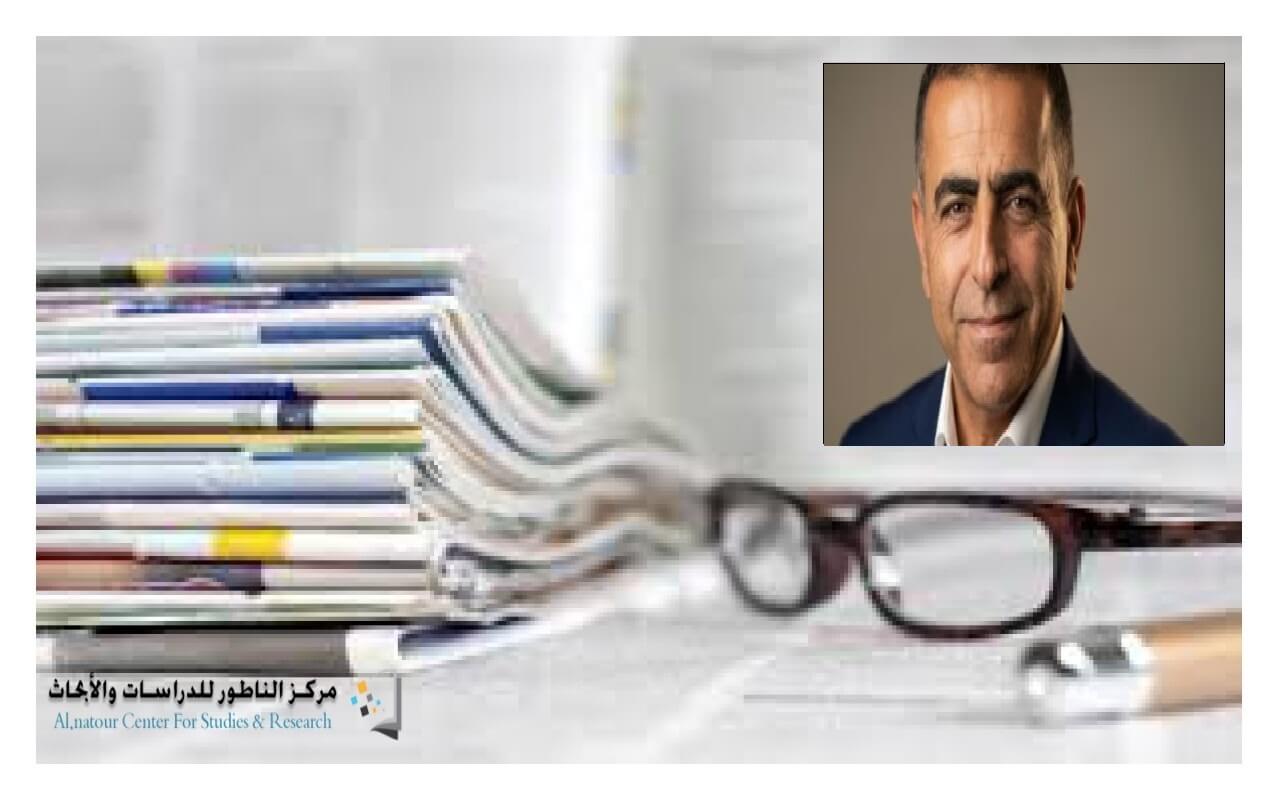
د. إبراهيم نعيرات 4-2-2026: الخشونة الأميركية: التفاف استراتيجي على الصعود الصيني
يميل جزء واسع من التحليل السياسي إلى تفسير سلوك الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب بوصفه نتاجاً لسمات شخصية استثنائية، تجمع بين النزعة الشعبوية والميل إلى الصدام والاستخفاف بالأعراف الدبلوماسية. غير أن هذا التفسير، رغم شيوعه، يبقى قاصراً. فهو يعزل الظاهرة عن سياقها البنيوي والاستراتيجي، ويحوّلها إلى شذوذ فردي، بدل قراءتها بوصفها تعبيراً عن تحوّل أعمق في طريقة إدارة الولايات المتحدة لصراعها مع القوة الصاعدة الأهم في النظام الدولي، أي الصين.
ترامب، بأسلوبه الفج وخطابه الاستفزازي، لم يكن فاعلاً طارئاً على المؤسسة الأميركية. لم يكن خروجاً عنها بقدر ما كان لحظة انكشاف لما تراكم داخل قطاعات نافذة من الحزب الجمهوري. هذه القطاعات باتت ترى أن المنظومة الدبلوماسية التي حكمت السياسة الخارجية الأميركية منذ نهاية الحرب الباردة لم تعد قادرة على التعامل مع نمط الصعود الصيني. فالصين لم تسلك طريق المواجهة المباشرة، بل انتهجت سياسة تمدد هادئة، محسوبة، ومتدرجة، تتجنب الصدام العسكري، وتراكم النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والطاقة بهدوء يصعب احتواؤه ضمن القواعد الليبرالية التقليدية.
في هذا السياق، لم تعد الدبلوماسية الأميركية الكلاسيكية أداة فعالة لكبح الصين. على العكس، بدأت تُنظر إليها كإطار يمنح بكين الوقت والمساحة لتوسيع نفوذها من دون تكلفة مباشرة. ومن هنا بدأ يتبلور داخل واشنطن تصور جديد: إذا كانت الصين تتحرك بحكمة داخل النظام، فإن مواجهة هذا الصعود تتطلب تجاوز بعض قواعده. ليس عبر صدام مباشر مع بكين، بل عبر الالتفاف عليها، وضرب مفاصل تمددها غير العسكرية، خصوصاً في مجالات الطاقة وسلاسل الإمداد والنفوذ الجيوسياسي.
هنا يمكن فهم ترشيح ترامب لولاية ثانية، رغم معرفة الحزب الجمهوري المسبقة بأسلوبه غير التقليدي وممارساته الصدامية، حتى بعد خسارته أمام جو بايدن. هذا الترشيح لم يكن مجرد رهـان على شخصية مثيرة للجدل، بل إقرار ضمني بأن هذا النمط الخشن من السلوك بات يُنظر إليه كأداة وظيفية في لحظة صراع مع قوة صاعدة تتقن العمل داخل النظام وتتفادى المواجهة المباشرة.
من هذا المنظور، لا تبدو سياسات الولايات المتحدة في تلك المرحلة انحرافاً عشوائياً عن المسار المؤسسي، بل انتقالاً واعياً نحو نمط تكتيكي أكثر صدامية. نمط يعيد تعريف القوة، لا بوصفها قدرة على بناء التوافقات الطويلة الأمد، بل كوسيلة ضغط مباشرة تُستخدم لكسر الحواجز التي يصعب تجاوزها في ظل الدبلوماسية التقليدية. في هذا الإطار، يصبح تجاوز “الصواب السياسي” أداة عمل، لا عبئاً أخلاقياً، ويغدو كسر القواعد الليبرالية وسيلة للوصول إلى أهداف كان بلوغها صعباً في ظل نظام دولي يمنح الصين أفضلية الحركة الهادئة.
هذا التحول يعيد تصور النظام الدولي كساحة تنافس صفري. ليس لأن واشنطن ترفض التعددية مبدئياً، بل لأنها ترى أن الصين تستفيد منها أكثر مما ينبغي. فلا مكان للخطاب القيمي أو الالتزامات المعيارية ما لم تُترجم إلى تفوق مادي ملموس. وهو ما يمثل قطيعة واضحة مع التصور الليبرالي التقليدي للقيادة الأميركية، الذي راهن طويلاً على الجمع بين القوة والشرعية.
الإشكالية هنا لا تكمن فقط في حدّة هذا التوجه، بل في افتراضه أن كسر القواعد سيؤدي تلقائياً إلى إضعاف الصين. فالضغط الخشن قد يحقق مكاسب تكتيكية سريعة، لكنه في الوقت نفسه يخلق فراغات استراتيجية. هذه الفراغات لا تبقى بلا شاغل، بل قد تدفع الصين نفسها، ومعها قوى أخرى، إلى تسريع بناء شبكات بديلة تقلل من الاعتماد على النظام الذي تقوده الولايات المتحدة.
تتجلى سياسة الالتفاف هذه بوضوح في ساحات تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن الصين. التعامل الأميركي مع فنزويلا، على سبيل المثال، اتسم بتصعيد سياسي واقتصادي غير مسبوق. عقوبات خانقة ومحاولات لعزل النظام جرى تبريرها بخطاب ديمقراطي هش. لكن هذا السلوك يصبح أكثر قابلية للفهم حين تُقرأ فنزويلا بوصفها مورداً أساسياً للنفط الصيني، ومفصلاً حيوياً في شبكة الطاقة التي تعمل بكين على تأمينها خارج السيطرة الأميركية.
الأمر ذاته ينسحب على إيران. فالصراع لا يتوقف عند حدود الملف النووي أو السلوك الإقليمي. بل يمتد إلى موقع إيران في معادلة الطاقة العالمية، ودورها في تزويد الصين وشركائها بالنفط. هنا يصبح الضغط الأميركي محاولة لإعادة ضبط شرايين الطاقة التي تغذي الصعود الصيني، لا مجرد مسعى لمنع انتشار نووي.
حتى الحالة الفلسطينية، وبالتحديد الحرب على غزة، ومحاولات فرض مسارات سياسية بديلة تحت مسميات مثل مجالس السلام، لا يمكن فصلها عن هذا السياق. فالانحياز الأميركي الصارخ، وتهميش القانون الدولي، يعكسان منطق إدارة الأزمات من موقع القوة، وفرض وقائع جيوسياسية في منطقة مركزية للتجارة والطاقة، بما يحد من قدرة الصين على توسيع نفوذها السياسي والاقتصادي فيها.
غير أن هذا الأسلوب لا يعني قطيعة دائمة مع السلوك الأميركي التقليدي. ما شهدناه كان أقرب إلى مرحلة ضغط قصوى، هدفها تعديل قواعد اللعبة، قبل العودة إلى واجهة أكثر انضباطاً في الشكل. الولايات المتحدة تاريخياً جمعت بين الصدمة والترميم، وبين الخشونة وإعادة إنتاج القبول. وما يُفرض بالقوة لا يُلغى لاحقاً، بل يُعاد تقديمه بلغة أكثر قبولاً.
مع ذلك، يبقى احتمال آخر لا يمكن تجاهله. فهذه الخشونة قد لا تكون تعبيراً عن ثقة فائضة، بل عن قلق بنيوي من صعود صيني يصعب احتواؤه. فالاقتصاد الأميركي يواجه تحديات داخلية متراكمة، بينما تواصل الصين تمددها بهدوء، من دون استفزاز مباشر، ومن دون منح واشنطن ذريعة مواجهة واضحة.
في هذا الإطار، يمكن فهم السلوك الأميركي بوصفه محاولة التفاف على خصم يتجنب الصدام. لكن هذا التفاف محفوف بالمخاطر. فكلما زادت الخشونة، زادت دوافع الصين والقوى الصاعدة الأخرى لبناء نظام أقل اعتماداً على المركز الأميركي.
وعليه، فإن اختزال هذه المرحلة في شخص ترامب أو أسلوبه يبقى تبسيطاً مضللاً. السؤال الحقيقي هو ما إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على كبح صعود الصين عبر كسر القواعد، أم أن هذا النهج سيسرّع، بشكل متناقض، عملية إعادة تشكيل النظام الدولي على نحو يقلص النفوذ الأميركي ذاته. هذا السؤال لا يخص مرحلة بعينها، بل يمس جوهر الصراع الجاري على شكل النظام العالمي وحدود القوة في عصر التعددية القطبية.